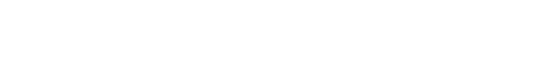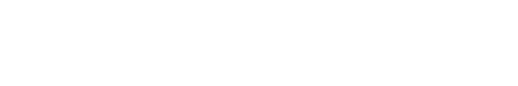
عباس الجراري
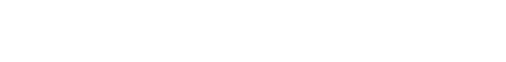
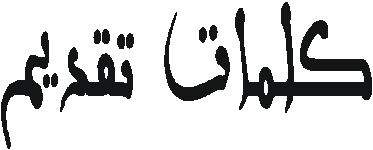
الجزء الأول
جمع وتقديم
حميدة الصائغ الجراري
منشورات النادي الجراري
إ
إ
![]()
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
الطبعة الأولى
جمادى الأولى 1427 هـ
الموافق يونيو 2006م
مطبعة الأمنية – الرباط
الإيداع القانوني : 1602/2006
ردمك : 9981 - 893 - 17 - x
المؤلف وزوجته في أحد أجنحة (المكتبة العباسية) بالنادي الجراري
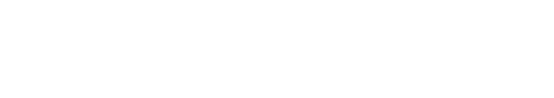

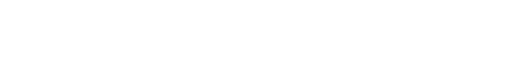
![]()

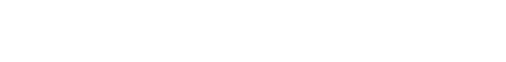
تقــديــم
يتبين لكل متتبع
لمسيرة التأليف والنشر، أن كل كتاب لا يخلو من تقديم، يكون توطئة يُهَيَّأ بها
القارئ للموضوع الذي سيتناوله الكتاب الذي بين يديه.
ولا يكاد يخرج أمر هذا التقديم عن إحدى حالتين :
أولاهما أن يقدم المؤلف نفسُه لكتابه، وثانيتهما أن يتكفَّل بذلك غيره، إما
شخص واحد أو أكثر ممن يتوسم فيهم الكاتب اهتماما بالموضوع المتناول وبصاحبه، خاصة
وهو في الغالب ما يكون من أصحاب الدراية والتمرس وذا باع في المجال بحثا ودراسة،
ونقدا واطلاعا، ومشاركة وإبداعا.
وهذا ما جعل الكثيرين من المؤلفين حين يعقدون العزم على نشر إنتاجاتهم،
يقصدون الأستاذ الدكتور عباس الجراري لتوافر كل هذه المعطيات وغيرها فيه ؛ إذ يزيد
أحيانا أن يكون قد عايش العمل باعتباره مشرفا عليه رسالة أو أطروحة ؛ أو أن يكون
المصدر الأساسي للمادة التي أدار عليها المؤلِّف كتابه.
ولا غرابة في ذلك وهو المؤطر الصبور والعالم الغيور والموثق الدقيق وصاحب
"المكتبة العباسية" التي تضم من الذخائر والنفائس والمخطوطات ما يساعد
على إخراج الكثير من أدبنا الغميس في شقيه المدرسي والشعبي.
يضاف إلى كل هذا أن كتابة تقديم – أي تقديم - يستوجب قراءة فاحصة متأنية
تُمكِّن من استيعاب مضمون الكتاب ليتأتى بعد ذلك تقديمه بشكل جيد ومشوق للباحثين
الدارسين ولعموم القراء على السواء بالنحو الذي يغريهم بقراءته وعدم تقليب صفحاته
ورميه وربما للاعودة إليه.
ولن أخفي - وأنا أعايش الأستاذ - أنه في كل مرة طُلب منه كتابة تقديم إلا
وأخذ المؤلَّف ثانية وثالثة ليستخلص مزاياه فيثني عليها، ويكشف نواقصه فينبه لها.
وهو بقدر ما يكون كريما في الأولى يكون رحيما في الثانية، يلتمس الأعذار ويشجع على
الاستمرار ويحاول جهده لتذليل الصعاب التي تحف بالنشر وتكاد تعوقه.
وبحكم مساعدتي له في الطبع والتصحيح، تسنى لي أن أكون في كل الأحيان أول
قارئ لما يكتبه، كما كنت في أحيان قليلة أول ناقد. وكان دائما يتلقى ملاحظاتي بصدر
رحب وبسعة خاطر لا يتواجدان إلا عند العالم الفذ والمربي الحق والمؤطر المتمكن ؛
وغالبا ما كان يدخلها في الاعتبار بتواضع منه كبير ممزوج باحترام وتقدير ؛ وكانت
أسعد أوقاتنا هي التي نعيشها مع مخاض كلٍٍَّّ من كتبه أو بحوثه أو مقالاته أو
محاضراته أو تقديماته. وكانت هذه الأخيرة تشدني وتثير فضولي أكثر من غيرها لتنوع مضمونها
وإيجاز فحواها وتَلَوُّنِِ مُكوّْنها الذي كان ضيقا على سعته رحبا رغم صغره.
ويبدو لي أن التقديمات شكل أدبي ونوع من الإبداع لا يقل عن البحث أو المقال
أو الرسالة أو الخاطرة أو غيرها من شتى ألوان الإنتاج الفكري، وخاصة التقديمات
التي يكتبها الأستاذ لما تتميز به من درس وتمحيص يجعلها أحيانا في مصاف البحث
والدراسة.
وحين قيض الله أن تصبح الخطب الجرارية الجمعية موضوعا لأطروحة دكتوراه، على
أمل إخراج نصوصها فيما بعد، راودتني فكرة اقتراح تقديماته موضوعا لرسالة جامعية
تضاف إلى ما كتب عنه من بحوث ودراسات. ولكنني وقد لمست وعايشت معاناة الباحثين في
جمع المادة، أرجأت البوح بهذا الاقتراح لحين يتأتى تعبيد الطريق بجمع كل ما كتب
ونشر من هذه التقديمات في شتى المجالات وعلى اختلافها، ما بين دواوين ودراسات
مدرسية وشعبية وقضايا وظواهر وبيبليوغرافيا إلخ...
*******
وتشاء الأقدار أن يتوقف إنتاج الأستاذ بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها
أواخر العام الماضي ، والعملية الصعبة التي خضع لها أوائل السنة الحالية، وما صاحب
كل ذلك من مضاعفات ومعاناة لا أرى الله مثلها لحبيب. وفي تلك الأثناء العصيبة كنت
أحسه يألم لكثرة ما عنده من أعمال لم يُتح له إخراجها، ويخشى فوات العمر دون
نشرها. وسنحت لي بادرة : لماذا لا أعمل على تعويضه عن بعض ذلك، بأن أجمع وأُعد
التقديمات لتصبح جاهزة بين أيدي الدارسين والقراء، سهلة التناول بين دفتي كتاب
ربَّما من جزأين أو ثلاثة ؟ ولكن انشغالي بصحة الأستاذ ورعايتي المتواصلة له
وملازمتي له التي لم تنقطع لحظة من ليل أو نهار ؛ كُلها حالت دون ذلك، وخاصة بعد
سفرنا لـ "كليف لاند بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية" لإجراء
العملية.
وعدنا بحمد الله، وعادت التقديمات تلح علي. فلِم لا تكون المفاجأة بها
مجموعة ومنشورة أحسن هدية أقدمها لشريك الحياة، وهو يتعافى ابتهاجا بسلامته،
وتأكيدا له أن الوقت لم يفُتنا، وأني سرقت منه فترات خصصتها خلسة لإعداد
"كلمات تقديم" ؟ وهو العنوان الذي اقتبسته من موقع الانترنيت الخاص
بالمؤلِّف. وكلي أمل في أن تتاح لي ولو مجرد الإشارة لما ارتأيته من جوانب لفتت انتباهي
في كتابته لهذه الكلمات، وإن كنت لا أزعم أني سأقدمها بمثل ما قَدمت به هي
كتبها... ولكن يكفيني - على قصر باعي وضيق الوقت واختلاس اللحظات حتى أحفظ
للمفاجأة حلاوة وقعها - أن أسجل :
1- أنها
- أي التقديمات - متنوعة بتنوع المواضيع
التي تتناولها، بين شعر وطني، وشعر جهاد، ومقطوعات صوفية، ودواوين معربة وزجلية
رقيقة، وعرض لفن المقامة، وبلاغة القصيدة المغربية، وتأريخ لمنطقة، ورحلة شيقة،
وإضاءة على شخصيات كان لها أثرها السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي، غيرَ مفرِّق بين
المدرسي والشعبي، ولا متجاهل للمواضيع الساخنة الآنية، كموضوع الصحراء المغربية
التي ما فتىء يؤكد مغربيتها وارتباطها بالوطن الأم، من خلال التدليل على ذلك بتتبع
البيعات، والرحلات، والمساجلات، والإخوانيات وغيرها.
2- أنها
تعطي صورة صادقة ومشوقة تغري بالاطلاع على الكتاب.
3- أنها
تقدم دراسة وافية عن نوع الكتاب حين يقتضي الأمر ذلك، من مثل ما حصل في تقديم
"يابني"، حيث جاءت بحثا عن "الرسائل" كمنحىً أدبي لم يُلتفت
إليه في مغربنا الحبيب.
4- أنها
جاءت - في معظمها - تشجع على مواصلة تناول الجديد المفيد كـ
"البيبليوغرافيا".
5- أنها
تحث على الروح الوطني وترسخ جوانبه المشرقة، على نحو "الأناشيد
الوطنية".
6- أنها
تناولت القديم والحديث.
7- أنها
شملت بعض ما أشرف عليه الأستاذ - رسالة أو أطروحة – وكذا ما لم يكن له فيه دور
التأطير، وحتى بعض ما صدر عن جهات رسمية.
8- أنها
أعطت المرأة حقها، فهي عنده والرجل سواء لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بجودة
الإنتاج.
9- أنها
في نطاق اهتمامه بالتراث الشعبي لم تغفل جانب "الموسيقى" بل كان لهذه
السبقُ في النشر، إذ ضمَّن بعضها في الكتب التالية :
أ- في
الإبداع الشعبي. مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 1408 هـ - 1988 م.
ب- النغم المطرب. منشورات النادي الجراري رقم 22 مطبعة الأمنية – الرباط 1422 هـ - فبراير 2002م.
ج – مع المعاصرين.
الجزء الثاني منشورات النادي الجراري رقم 24 مطبعة الأمنية
الرباط 1423هـ - 2002م
وهي التقديمات التي
لم أشأ إعادة نشرها في هذا المجموع.
10- أنها تخضع عنده لتصميم يجعلها
تُفتتح في الغالب بتمهيد للموضوع، فتأتي حسب المقتضى تحديدا للمرحلة زمانا ومكانا،
أو تعريفا بالبيئة، أو عرضا عن نسق أدبي متميز. ويُتبع التمهيد بتلخيص موجز وبليغ
للكتاب يكون موفِيًا بكل معطياته ومضامينه. ثم ينتقل للتعريف بالمؤلِّف وذكر
علاقته به والإشارة لبعض ملامح سيرته وإنتاجه، وما يتميز به في مجال البحث،
مُرَكِّزا على تخصصه، ليختم بالتعبير عن متمنياته له، مع الدعاء بالتوفيق والسداد
واطراد التقدم.
11- أنها في حجمها تتراوح بين
قصيرة ومتوسطة وطويلة، دون أن يكون في أيها إخلال بالمطلوب، حسب رؤيته للموضوع
وتناوله.
12- أنها من حيث الأسلوب واللغة لا
تخرج عما ألفناه من عميد الأدب المغربي من كتابة سلسة بليغة لا تكلف فيها ولا
تصنع، وإن تضمنت بعض المحسنات وبدت ألفاظها منتقاة، ولكنها تبقى من السهل الممتنع
الذي يسحر بنبراته، حتى لتخاله لحنًا ينساب للمسامع فيصل القلوب ويشحذ الأذهان.
*******
هذا وقد ارتأيت
استبعاد التقديمات التي كتبها في غير الموضوعات المغربية، أو لمن لا ينتمي للمغرب
مثل تقديم "من وحي الأطلس" للشاعر الجزائري المرحوم مفدي زكرياء.
وبذلك شمل ما جمعته
من تقديمات ما كتبه ابتداء من سنة 1974م
إلى منتصف 2006م، فتجمعت لدي حوالي
الخمسين، سأبدأ بالجزء الأول منها حسب الترتيب التاريخي لكتابتها على أن يضم أربعة
وعشرين وقفت بها عند عام 2000م؛ وأتبعه إن شاء
الله بالجزء الثاني في انتظار ما سيجد من تقديمات. كما ارتأيت أن أفتتح كل تقديم
بإثبات عنوان الكتاب ومؤلِّفه وتاريخ طبعه وفق ما في غلافه.
وأملي كبير في أن
يغري هذا المجموع أحد الباحثين ليتناول بالدرس كلمات التقديم الجرارية. وعندها
سأحس الرضا لمساهمة جد متواضعة في تجلية جانب من أدبنا المغربي ودراسة أعلامه.
فلعلِّي أكون قد
وفقت في التعبير عن فرحتي بشفاء زوجي الحبيب من جهة، وفي قطع فترة توقفه من جهة
أخرى، مستسمحة "منشورات النادي الجراري" أن أضفت لها كتابا دون علم
صاحبها. فليتقبله مشفوعا بكل حبي ولهفتي ووفائي للعهد الذي ربطنا والذي لا تزيد
أواصره عندي مع الأيام إلا رسوخا وقوة.
ودعائي متصل أن
يحفظه الله، ويبارك علمه وعمله، ويفيض إنتاجه، ويبقيه لأسرته الصغيرة ولمجموعته
الكبيرة ولوطنه العزيز في ظل مليكه المفدى جلالة الملك محمد السادس الذي شمله –
أعزه الله وأيده –برعايته وعطفه وحد به.
إنه السميع المجيب
وولي الهداية والتوفيق.
الرباط الجمعة ثالث
جمادى الثانية 1427 هـ
الموافق 30
يونيو 2006م
حميدة الصائغ الجراري
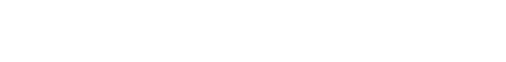
![]()
الشعر الوطني المغربي
في عهد الحماية
1912-1956
للدكتور إبراهيم السولامي
نشر وتوزيع
دار الثقافة
الدار البيضاء
بسم الله الرحمن
الرحيم
ليس من شك في أن الأدب المغربي يشكل منطقة بكرا في عالم
الدراسة والبحث، وليس من شك كذلك في أن هذه حقيقة تنتج عنها صعوبات تعترض كل من
يحاول خوض مجال ما من مجالاته. وتتجلى هذه الصعوبات في مادة البحث ذاتها، وفي
مصادرها، وحتى في المنهاج الذي يقتضيه هذا الموضوع أو ذاك.
من هنا كان تقديري لهذه الدراسة القيمة التي يقدمها الأستاذ
الزميل ابراهيم السولامي عن الشعر الوطني خلال فترة الحماية، والتي تعتبر بحق
إضافة علمية غنية للمكتبة المغربية خاصة، وللمكتبة العربية عامة، ليس فقط أنها
جاءت لتملأ بعض الفراغ الذي تشكو منه الدراسة الأدبية سواء في المغرب أو المشرق،
ولكن لأنها جاءت عملا جادا وجديا لا بد أنه أرهق صاحبه وأضناه. بل إني لأشهد على
ذلك، فقد كان الأخ السولامي يطلعني على بعض متاعبه، وكنت أحس – ولو من بعيد – مدى
ما يعاني ويكابد، ومدى الصدق والإخلاص اللذين كان يعالج بهما معاناته ومكابدته.
ومع تقديري المبدئي للرسالة، وللجهد الذي بذله الصديق
السولامي في إنجازها، فقد كانت لي ملاحظات طرحتها خلال الجلسة التي نوقشت فيها هذه
الرسالة ؛ وهي ملاحظات لا أريد أن أعود إليها، فقد وعد باعتبارها وهو يعيد النظر
في رسالته ويعدها للنشر.
لذا فإني لن أتناول في تقديم هذه الرسالة تقويمها
النقدي، كما أني لن أقرظها، إذ هي بإيجابيتها غنية عن كل ثناء، ولكني سأحاول – ولو
بإيجاز – طرح الإطار التاريخي والفكري والأدبي الذي يمكن أن يدار داخله بحث عن
موضوع جزئي هو الشعر الوطني وفي فترة محددة بعهد الحماية. كما يمكن أن يدار في
نطاقه أي موضوع أو ظاهرة أو قضية أو أية جزئية تعاني من الضياع في شتات مبعثر ولا
محدود بل غير معترف بوجوده عند كثيرين، ألا وهو الشعر المغربي الحديث والمعاصر.
*** *** ***
وإذا كان المدلول الزمني لكلمة (حديث) بالنسبة للأدب
العربي عامة قد ارتبط بـ (النهضة) التي عرف المشرق ابتداء من عهد محمد علي وربما منذ
الحماية الفرنسية على مصر، فإنه بالنسبة للمغرب بقي غامضا وغير واضح. ولعل سبب ذلك
كامن في العزلة التي فرض على نفسه أو فرضتها عليه الظروف الداخلية والخارجية منذ
انتهاء عهد الوحدة في القرن السابع الهجري، والتي جعلته ينكمش على نفسه ويبذل كل
طاقاته للذود عن كيانه ورد العدوان الخارجي المتربص به. وإذا كان العصر السعدي قد
عرف بعض التفتح على أقطار أوربية وإفريقية وحتى مشرقية، فإن هذا التفتح كان رهنا
بظروف عابرة وفترات محدودة. وفي الوقت الذي كانت شمس النهضة تلقي بأشعتها على
المشرق، كان المغرب يسعى جهده لحماية استقلاله من النفوذ العثماني أولا ثم من
التدخل الأوربي ثانيا.
وربما أمكن اعتبار حادث احتلال الجزائر سنة 1830 بداية عصر جديد في المغرب والشمال الإفريقي عامة، لأنه
كان بمثابة الناقوس الذي دق ينذر بالخطر في المنطقة. وقد أفاق المغرب من سباته
بالفعل، وكان ممكنا أن تبدأ النهضة – ولو متأخرة – وكانت قد تيسرت لها أسباب
متلاحقة لعل هذه أهمها:
أولا: البعوث العلمية التي
وجهت إلى مصر على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن، ثم إلى أوربا أيام الحسن الأول.
ثانيا: المحاولات المتعددة
لتنظيم الإدارة والجيش ومختلف مرافق الدولة.
ثالثا: دخول المطبعة إلى
المغرب من باريز عام 1859، ومن
مصر سنة 1865، ثم توالي المطابع بعد ذلك.
رابعا: ظهور الصحافة ابتداء من
1889، وهي السنة التي صدرت فيها أول
جريدة أسبوعية، وكانت تسمى "المغرب" ثم تلتها صحف أخرى غير قليلة.
ولكن هذه العوامل لم تثمر، حيث وجدت عوائق كثيرة حالت
دون ظهور النهضة:
أولها: الظروف الداخلية
والخارجية التي كان يعاني منها المغرب نتيجة الإنهاك الذي أصابه على إثر مواجهته
لفرنسا وفي وقعة إيسلي سنة 1844، ثم لإسبانيا في حرب تطوان عام 1860، تلكم المواجهة التي اضطر إليها عقب مساندته للجزائر والتي فتحت عليه باب
المناوشات والتدخلات إلى أن كان عقد الحماية سنة 1912.
ثانيها: طبيعة البعوث التي وجهت
للخارج، إذ لم يكن يقصد منها إلى التعليم الطويل بقدر ما كان يقصد إلى التكوين
السريع والتدريب العلمي على بعض التقنيات. ومن ثم لم تمس حركتها أي جانب من ميدان
الفكر يمكن أن يكون له تأثير في العمق.
ثالثها: اقتصار المطابع على
إخراج بعض الكتب الدينية والمتون المقررة في مجالس الدرس، كشمائل الترمذي وشرح
ميارة على ابن عاشر، وهما في طليعة الكتب التي نشرت يومئذ.
رابعها: عدم وجود رأي عام وطني
واع يبلور اختيارات الشعب ومطامحه.
والمسؤولية في ذلك تقع على القيادة السياسية التي كانت
تسعى، أو يسعى من حولها لحماية مكاسبهم على حساب الشعب الذي كان مسلوب الإرادة.
وما تجميد المسؤولين للخريجين الذين عادوا من البعثات الموفدة للخارج إلا مظهرا
لذلك. والمسؤولية تقع كذلك على العلماء ورجال الفكر الذين قطعوا ما بينهم وبين
الجماهير من رباط، فلم تعد لهم أية مبادرة ولا أي دور قيادي ولا أي صوت مسموع إلا
ما كان من صوت الوعظ والإرشاد. وحتى هذا الصوت فقد كان غالبا ما يضيع في زحمة
الصراع من أجل المصالح والتهافت على تحقيقها بكل الوسائل.
لهذا كله تأخرت النهضة في المغرب إلى ما بعد إعلان
الحماية، وكانت لها أسباب مباشرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: المقاومة الشعبية
المسلحة التي عبر بها المغاربة في مختلف المناطق عن موقفهم من الحماية. وقد توجت
هذه المقاومة ثورة الريف العارمة التي أعادت للمغاربة ثقتهم بذات الفرد والجماعة،
وجددت فيهم قدرات النضال وقوة الإحساس بالكرامة.
ثانيا: الانتفاضة الفكرية التي
بدأت متمثلة في الحركة السلفية التي قادها الشيخ أبو شعيب الدكالي لمحاربة البدع
والطرقية والخرافات والشعوذة ومختلف مظاهر فساد الدين، ولكنها لم تلبث أن تطورت
على يد تلاميذ الشيخ إلى معركة بين الشيوخ والشباب أو بين القديم والجديد، في
توافق مع حركات الإصلاح في بقية أقطار المغرب العربي، وخاصة حركة جمعية العلماء
الجزائريين التي فتحت مجال صحافتها للأقلام المغربية التي لم تكن تجد لها متنفسا
في جرائد المغرب يومئذ.
ثالثا: ظهور وعي شعبي جديد نتج
عن العاملين السابقين، متجليا سنة 1930 في الموقف من حادث الظهير البربري الذي كان بداية انطلاق العمل السياسي
والعمل الثقافي في التحام برزت الحركة الوطنية من خلاله.
رابعا: الخروج من العزلة
بمحاولة الاتصال مع المشرق، عن طريق الصحف والمجلات والكتب التي كانت تتسرب رغم
الرقابة وعن طريق بعض البعثات، ثم بمحاولة التفتح على أوربا، ولو في إطار محدود
بواسطة الثقافة الفرنسية التي كانت تلقن في المدارس ويحملها الموفدون.
*** *** ***
لو حاولنا أن ننظر في حال الشعر قبل هذه الفترة وحتى في
أوائلها، لوجدناه امتدادا للقديم، في محاولة عند المجيدين لمحاكاة بعض أعلام الشعر
العربي، والأندلسي منه بخاصة.
وعلى الرغم من طغيان الموضوعات التقليدية، فإن بعض
الشعراء تناولوا الأحداث التي تعرض لها المغرب، ونبهوا لضرورة الجهاد، سواء عند
احتلال الجزائر كما فعل محمد بن ادريس ومحمد غريط، أو أثناء حرب تطوان على حد ما
نجد عند المفضل أفيلال وغيره من أدباء هذه المدينة المحليين، وكذلك عند إعلان
الحماية حيث تصدى للقول بعض الشعراء أمثال محمد المشرفي والطاهر الإيفراني.
ومع أن النصوص غير متوافرة، فإننا نستطيع من خلال القليل
الذي وصلنا منها، أن ننتهي إلى أن الشعر في هذه المرحلة كان يغلب عليه طابع
الصنعة، وإلى أن معظم الشعراء كانوا يحترفونه لمجرد الزخرفة، باعتباره عنصرا مكملا
لثقافة الفقيه أو العالم، وباعتباره من حيث الوظيفة لا يتعدى التسلية والمداعبة
والترويح والتنفيس عن كوامن الذات.
وقد استمر هذا التيار يعايش أجواء النهضة الجديدة حيث
اهتم شعراؤه بالموضوعات الخاصة والإخوانية، كما اهتموا بالمناسبات وما يكون فيها
من مدح وتهنئة، وخاصة في ليلة المولد النبوي التي كان يحييها السلطان وتلقى فيها
قصائد مفعمة بروح الدين ونفَس المدح. وقد برز في هذه المناسبة شعراء رسميون كعبد
الله القباج ومحمد بوجندار وابن ابراهيم ومن إلى طبقتهم من الشعراء الذين كانوا
رغم شاعريتهم المتألقة في أحيان غير قليلة، ينزلون بهذه الشاعرية إلى درجة من
الإسفاف نتيجة الإلحاح على وتر التملق الذي تضيع في نغمه أبعاد شخصيتهم وما لهم من
قدرات فنية وطاقات تعبيرية.
وبرز إلى جانب هؤلاء المحترفين شعراء حاولوا أن يبتعدوا
قليلا أو كثيرا عن هذا التيار، وبدأوا يتناولون بعض الجوانب المتعلقة بالنهضة من
أحداث سياسية واجتماعية أو غيرها من القضايا المرتبطة بظروف هذه النهضة ومقتضياتها
المختلفة، وفي طليعتها الدعوة إلى التعليم والتركيز على ضرورة طلب العلم ومخاطبة
الشباب في ذلك، على حد ما نجد عند محمد السليماني ومحمد النميشي. وكانت مناسبة ختم
المتون فرصة يستغلها بعض الأدباء المربين لتوجيه النصح والإرشاد للناشئة. وفي هذا
المجال يذكر محمد المدني بن الحسني في قصيدتيه المشهورتين إلى تلاميذ مدرسة
والزهراء والمدرسة الكتانية، كما يذكر الجزولي في قصيدته بمناسبة ختم الشيخ أبي
شعيب الدكالي سنن ابن ماجة، ويذكر كذلك المكي الناصري في قصيدته التي أنشأ عند
اختتام الشيخ المدني بن الحسني جامع البخاري.
وكانت الروح الوطنية والقومية والدينية تحث الشعراء على
التجاوب مع بعض الأحداث المحلية، ابتداء من ثورة الريف التي انتشرت معها أناشيد
لأبي بكر بناني ومحمد اليمني الناصري، وكذا بعض الأحداث العربية كما نقرأ عند علال
الفاسي في قصيدته التي قال إثر المظاهرات التي قامت بها النساء الفلسطينيات سنة 1932، وعند عبد الله كنون في قصيدته عن أحد الجرحى
الفلسطينيين في ثورة 1936
وقصيدته في رثاء وعد بلفور، وعند التهامي الغربي في مقصورته التي تعرض فيها للقضية
الفلسطينية بعد إعلان دولة إسرائيل. كذلك كان التجاوب مع قضايا العالم الإسلامي
مظهرا آخر لهذا التيار الجديد يكفينا أن نمثل له بموقف الشاعر الجزولي من انتصار
الأتراك على اليونان.
وقد ظهر في هذه الفترة نوع جديد من الشعر مزيج من
الأفكار الوطنية والمدح، يعتبر محور الشعر الوطني بعد 1934 ؛ وهي السنة التي تقرر فيها الاحتفال الرسمي بعيد العرش. وقد كانت هذه
المناسبة السنوية فرصة يتاح فيها للشعراء أن يعربوا عن عواطفهم وأفكارهم المرتبطة
بالنضال الوطني، في جو من الحرية تبيحه حصانة المناسبة. ومن أبرز المتبارين في هذا
المجال محمد بن المهدي العلوي ومحمد العثماني ومحمد الحلوي وعبد المالك البلغيثي
والحسن البونعماني وعبد السلام العلوي وعبد الرحمن الدكالي وغيرهم من الشعراء
الذين كانوا يتجاوبون مع المناسبة على اختلاف أجيالهم وتباين انتماءاتهم.
وكان ممكنا لهذه الإرهاصات الجديدة أن تتبلور في تيار أو
تيارات تغني حركة الشعر في هذه المرحلة، لولا عوامل حالت دون ذلك يمكن تلخيصها
فيما يلي:
أولا: خنق الحريات ولا سيما
في مجال التعبير.
ثانيا: ضعف التعليم ومحدوديته،
وإن بدأ التعليم العربي الحر يزاحم التعليم الرسمي.
ثالثا: ضيق مجال الصحافة.
رابعا: قلة النقد.
ونود أن نسجل هنا ملاحظة تنطبق على الشعراء المغاربة في
هذا العصر وكل عصر، بل على شعراء العربية وأدبائها عامة إلا في حالات نادرة، وهي
فردية الشعراء وانعزاليتهم الفكرية، وعدم ميلهم إلى الالتقاء في مجتمعات أدبية
لتطارح هذه القضية أو تلك من قضايا الشعر ومحاولة مناقشتها وتبادل النظر فيها
للانتهاء إلى رأي يمكن أن تتضح من خلاله أبعاد تيار أو مدرسة أدبية يتعدى مفهومها
ما وصلنا عن مدرسة أبي تمام وزهير. وقد عرف الشعراء المغاربة بعض مجالات الالتقاء
أبرزها نادي أبي جندار، ولكنهم حتى في هذا النطاق الضيق لم يكونوا يجرؤون على
تبادل النقد، ولم يكونوا يتناولون مشاكل التعبير ليتدارسوا صعوباتها، وليخرجوا من مناقشتها
باتجاه جماعي محدد ومتبلور.
ولعل من نتائج ذلك أن بدت أطوار الشعر متداخلة في هذه
الفترة. فمن جهة استمر التيار القديم يحمل لواءه شعراء أمثال محمد غريط وأحمد بن
المامون البلغيثي ومحمد السليماني والمكي البيطاوري ومحمد بوجندار وأحمد سكيرج
ومحمد الجزولي وأحمد الزبدي وأبو بكر بناني. ومن جهة ثانية ظهر شعراء مجددون
ولكنهم كانوا يسيرون في اتجاهين متفاوتين: أحدهما يعتمد أساسا على التراث في
محاولة لترسم خطى حركة البعث في مصر. وقد برزت فيه مجموعة نذكر منها محمد اليمني
الناصري ومحمد القرى ومحمد المختار السوسي وعلال الفاسي. والثاني له ارتباط ما
بالتراث ولكنه متأثر بمدرسة الديوان في اتجاه العقاد الواقعي الرومانسي أو بمدرسة
أبولو والمهجر. وفي هذا الاتجاه لمعت أسماء جيل من شباب الفترة نذكر منهم محمد
الحلوي وعبد القادر حسن وعبد الكريم بن ثابت وعبد المجيد بنجلون ومن إليهم من
الشعراء الذين مجدوا الحرية في أبعادها الذاتية والجماعية وتغنوا بالطبيعة
والجمال، وربما أخضعوا الإشادة بهما للتعبير الوطني الناسج على خيوط رومانسية.
وكان ممكنا للحركة الشعرية في هذه الفترة وعلى يد هذا
الجيل – بحكم عوامل اتصال كثيرة – أن تتعدى مرحلة التأثر بواسطة الشرق لتقتبس
مباشرة من التيارات الفرنسية المتفاعلة يومئذ، والتي لم تكن قد وصلت أصداؤها إلى
بلاد الشرق العربي. ولكن عوامل الاتصال لم تكن من القوة والعمق بحيث تيسر أسباب
هذا الاقتباس، بل لقد وجد من الشعراء المغاربة من أتيحت لهم فرصة الإقامة في أوربا،
دون أن يكون لإقامتهم أي تأثير يذكر في تطوير شعرهم. نذكر منهم محمد (فتحا)
الناصري الذي ذهب إلى فرنسا دارسا للحقوق غير ملتفت لمجالات الأدب والشعر هناك.
ونذكر منهم كذلك عبد الرحمن حجي الذي أقام مع أسرته يعمل بالتجارة في لندن، والذي
لا نجد تأثيرا لهذه الإقامة في شعره إلا من خلال بعض القصائد التي تناول فيها
معاناته المرضية من جراء قسوة الطقس هناك.
وربما جاز لنا أن نعتبر في هذا الإطار المتداخل وامتدادا
له، تيار الشعراء الشباب أو الشعراء الجدد الذين أوقدوا جذوة الشعر غداة
الاستقلال، في محاولات مختلفة لتطويره وتجديده، وهي محاولات ما زالت مستمرة. وقد
كانت المرحلة تصل إلى عقدين تغني حركة الشعر المغربي المعاصر، وإن لم تتضح ملامحها
بعد إلا من خلال ما تكشف من بصمات التأثر بهذا الاتجاه أو ذاك، وخاصة بحركة الشعر
الحر عامة فيما يتعلق بالتكوين، ثم بشعراء الوجدان الجماعي أو الواقعية الاشتراكية
من حيث المضامين. ولعلهم بصفة عامة متأثرون بمختلف أنماط الشعر العربي الذي أنتجه
جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، بكل ملامح القلق والاضطراب التي نتجت عن
الهزات السياسية والفكرية والاجتماعية التي تعرض لها العالم العربي، وخاصة منها مأساة
فلسطين التي كشفت عن تناقضات المجتمع العربي وما يعاني من أعراض شللية. والشعراء –
والأدباء عامة – يبحثون عن هويتهم بل عن ذواتهم الضائعة في هذا المجتمع فلا
يهتدون، فينطوون على أنفسهم يجترون مرارتها في رفض يقوى ويضعف، ولكنه رفض مرضي
وسلبي لا يعني غير إفلات الزمام والعجز عن امتلاك قوة الوجود وقدرة الصمود، إذْ
أنه غير منبثق عن وعي بالذات وبالجماعة، وبانتمائهما الطبقي الناتج عن ظروف تطور
غير طبيعية ولا واضحة، تجعلهم منفصلين عن المجتمع، ولا يدركون حتى حقيقة وضعيتهم
فيه. وهم يعتمدون أساسا على الموهبة الفردية، وعلى اجترار أشكال ومضامين وقيم غير
نابعة من تجربتهم وواقعهم. والمجيدون منهم يقتبسون بعض الأساليب الجديدة في محاولة
تطويعها للتعبير مركزين على الرمز والأسطورة، ولكن الرؤى مشتتة ومضببة وغير موحدة.
ولا عجب طالما أنهم يتحفزون من منطلقات ذاتية تجعل رؤاهم وليدة التفاعل الشخصي،
وليست وليدة التفاعل الجماعي الذي من شأنه أن يلحم بين مختلف الرؤى ليولد خطا
موحدا قادرا على أن يرفد التفكير ويغني التعبير، وعلى أن يرتفع بالمنتجين إلى
مستوى المسؤولية للوعي بها وتحملها.
وشعرنا المعاصر يلح على المدلول الإنساني ويحاول إبرازه،
نسجا على خيوط من الرومانسية المكشوفة حينا والمغلفة أحيانا كثيرة. وكان ممكنا أن
تكمن هنا قيمته لولا إخلال بغير قليل من المقاييس ناتج عن بعض مظاهر النقص التي
يعاني منها كثير من شعرائنا الشباب، والمتمثلة في محدودية القدرة اللغوية وضعف
الثقافة العامة، والأدبية منها خاصة، ولا سيما ما كان منها متصلا بالتراث العربي
والإنتاج العالمي. ومن المؤكد أن النقص في التكوين الفكري يترتب عنه قصور في فهم
القضايا الوطنية والإنسانية وإدراكها بعمق، ويترتب عنه بالتالي عجز عن التجاوب
معها وخلق الرؤيا نحوها، فضلا عن تحديد هذه الرؤيا. ويترتب عنه في النهاية ضلال
أمام أعراض الداء والاختلال، وعدم اهتداء إلى الكشف عن مراكزه وعوامله المضاعفة
لتعقيدات مجتمعنا المتخلف وتناقضاته، والوقوف أمامها غير قادرين فيها على الحسم
والبث.
من هنا فإنا على كثرة ما نقرأ من شعر يتناول الجوانب
السياسية والاجتماعية لبلادنا، لا نكاد نعثر على التجاوب الصادق والبعد المحدد
والرؤيا الواضحة إلا عند قلة ممن أتيحت لهم ثقافة واسعة واتصال – ولو محدود –
بالتراث القديم والثقافة المعاصرة، وخاصة عند مجموعة الجامعيين.
ويخطئ شبابنا حين يظنون أنهم حتى ولو لم تنضج شاعريتهم
أو لم تكتمل لهم الأداة أو لم يتوافر لهم صدق المعاناة، فإن تناولهم لموضوعات حية
تصادف هوى في نفوس القراء، وخاصة منها ما يتصل بقضايا النضال، سيغفر لهم كل العيوب
وسيحول عنها نظر النقد. وهم في هذا ينسون أن عرض هذه القضايا – لكي تكون له قيمة
ويكون له تأثير – يتطلب من الشاعر معرفة بالتصوير والقدرة عليه. كما يتطلب منه
تجاوبا صادقا مع الجوانب الحية والمثيرة في هذه القضايا، ثم يتطلب بعد ذلك اتخاذ
موقف منها، من شأن ملامح الصدق والقوة فيه أن تجعل المتلقين ينسجمون معه
ويتجاوبون، فيتحول الصدق والتجاوب بذلك من إطارهما الشخصي إلى الإطار العام.
وطبَعي أن هذه العناصر – إذا توافرت – لا يمكن أن تنتج
محاولات رديئة، وهي الصفة التي يستحقها كثير من الإنتاج الشعري المعاصر. على
أَنَّا لا ننكر أن أصحاب هذه المحاولات يشكلون في غالبهم طاقات وقدرات هي لا شك
واعدة بشعر مغربي جديد نريد أن تكون له قيمته وشخصيته النابعتان من التعبير السليم
والفنية الجيدة والموضوع الحي والموقف الصادق، وأن تكون له أصالة متميزة تعتمد
الانطلاقة من واقع المجتمع والاستيحاء من التراث الحي الفعال والاقتباس من ثقافات
العصر وكل التيارات الأجنبية الإيجابية، على أن نكون قادرين لغويا وفكريا وذهنيا
على استقبالها والاستفادة منها مباشرة وليس عن طريق الترجمات والتأثيرات الجاهزة
التي تفد إلينا من الشرق. ومثل هذه السمات هي التي ستجعل من شعرنا –وأدبنا عامة–
بنية طليعية، أي مومنة بقيم جديدة وداعية لها في صدق ووعي بالمسؤولية وقدرة على
تحملها، ملتحمة مع الجماهير ورائدة لها في تأثير قيادي فعال، باحثة أبدا عن الجديد
للإغناء به وتحقيق المعاصرة، وهادفة من وراء ذلك إلى تشكيل آخر للإنسان المغربي
ولملامح مجتمع متغير يسير نحو التطور والتقدم بعيدا عن المعطيات العفنة والمواضعات
البالية.
*** *** ***
وأدبنا – بهذه الأبعاد الخلفية
والمستقبلية – يطرح على باحثه مصاعب تضاف إلى المصاعب الطبيعية التي تواجه
الدارسين في مجال الموضوعات المغربية عامة.
وكما عانى الأستاذ ابراهيم السولامي من هاته فكذلك عانى
من تلك، ولكنه استطاع بصبر الباحث ودأبه وموضوعيته وسعة صدره أن يتغلب على الكثير
منها. فلعله – وقد جرب وتمرس – أن يتابع الدراسة في الشعر المغربي الحديث
والمعاصر، على الرغم من المصاعب والمشاق التي تكتنف دراسة هذا الشعر والتي تكتنف
دراسة كل شعرنا وأدبنا عامة، والتي لا بد لها من رواد يقتحمونها ليعبدوا الطريق
ويمهدوا السبيل، وإن بارتكاب هفوات وأخطاء. ويكفي الصديق السولامي فخرا واعتزازا
أنه واحد من هؤلاء.
الرباط 4 مارس 1974
![]()
![]()
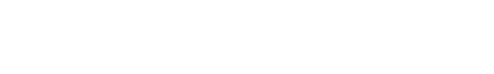
الشعـر الـدلائـي
للدكتور عبد الجواد السقاط
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
الطبعة الأولى 1985م
ا


بسم الله الرحمن الرحيم
يتميز النسق السياسي والفكري في المغرب – على حد ما يكشف
عنه تاريخه الممتد الطويل – بخصوصيات تبرز طبيعة هذا النسق الذي كان يتسم في مختلف
مراحل ذلك التاريخ بالمزج بين المشروعية والقداسة، وربط الطاعة بهما في اندماج لا
يقوم الكيان ولا يستقر إلا به.
ولا شك أن البعد الديني المتجذر في عمق ضمير المغاربة،
يعتبر أساس هذه الرؤية التي غالباً ما وجهت سلوكهم في الخضوع والانقياد أو التمرد
والثورة. وهو سلوك يعكس مدى القابلية للاستقرار والتغيير القائمين على مقاييس
متطورة ومتحركة في معظمها، وإن كانت في بعضها من قبل الثوابت والسواكن.
ونعتقد أن تحليل تاريخ المغرب في ضوء هذا النمط من
الإحساس والتفكير والتصرف، يسعف إلى حد بعيد في فهم ظاهرتين بارزتين عرفهما هذا
التاريخ.
أولاهما:
ارتكازه على دول تفاوت قدرها والدور الذي نهضت به وما كان لها من فعالية وتأثير ؛
إلا أنها مع ذلك شكلت محاور غالباً ما ظلت الحلقات الفاصلة بينها مبعثرة، إن لم
أقل مفقودة أو شبه مفقودة، بما مثلته من فجوات وثغرات كاد خيط الوحدة والتكامل وسط
ظلمتها واضطرابها أن يضيع في بعض الفترات.
ثانيتهما: وجود
مؤسسات موازية لهذه الدول، غالباً ما كانت تحول دون ضياع ذلك الخيط، بسبب انتشارها
المتسع، وقدرتها على استيعاب الأمة، وامتصاص ما تتعرض له من صراعات وتناقضات،
ومساهمتها في اجتياز تلك الهوات ؛ ولعل
الزوايا كانت في طليعة هذه المؤسسات.
وقد ارتبط مفهوم الزوايا في المغرب، والشمال الإفريقي
عامة، بالحركة الصوفية وما كان ينشأ عنها من طرق وطوائف ؛ مما جعلها تعني المكان
الذي يجتمع فيه شيخ مع أتباعه ومريديه وتلاميذه. وهو مكان يتخذ للعبادة والتعليم،
كما يتخذ للإطعام والإيواء، وقد يتخذ للتعبئة والجهاد حين يقتضي الأمر ذلك. وهو
مفهوم يعبر عنه في المشرق مصطلح الخانقاه أو التكية أو التكة.
ولسنا نستبعد أن يكون مصطلح الزاوية وافداً إلينا من
المشرق، حيث كان يعني المكان الصغير الذي يتعبد فيه، والذي غالباً ما يكون في
الحجم والاتساع دون الجامع أو المسجد.
ومن المعروف أن هذا المصطلح لم يكن شائعاً عند المغاربة
قبل القرن السابع الهجري. وربما كانت الزاوية المقامة لأبي محمد صالح في منتصف هذا
القرن بأسفي من أولى المؤسسات التي حملت هذا الإسم بالمغرب. أما قبل ذلك، ولا سيما
في العهود الإسلامية الأولى، فإن المراكز التي أنشئت
– كزوايا – كانت تحمل اسم الرباط، على غرار رباط ماسة في السوس الأقصى، ورباط شاكر
المقام على ضفاف وادي نفيس ؛ ومثلهما رباط عبد الله بن ياسين عند مصب نهر السنغال
أو النيجر، حيث كان انطلاق دعوة المرابطين.
مهما يكن، فطوال القرن الحادي عشر الهجري، وبصفة خاصة
منذ وفاة المنصور السعدي عام 1012هـ إلى أن استقر الأمر للدولة العلوية على يد المولى الرشيد ابتداء من سنة 1075هـ بعد أن أتيح له توطيد السلطة المركزية والقضاء على
بعض الفتن الداخلية، عرف المغرب في مختلف حواضره وبواديه حركة مزدهرة للزوايا، في
طليعتها زاوية الدلاء.
وقد اكتسبت هذه الزاوية أهمية بارزة، من كونها استطاعت
أن تستقطب في مركزها ببادية تادلا، طوال هذه الفترة الحالكة المضطربة، مختلف عناصر
الفعالية وعوامل التأثير، مما أتاح لها تحكماً في الزمام إلى حد بعيد ؛ في وقت
كانت العاصمة – ومثلها بقية الحواضر – منهارة، سواء على صعيد السياسة أو الثقافة.
ثم إن هذه الزاوية اكتسبت أهمية خاصة من كونها بلورت الدور المتشعب الذي كانت تنهض
به مثيلاتها، على جميع مستويات هذا الدور ؛ بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي
كانت لها في مجال العلوم العربية الإسلامية، ولا سيما ما كان منها متصلاً باللغة
والأدب، والشعر على وجه الخصوص.
*** *** ***
وقد جاء الشعر الذي صدر عن أبناء الزاوية الدلائية
والمنتمين إليهم، وثيقة نابضة بالحياة، تكشف عن مختلف المراحل التي اجتازتها
الزاوية، بدءاً من التأسيس إلى التخريب ؛ وتبرز في كل منها الدور الذي اضطلعت به،
سواء على صعيد التوعية الدينية، أو على صعيد التعبير عن الذات الجمعية المفعمة
بإحساس النفوذ والمسؤولية، أو على صعيد اجترار الذكريات التي يحث الحنين على
استرجاعها وبكائها واستخراج المواعظ منها والعبر.
وإن وثيقة هذا الشعر لتدل بما لا يدع مجالاً للشك، على
أن الشعراء الدلائيين توسلوا به خطاباً عبروا من خلاله لأنفسهم وللآخرين عما كان
يعتمل في وجدانهم، وعن المواقف المختلفة التي لجأوا إليها أو اضطروا إلى اتخاذها
في غمرة ظروف العصر وأحداثه المتلاطمة ؛ انطلاقاً من روح حفزهم إلى الصدق في
القول، والالتزام بالواقع، والابتعاد عما كانوا في غنى عنه من تزلف وتملق غالباً
ما يفضيان إلى الافتعال والاصطناع والتزييف، إلا في حالات نادرة لا تشوب المجموع.
ولم يحل ارتباط شعراء الزاوية بالتعبير العام، دون
انطلاقهم للإعراب عن ذواتهم الخاصة وما تجيش به من عواطف أطلقوا عنانها في مجالات
شتى، كان من بينها الغزل الذي غالباً ما صاغوه عفيفاً رقيقاً يفيض تذللاً وصبراً
وهياماً وانهمار دموع، وربما مزجوه بالطبيعة التي أدمجوا عواطفهم بها، والتي حثوها
على التجاوب أو ربطوا بها من يعشقون. إلا أنه قد يتعدى هذا الخط تحت لوعة الصبابة،
ولا سيما عند بعض الشعراء الذين أوصلوه حد المادية الصريحة والإباحية المكشوفة،
مأخوذين بفتنة الجمال، ومتخذين له نموذجاً رسموا له صورة متناهية في الدقة
والروعة، يسعون بها للاستمتاع الذي لا يتسنى بغير الوصال، مهما كلفهم ذلك أو جعلهم
يتحملون.
وقد دل تعبيرهم في هذا الغرض على أن عاطفتهم كانت سوية
لا يشوبها المرض والشذوذ، وإن خاطبوا بالمذكر في بعض غزلياتهم. إلا أن هذه الظاهرة
لا تعني عندهم غير التعمية وعدم الإفصاح، على غرار ما كان شائعاً عند بعض الشعراء
الذين كانوا يقصدون إلى ذلك. على أن بعض هذا الغزل لم يكن إلا رمزاً يعربون به ومن
خلاله عما خلفته نكبة الزاوية في نفوسهم من ألم البعد وحسرة الفراق، وعما ترجع به
الذكريات من شوق إلى أيامها الزاهية الزاهرة.
بهذا وغيره حافظ شعراء الزاوية الدلائية على طابع الشعر
العربي في المغرب، كما انتهى إليهم عبر الحركة الشعرية المزدهرة التي عرفها عصر
السعديين، بكل روافدها الشرقية والأندلسية الغنية، بدءاً مما أبدعه شعراء العربية الأقدمون
إلى شعراء الفترات المتأخرة، على ما في ذلك كله من تفاوت في القيمة والجودة، سواء
على مستوى المضامين أو الأشكال.
وكانوا وهم يحافظون على هذا التراث ويحفظونه من أن يداس
أو يهمش في سياق الأحداث الخطيرة التي عاشها المغرب، يغنون مجالات قوله بما يبدعون
على صعيد الزاوية من قصائد كانت طوع لسان كل فرد من أبنائها أو المنتمين إليها من
الطلبة الوافدين.
وإذا كان الإبداع الشعري للدلائيين يتجلى من حيث
المضامين فيما صدر عنهم، معبراً عن ظروف نفسية ومواقف عامة عاشوها وعانوها في
تفاعل وتجاوب صادقين، مما أبرز شخصيتهم في هذا الإبداع وميزها في مسيرة الأدب
العربي في المغرب، فإنه من حيث الأشكال يتمثل في محاولات لتجاوز القوالب التقليدية
وما تعارف الشعراء عليه في مجال البنية، إلى أنماط أخرى كانت تتيح لهم إمكان
التجديد، في طليعتها فن التوشيح الذي برزوا فيه ببراعة وتفنن، وكذا التوسل بألوان
من الإيقاع ظاهرة وخفية، جاءت منسجمة مع ما جاشت به ضمائرهم وعواطفهم وتاقت نفوسهم
للتعبير عنه، في صور شعرية كانت تأتي عفوية منساقة للطبع في بعضها، وتأتي في
معظمها خاضعة لصنعة بديعية أتقنوا سبكها في مهارة وفنية قلما أفقدتا التعبير وضوحه
وجمال أسلوبه، إلا عند من كانوا يتكلفون ذلك.
أما اللغة فكانت ناصعة وقوية وواضحة، لم يشبها في الغالب
ما ينزل بها إلى الضعف أو الغرابة. ولم يكن ذلك بدعاً بالنسبة للدلائيين، وقد
انتهى إليهم أمر اللغة في المغرب لهذا العهد، حفظاً وتدريساً وتعبيراً.
بهذا وغيره مما ساهم به الدلائيون في ساحة الشعر العربي
بالمغرب، تسنى لهم أن يحافظوا على استمرارية الإبداع حياً وخصباً وغنياً، رغم
عوامل التفريق والتمزيق والاضطراب التي شهدتها المرحلة، وتسنى لهم كذلك أن يخلفوا
بصمات واضحة ومتميزة أتاحت لمن جاء بعدهم أن يقتفي آثارها ويقيم عليها حركة شعرية
متطورة ومزدهرة، هي التي سيحتضنها عصر العلويين.
*** *** ***
وهذا الكتاب القيم الذي بين أيدينا للأستاذ الأخ عبد
الجواد السقاط، يعد الدراسة المستفيضة الأولى التي تناولت موضوع الدلائيين في
إطاره الشعري، بشكل جامع وشامل لأطرافه المختلفة وجوانبه المتعددة.
وقد انطلق الباحث من مادة غنية جمعها بدقة وعناية، قبل
أن ينكب على درسها بمنهج يسرت له أدواته أن يصف ويحلل ويقوم وينقد كذلك، في تغلب
على كل الصعوبات والمواطن الشائكة التي تكتنف دراسة مثل هذا الموضوع.
وتعتبر دراسته بذلك حلقة أساسية في سلسلة الدراسات التي
ما فتئ طلابنا الباحثون يقدمونها في الموضوعات العديدة التي يطرحها أدبنـا المغربي
– قديمه وحديثه ومعاصره – سواء فيما يتعلق بالكشف عن نصوصه وجمعها وتحقيقها،
وأحياناً صنع دواوين منها متكاملة ؛ أو فيما يتعلق بدراسة أعلامه وفنونه، ومناقشة
بعض ظواهره وقضاياه، مما يساعد على التعرف إلى هذا الأدب والتعريف به، ومن خلالهما
الكشف عن أبرز معطياته وأهم ملامحه المميزة له وخصوصياته المتفردة. وهي عناصر
أساسية لا شك لاستكمال رؤيتنا لفكر أمتنا وشخصيتها وحقيقة وجودها وما كان لها من
دور في التاريخ.
ولعلنا بهذا البحث وأمثاله لم نعد نردد الشكوى، أو
بالأحرى خففنا من الشكوى التي اعتدنا تقديمها كلما شعرنا بنقص أو ضعف في ميدان
الإبداع أو البحث الأدبي بالمغرب ؛ تشفع لنا في ذلك عشرات الرسائل والأطروحات التي
أنجزها وينجزها النابهون من طلبتنا في الجامعة، منذ وفقنا الله في أول السبعين
لتأسيس الدراسات العليا في تخصص الأدب المغربي بكلية آداب جامعة محمد بنعبد الله
بفاس، ثم بكلية آداب جامعة محمد الخامس بالرباط. وهي بحوث نقدم منها للمناقشة كل
سنة عدداً غير قليل. وإنها لخير دليل على الجهود الجبارة المضنية التي تبذل في هذا
المضمار، والتي يخوض باحثونا الشبان غمارها بصدق وشجاعة وإيمان بالهدف الذي نسعى
إليه، سواء على المدى القريب أو البعيد، وعن علم بأنهم في ذلك يسلكون الطريق الوعر
الشاق، غير جاعلين نصب أعينهم مجرد الحصول على الشهادة.
ونشهد بأنهم في سبيل بلوغ ذلك الهدف يتحملون ألواناً من
العناء المادي والأدبي، وهو عناء يرجع في طليعة أسبابه إلى الهوة العميقة التي
تفصل بين التعليم الجامعي والبحث العلمي، مما جعل هذا البحث لا يقوم إلا على
الجهود الفردية، على الرغم من كثرة الأجهزة والمؤسسات الرسمية التي تقام باسمه.
وقد سعدنا بالإشراف على هذه الدراسة ومرافقة صاحبها في
جميع المراحل التي قطعها، يحذوه الصبر والجد والمثابرة والرغبة الملحة في
الاستفادة والاستزادة ؛ وهو شعور غمرنا كذلك حين عرضناها للمناقشة في غير قليل من
الغبطة والاعتزاز. ولا نخفي أن نفس الإحساس يعاودنا اليوم ونحن نقدم للقراء هذا
البحث بعد أن أثبتت مميزاته التي سيدركها القراء أنه بحق إضافة علمية غنية للمكتبة
العربية عموماً، والمغربية منها على وجه الخصوص.
وإنا لنرجو الله أن يحقق آمالنا فندرك الغاية التي نجد
ونجهد من أجلها، ومعنا تجد وتجهد نخبة من العلماء الشبان – من أمثال صاحب هذا
البحث – أولئك الذين يتاح لهم بما ينجزون من رسائل وأطروحات أن يتحملوا مسؤولية
الدرس والبحث في شتى الجامعات المغربية، كما يتاح لهم بذلك وبما عرف عنهم من همة
عالية ونفس طموح أن يساعدوا في حمل المشعل وقطع الأشواط لبلوغ الهدف، مهما كان
الطريق إليه طويلاً أو يطول.
وبالله التوفيق.
الرباط فاتح ربيع الثاني 1405هـ
موافق 25 دجنبر 1984م
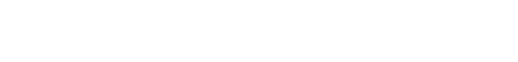
التأليف ونهضته بالمغرب
في القرن العشرين
من 1900 إلى 1972
جزآن
تأليف العلامة المرحوم
عبد الله بن العباس الجراري
ضمن منشورات النادي الجراري رقم 1
طبع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
الرباط – الطبعة الأولى
1406هـ -
1985م
ا
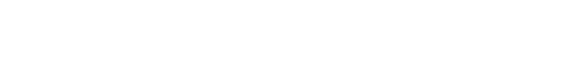
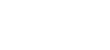
بسم الله الرحمن الرحيم
بهذا الكتاب نستهل نشر مؤلفات والدنا رحمه الله، وهي
المؤلفات التي لم يتح له أن يقدمها للطبع في حياته الفكرية الحافلة.
وقد ارتأينا أن ينضوي هذا النشر تحت شعار "النادي
الجراري"، إحياء لذكرى ناديه الثقافي الذي كان يقيمه في بيته عشية كل جمعة
طوال مدة تنيف على نصف قرن، والذي كان يلتقي فيه أصدقاءه وتلاميذه ومحبوه من رجال
العلم والأدب والوطنية.
وهو كتاب وضعه للتعريف بحركة التأليف في المغرب من خلال
مرحلة عرف فيها التأليف نهضة عبر عنها في العنوان الذي أعطاه إياه. وقد حدد هذه
المرحلة بنحو سبعين سنة بدأت مع مستهل القرن العشرين ووقفت عند اثنتين وسبعين ؛
وهو التاريخ الذي أنهى فيه جمع الكتاب على الشكل الذي اعتمدناه وأخرجناه عليه، أي
أنه مضى على تأليفه ما يقرب من ثلاثة عشر عاما قبل أن يتسنى نشره. ومعروف أن حركة التأليف
نشطت على امتداد هذه السنين التي تعدت العقد، بما لو روجع الكتاب في ضوء ما جد
فيها لاحتاج إلى إضافات تتعلق بالأعلام والأعمال يضيق عنها حجمه. بل لقد عرفت حياة
المؤلفين المتحدث عنهم ملامح جديدة خلال هذه الفترة، مست نشاطهم العلمي والتأليفي،
وربما توقفت بها تلك الحياة بالنسبة لمن توفاهم الله. وهي كلها ظواهر تدعو إلى أن
يلحق بالكتاب ما يكمله أو يعدله.
ولا نخفي أن المؤلف نفسه كان يفكر في مراجعة كتابه،
ليكون مسايرا لما يطرأ في الموضوع من جديد، لولا أسباب حالت دون ذلك ؛ من بينها
اهتماماته العلمية المتعددة، وانشغاله ببحوث أخرى كثيرة كان يسعى إلى إنجازها. ثم
إن الأجل لم يمهله حتى ينهي كل ما كان خططه أو أدخله في مشروعاته الكتابية
المتنوعة.
أما نحن، فآثرنا أن ننشر العمل كما هو، أي على الصورة
التي وضعها المؤلف عليه، دون أي تدخل بالتعديل أو الإضافة ؛ ولو فعلنا لكنا نقوم
بعملية تحقيق للنص، وما إلى ذلك أو بعضه نقصد بهذا النشر.
وقد سار المؤلف في كتابه على منهاج اقتضى منه أن يعرف
بالنهضة التأليفية من خلال التعريف بالمؤلفين الذي وضع لهم تراجم جاءت في عمومها
غير مسهبة، إذ هي في الحقيقة مجرد تقديم يمهد به لاستعراض مؤلفاتهم. وهو استعراض
لا يقتصر على ذكر أسماء هذه المؤلفات، ما طبع منها وما هو مخطوط أو غير معروف
مصيره، ولكنه يتعدى ذلك في بعض الأحيان إلى التعليق وإبداء الرأي، مع الميل إلى
نزعة وطنية تظهر في رؤيته الفكرية، وفي الموقف من التراث المغربي والتأسف على ما
ضاع منه أو أهمل، والإعراب عن كثير من الهموم الثقافية الناتجة عن الممارسة
والمعاناة.
ثم إنه قسم الكتاب إلى جزءين رتب)1( فيهما المؤلفين، وعددهم مائتان،
بادئا بالأحمدين والمحمدين خصص لهم الجزء الأول ؛ وجاعلا بقية الأسماء في الجزء
الثاني مرتبة على حروف المعجم. وهذه طريقة معروفة لدا كثير من الذين ألفوا في
التراجم، وكان قد سلكها في كتابه "أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط
وسلا".
ولعل من حق المؤلف علينا، ونحن نقدم كتابه للقراء
والباحثين، أن نسير على نهجه في التعريف بالمؤلفين، فنشير إلى بعض ملامح حياته وما
خلف من إنتاج يتسم بالخصب والغنى والتنوع والتعدد، ويعتبر بذلك معلمة متميزة في
"التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين".
وقد كان منتظرا أن يترجم المؤلف لنفسه في الكتاب ويبرز
الدور الذي كان لـه في هذه النهضة، إلا أنه لم يفعل ؛ وأغلب الظن أنه كان يرى
الاكتفاء بما هو معروف عنه وعن جهاده العلمي، وكذا أعماله الكثيرة، سواء منها التي
نشرها أو التي ذكرها في بعض مطبوعاته. على أننا سنوجز القول ونقتصر على الإشارة،
إذ فيما كتبناه في "العالم المجاهد عبد الله بن العباس الجراري" (2) ما يكفي – وإن باختصار وتركيز –
لإبراز السمات العلمية والوطنية التي تطبع شخصيته.
![]() فقد ولد يوم رابع شعبان عام 1322هـ الموافق سنة 1905م. وما كاد يبلغ الثالثة من عمره، حتى أدخل الكتاب حيث تابع دراسته
القرآنية، حفظا وتجويدا ورسما ورواية، على يد جماعة من المقرئين هم امحمد الدغيمر،
والحسن الجبلي، والحاج محمد التوروكـي، ومحمد
الشياظمي، ومحمد المهدي متجنوش.
فقد ولد يوم رابع شعبان عام 1322هـ الموافق سنة 1905م. وما كاد يبلغ الثالثة من عمره، حتى أدخل الكتاب حيث تابع دراسته
القرآنية، حفظا وتجويدا ورسما ورواية، على يد جماعة من المقرئين هم امحمد الدغيمر،
والحسن الجبلي، والحاج محمد التوروكـي، ومحمد
الشياظمي، ومحمد المهدي متجنوش.
وبعد أن أخذ العلوم الأساسية على الفقيه المربي محمد بن
التهامي الرغاي، التحق بحلقات العلماء: محمد المدني ابن الحسني، ومحمد بن عبد
السلام السايح، وأبي شعيب الدكالي، ومحمد بن العربي العلوي، والتهامي الغربي،
وأحمد بن المامون البلغيتي، ومحمج البيضاوي الشنجيطي، وأحمد بن عمر ابن جلون، وعبد
الرحمن بن القرشي ؛ مما أتاح له – بالترشيح الحر – أن يحرز على شهادة العالمية من
جامعة القرويين عام 1356هـ - 1937م.
ثم إن له من بعض هؤلاء الأشياخ وغيرهم من العلماء الذين
عرفوه إجازات علمية أهمها تلك التي كتبها له أبو شعيب الدكالي، ومحمد عبد الحي
الكتاني، ومحمد ابن عبد السلام السايح، ومحمد بن عبد السلام الرندة، ومحمد بن أحمد
العلوي الزرهوني، وأحمد سكيرج، وأحمد بن عمر ابن جلون، ومحمد بن علي دينية، ومحمد
ابن التهامي الرغاي، وأحمد بن عبد النبي، وعبد الحفيظ ابن الطاهر الفاسي، والمكي
بربيش، ومحمد الأماني السوسي، ومحمد الصبيحي، ومحمد بن عياد التليدي الشفشاوني.
وعلى الرغم من الطابع التقليدي الذي كان يسيطر على هذا
التكوين فإن طموحا وثابا كان يحثه باستمرار لتطوير هذا التكوين وتجديده، بتعاطي
عدة فنون، كالجغرافيا والتوقيت والموسيقى ؛ بالإضافة إلى انخراطه في التدريبات
التربوية الأولى، وكذا مشاركته في مباريات علمية مختلفة ؛ دون أن ننسى تثقيفه
الذاتي المستمر الذي كان مرتبطا عنده بنهم للقراءة والتدوين لا حد له، ومشاركة
علمية عميقة متفردة، مع اهتمام خاص بالأدب والتاريخ.
وقد دعي – لنبوغه العلمي المبكر – إلى ممارسة التدريس
الذي بدأه بالزاوية المباركية عام 1920م والذي استمر فيه نحو أربع سنوات قبل أن يؤسس مدرسة خاصة هي "المدرسة
العباسية"، وكانت يومئذ متطورة في برامجها ومناهجها وأنشطتها التي يكفي
لإبرازها ذكر فرقة التمثيل التي كونها من بعض تلاميذها عام 1928م، وكانت تحمل اسم "جوق السعي والفضيلة".
وابتداء من 1932م، التحق بالتعليم الرسمي، فعمل بالمدرسة الصناعية ومدرسة أبناء الأعيان ثم
الثانوية اليوسفية، إلى أن دعاه جلالة الملك المغفور له محمد الخامس عام 1939م للعمل إلى جانبه بدار المخزن، حيث كلفه بتفتيش
الكتاتيب القرآنية والتعليم الحر وكذا تعليم البنات في عموم المغرب. كما دعاه –
طيب الله ثراه – إلى التفتيش بالمعهد المولوي والتدريس به، منذ إنشائه سنة 1942م.
إلا أنه لم يلبث أن أعفي من جميع هذه المهمات التفتيشية
إثر نفي جلالة الملك المنعم وأسرته الشريفة يوم 20 غشت 1953م، بسبب مواقفه الصارمة في وجه
إدارة الحماية ؛ وهي مواقف بدأت منذ عام 1930م حين تصدى للظهير البربري الذي كان خطيبه وسجينه كما هو معروف في التاريخ.
وقد عاد إلى عمله التفتيشي بعد العودة الملكية الميمونة وحصول المغرب على
الاستقلال.
وكانت له – إلى جانب وظيفه الرسمي سواء في التعليم أو
التفتيش – دروس منتظمة في المساجد لم يتخلف عنها قط، آخرها دروسه بجامع السنة ودار
القرآن.
كذلك كان له – بموازاة هذا العمل – نشاط ثقافي بدار
الإذاعة لأول تأسيسها، إذ رتل القرآن وألقى الأحاديث والمحاضرات وأجاب على أسئلة
المستمعين في الدين والتاريخ. ومثله النشاط الذي برز به في مختلف اللجان التعليمية
الملكية، وكذا لجان التأليف والتجويد والمصحف الحسني والمعجم القرآني، وما إليها
كالمؤتمرات التي حضر الكثير منها في المغرب والخارج ؛ دون إغفال إسهامات أخرى له،
باعتباره عضوا في رابطة العلماء، واتحاد الكتاب، وجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وجمعية هواة الموسيقى الأندلسية، ثم المجلس العلمي للعدوتين.
أما الكتابة فإنه بدأ تجربته الأولى معها في أحضان
الحركة السلفية منذ 1926م،
واستمر يمارسها تدويناً وتأليفاً وتحريراً في مختلف المجالات المعرفية التي كانت
تشكل ثقافته وتثير اهتماماته، إلى آخر يوم من حياته، إذ لقي ربه شهيداً مساء
الأربعاء حادي عشر ربيع الثاني 1403هـ موافق سادس وعِشري يناير 1983م.
وقد تسنى له أن ينشر عشرات المقالات والبحوث في مختلف
الصحف والمجلات التي عرفتها الفترة، وأن ينشر كذلك بعضا من مؤلفاته التي بقي
الكثير منها مخطوطا ؛ علما بأنه خاض معركة الطبع في وقت مبكر، حين لم تكن الوسائل
متوافرة ولا متيسرة. وهذه أسماء تلك المؤلفات مرتبة حسب الموضوعات)3(:
التجويد:
- كتاب متعة المقرئين في تجويد القرآن المبين (طبع دار
النجاح الجديدة بالدار البيضاء 1401هـ -1981م).
- دروس في التجويد (مخطوطة وبعضها مرقون).
- كلمات
في العناية بالقرآن وتجويده (بعضها منشور).
التفسير والدراسات القرآنية:
- محاضرات في التفسير (ألقاها بالإذاعة المغربية في شهر
رمضان 1378هـ - 1959م).
- محاضرات وكتابات قرآنية (بعضها منشور).
- كتابات
حول المصحف (بعضها منشور).
- المعجم
القرآني (في نطاق أعمال لجنة ملكية تشرف عليها وزارة التعليم) أنجز منه حروف:
التاء والخاء والذال والصاد والضاد والهاء والواو والياء (وهي مرقونة وبحوزة
الوزارة).
الحديث واصطلاحه:
- كتابة مطولة حول حديث (من كان يومن بالله واليوم الآخر
فلا يؤذ جاره ... ): مخطوطة.
- شرح ألفية السيوطي (يوجد منه كراس بخطه).
الفقه والتشريع والفتاوى:
- القول المحتم في لبس الخاتم (المطبعة الوطنية بالرباط
1350هـ - 1932م).
- نقد النقد لما احتوى عليه الدر المنظم من الحل والعقد
(نشر بنفس المطبعة والعام).
- التحسين
والحلية في مباحث الشعر واللحية (مخطوط).
- مجموعة
فتاوى (تشكل الجزء الأول من كتابه "إطلاع القاري على فتاوى الجراري"
المكون من ثلاثة أجزاء، أولها في الأجوبة الفقهية، والثاني في التاريخية، والثالث
في متفرقات) وهي مرقونة.
- كتابات
في التشريع (بعضها منشور).
- محاضرات
وأحاديث دينية (بعضها قدم بالإذاعة).
- دروس في
التربية الدينية (بعضها مرقون).
التوحيد والدعوة:
- في العقيدة (بعضها منشور).
- كتابات سلفية (أغلبها منشور).
السيرة النبوية:
- أحاديث ومحاضرات (منها ما نشر وما ألقي بالإذاعة).
- دروس في السيرة (بعضها مرقون).
اجتماعيات:
- ذكريات المومن (نشر المطبعة الوطنية بالرباط 1352هـ - 1933م).
- رمضان في إشراقاته وأنواره، أو رمضان في إشراقاته
وعاداته (أحاديث مذاعة وبعضها منشور).
- قصة
المولد ومشاهدها أيام الطفولة (مخطوطة).
- أحاديث
(بعضها مذاع).
- كتابات
اجتماعية مختلفة (معظمها منشور).
التاريخ والحضارة:
- دروس التاريخ المغربي (في خمسة أجزاء طبعت أكثر من مرة
في المغرب ولبنان، وكان الجزء الأول منها قد نشر أول مرة عام 1935م).
- كتاب الغاية من رفع الراية (مطبعة الأمنية بالرباط –
غشت 1953م).
- صفحة من
صفحات الماضي للكتلة وتجليها في المطالبة بالاستقلال سنة 1944 (طبع دار السلمى – الدار البيضاء – مارس 1956م).
- تقدم
العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأروبا (نشر بدار الفكر العربي – القاهرة 1381هـ - 1961م).
- شذرات
تاريخية من 1900 إلى 1950 (طبع دار النجاح بالبيضاء 1396هـ - 1976م).
- ورقات
في أولياء الرباط ومساجده وزواياه (نشر بنفس المطبعة عام 1398هـ - 1978م).
- مواقف
الإعجاب بابن السلاطين الأنجاب سمو الأمير مولاي الحسن نابغة الشباب (مؤرخ بعام 1944م وهو مخطوط).
- حياة بطل
التحرير محمد الخامس أو: من تاريخ نهضتنا الحديثة (مخطوط وتوجد نسخة منه مرقونة في
المكتبة الحسنية بالرباط رقمها 6912))4(.
- محاضرات
وأحاديث تاريخية (بعضها ألقي بالإذاعة).
- أجوبة
تاريخية (أشير إليها مع فتاويه الفقهية).
- دروس في
التاريخ الإسلامي (بعضها مرقون).
- مسائل
تاريخية (مخطوطة في دفاتر وأوراق).
تراجم الأعلام :
- من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا (في
جزءين صدرا بمطبعة الأمنية – الرباط 1391هـ - 1971م).
- سلسلة شخصيات مغربية: أصدر منها ستة أجزاء طبعها بدار
النجاح الجديدة بالدار البيضاء، وهي:
1 - المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي (1396هـ - 1976م).
2 - الحافظ الواعية محمد المدني ابن الحسنى
(1397هـ - 1977م).
3 - شيخ الجماعة العلامة محمد المكي البطاوري
(1398هـ - 1978م).
4 - الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السايح
(1399هـ - 1979م).
5 - شيخ الجماعة العلامة أبو إسحاق التادلي الرباطي
(1400هـ - 1980م).
6 - العلامة الرياضي
محمد المهدي متجنوش (1402هـ - 1982م).
- من رجال
الثقافة والفكر بالرباط وسلا (مخطوط).
- تراجم وشخصيات مختلفة (بعضها منشور).
- التأليف
ونهضته بالمغرب في القرن العشرين (هذا الكتاب).
- وفيات (مخطوطة).
- اختصار
جذوة الاقتباس لابن القاضي (مخطوط).
الرحلة:
- عشرة أيام في مراكش (مخطوطة)(5).
- نزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس أو نتيجة الاقتباس
... (مخطوطة)(6).
- قرة
العيون من سبعة أيام في مكناسة الزيتون وجارتها زرهون (مخطوطة).
- الرحلة
السطاتية (مخطوطة)(7).
- جولة في
وجدة (مخطوطة)(8).
- الرحلة
الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية (مخطوطة)(9).
- رحلتي
الصيفية (مخطوطة).
- ملخص
الرحلة الليبية أو موجز ... (مخطوطة).
السيرة الذاتية والمذكرات:
- ذكريات الاعتقال (مخطوطة).
- هذه مذكراتي: في جزءين وقف في الثاني عند 1950 (مرقونة)(10).
تأبينـات:
- مجموعة كبيرة من الكلمات ألقيت في مناسباتها (بعضها
مرقون).
عرشيات وذكريات وطنية:
- مجموعة كبيرة من الكلمات (بعضها منشور).
الشعــر:
- مجموعة معظمها في الإخوانيات (مخطوطة).
المسرح:
- تمثيلية (تحت راية العلم والجهاد) كان أحرز بها على
جائزة قدماء الثانوية الإدريسية عام 1348هـ (مخطوطة).
- تمثيلية (نحو الكمال): مخطوطة.
كتابات أدبية:
- من مختار الشعر المغربي المعاصر (جمع منه جزءا واحدا
وهو مرقون)(11).
- المجالس الأدبية (مخطوطة)(12).
- روض
المقالة أو سوانح القلم (انتخب فيه مجموعة من مقالاته وبحوثه) وهي مجلدات ثلاثة
مخطوطة، وكان بصدد جمع الرابع.
- دراسات
(بعضها منشور).
- تعاليق
على شرح قافية ابن الونان للفقيه محمد السايح (يوجد منه كراس مخطوط).
الموسيقى:
- الآلة – الموسيقى – عبر التاريخ (مرقون).
- الموسيقى والشباب (طبع بدار النجاح الجديدة الدار
البيضاء
1396هـ-1976م).
خـطـب:
- خطب منبرية جمعية (مخطوطة).
- خطب بمناسبات مختلفة (مخطوطة).
رسائل:
- مجموعة كبيرة ومتنوعة.
اللغة والنحو:
- ختم على الأجرومية (أملاه عام 1342هـ وهو مخطوط).
- ختم على ألفية ابن مالك (أملاه عام 1349هـ وهو مخطوط).
- كتابة
على ألفية ابن مالك (مخطوطة في كراس، وقد ركز فيها على الأبيات الأربعة الأخيرة).
- مقالات
وبحوث مختلفة (معظمها منشور).
التربية والتعليم:
- كتابات متعددة (معظمها منشور).
تقاييد مختلفة:
- كناشات ومحافظ وبطاقات.
كتب مدرسية:
- ألفت (بالاشتراك مع الغير) نشرتها مكتبة الوحدة
العربية بالدار البيضاء:
· تاريخ المغرب.
· كتاب التربية
الإسلامية.
· القراءة الجديدة.
هذه هي عناوين
مؤلفات والدنا طيب الله ثراه، وهي تعكس إنتاجا غزيرا يعد بحق رافدا هائلا يغني
"التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين". وإننا – إذ ننشر منه اليوم
هذا الكتاب بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته – نرجو أن يسد بعض الفراغ الذي يعانيه
موضوعه الحيوي وما له من أهمية في مجال الدراسات البيبليوغرافية خاصة، والمغربية
على وجه العموم ؛ وندعو العلي القدير أن يجعل لمؤلفه من الرحمة والثواب بقدر ما
ستكون له من فائدة عامة، وما سيحظى به من رضى القراء والباحثين، وأن يوتيه من لدنه
أجرا عظيما جزاء ما قدم لأمته من أعمال جليلة، وما بذل من تضحيات في ميدان الجهاد
العلمي والوطني بصدق وإخلاص ؛ إنه سميع مجيب.
الرباط (الهرهورة) في 11 ربيع الثاني 1406هـ
الموافق 2 دجنبر 1985م
(1) قد يلاحظ بعض الاضطراب في
الترتيب، وهو ناتج عن التصفيف المطبعي لمادة الكتاب، مما صعب تفاديه.
(2) نشر
ضمن سلسلة (شخصيات مغربية) الحلقة السابعة – الطبعة الأولى – الدار البيضاء
1405 هـ - 1985م.
(3)لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى المصدر السابق (فصل : إنتاجه العلمي).
(4) بصدد الطبع لنشره في القريب إن شاء الله.
(5) طبع بعد كتابة هذه
المقدمة بتحقيق الدكتور عبد المجيد بنجيلالي.
(6) معدة للنشر بعناية الدكتور بنجيلالي.
(7) طبعت بتحقيق الدكتور مصطفى الجوهري.
(8) معدة للطبع بعناية
الدكتور بنجيلالي.
(9) معدة للطبع
بعنايته كذلك.
(10) حققت في إطار أطروحة جامعية
أنجزها الدكتور مصطفى الجوهري لنيل دكتوراه الدولة.
(11) حققه
الدكتور المرحوم سعيد الفاضلي في إطار رسالة جامعية نال بها دبلوم الدراسات العيا.
(12) حققتها الأستاذة المرحومة عائشة النواير في إطار رسالة جامعية نالت بها
دبلوم الدراسات
العليا.
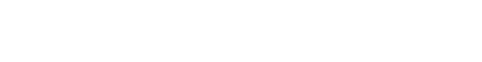

شـعـر
عبد العزيز الفشتالي
جمع وتحقيق ودراسة
الدكتورة نجاة المريني
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
1986
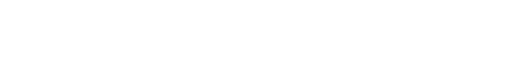
![]()
بسم الله الرحمن
الرحيم
منذ نظمت الدارسات العليا في الجامعة المغربية، أي منذ نحو عقد ونصف من
السنين، عرف البحث العلمي في الأدب العربي – وخاصة ما يتعلق منه بالإبداع المغربي –
تطوراً ملحوظاً، واتساعاً متزايداً، وإقبالاً قل نظيره في شعب التخصص الأخرى.
وقد نشط هذا البحث في اتجاه الدراسات التي تعنى بموضوعات تمس قديم الأدب
وحديثه ومعاصره، وربما عنيت في بعضها بالتعبير الشفوي وما إليه مما يشمله التراث
الشعبي، وكذا في اتجاه تحقيق النصوص المخطوطة، باستخراجها وقراءتها والمقابلة بين
نسخها والتعليق عليها، مع تقديم دراسة تمهد لها ولو قصرت. بل إن البحث نشط كذلك في
ميدان متصل بالتحقيق يبدو أكثر صعوبة من سابقه، وهو صنع النص حين يكون ضائعاً أو
مشتتاً أو لم يسبق جمعه، إذ يسعى الباحث إلى لم أطرافه ووضع لبنة فيه إلى جانب
أخرى، في حرص على أن يجعل منه بناء تاماً وكاملاً، على غرار ما قام به أولئك الذين
رووا أشعاراً عربية ووضعوا لها دواوين، من أمثال عبد الملك الأصمعي والمفضل الضبي
وأبي سعيد السكري والأعلم الشنتمري.
ولعل أحداً لا ينكر الأهمية القصوى التي يكتسبها صنع النصوص وتحقيقها، وما
يترتب عن ذلك من إبراز كشف جديد، هو من دون شك إضافة حقيقية تغني التراث الأدبي
بما يزيد في معرفته والتعرف إليه. ولعل أحداً لا ينكر كذلك الفائدة الجلي التي
يكتسبها الباحث الذي يخوض غمار هذا النوع من الدرس. وهي فائدة تتجلى في الرجوع إلى
المصادر المختلفة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، معروفة أو مجهولة، بل مهما كانت تلك
المصادر مجرد تقاييد أو خروم، طالما أنها مظنة للعثور على نص أو جزء منه، وإن يكن
ناقصاً أو مبتوراً. وتتجلى الفائدة أيضاً في عملية إعادة بناء النص وتشكيله من
لبنات تلتقط هنا وهناك، كما لو كان الأمر يتعلق بتمثال مكسور تناثرت أجزاءه فضاع
بعضها، وبقي البعض الآخر مبعثراً ليس من اليسير الاهتداء إليه، وإن اهتدي إليه
فليس من السهل التقاطه، فضلاً عن ربطه مع غيره وضمه إليه وإلحامه معه.
وهذه لا ريب فائدة لا تخلو معاناة الحصول عليها من متعة ذهنية متميزة، لا
يحسها أو يدركها إلا الذين مارسوا التجربة في هذا المضمار الوعر الدقيق. ثم ياتي
بعد ذلك كل ما يستفيده من يقرأ النصوص القديمة ويقابل بينها، ويشرح غوامضها، ويعلق
على ما تحتويه من إشارات غالباً ما تكون متعددة ومتنوعة، مع ما تقتضيه هذه العملية
المعقدة من صبر وأناة وتثبت وأمانة.
*** *** ***
إلى هذا النمط من البحث تنتمي الرسالة التي يسعدني اليوم تقديمها، كما
أسعدني من قبل الإشراف عليها وتوجيه العمل فيها، والتي أنجزتها الأستاذة الفاضلة
نجاة المريني عن: "عبد العزيز الفشتالي: شعره -جمع وتحقيق ودراسة". فقد
كان هذا الشعر في حاجة ماسة إلى أن يضم في ديوان ويدرس. وهو عمل لم يكن خوض غماره
بالأمر السهل، فإن أحداً لم يجمع للفشتالي إنتاجه الشعري، وهو نفسه لم يهتم بجمعه،
وإن اهتم من هذا الإنتاج بما هو متصل بممدوحه المنصور وما كان ينشد في مجلسه وفي
المناسبات الرسمية، فضمنه كتاب "مناهل الصفا" ؛ ويعتبر أهم مصدر لشعر
الفشتالي، بل أقرب مصدر إليه، باعتبار الشاعر مؤلفه ؛ وإن كنا نعتقد أن ما أورده
المقري في "روضة الآس" يفوق ما ساقه الفشتالي في "المناهل".
ولا يقل أهمية عنه ما ذكره له المقري كذلك في "نفح الطيب"، وابن القاضي
في "المنتقى المقصور"، وكذا ما جاء به اليفرني في "نزهة
الحادي"، وغيره من المؤرخين الذين كان اعتمادهم في الغالب على ما كتبه
الفشتالي نفسه ؛ دون التحدث عن بعض الكناشات، وخاصة منها كناشة الزجالي.
من هذه المصادر وغيرها جمعت الباحثة شعر الفشتالي لتصنع له ديواناً رتبت
قصائده على حروف المعجم، ثم عالجتها بالتحقيق الذي اقتضى منها مقابلة النصوص
ومقارنتها وتتبع ما بينها من فروق واختلافات، مما أتاح لهذه النصوص تخريجاً جيداً
زانه ما ذيلت به القصائد من هوامش عرفت فيها بالأعلام، وشرحت ما هو صعب وغامض،
وخرجت الاستشهادات والاقتباسات والتضمينات، ووضحت الإشارات المختلفة – وما أكثرها
في سياق الدين والسياسة والتاريخ – مع ما تتطلبه الدقة العلمية في كل ذلك من ضبط
وإحالة على المصادر والمراجع اللازمة.
على أن الدارسة لم تكتف بجمع الديوان وتحقيقه، ولكنها زادت على ذلك عملاً
آخر مهدت به لشعر الفشتالي، إذ كتبت دراسة قسمتها إلى فصول ومباحث عرفت فيها بعصر
الشاعر وحياته وآثاره، مع التركيز على شخصيته وشاعريته.
والحق أن الفشتالي كان في أمس الحاجة إلى من يلتفت إلى إنتاجه الشعري يجمعه
ويدرسه، فهو علَم في عصره متفرد عمن نبغوا فيه، بكونه أحد كتاب المنصور وربما
أبرزهم، ولأنه شغل في هذا العهد الذهبي منصب مؤرخ الدولة. ثم هو – قبل ذلك وبعد –
شاعر له مكانته المتميزة بين معاصريه وغيرهم. ففي إبداعه الشعري رقة وعذوبة وصفاء
مفعم بروح صوفي صادق ؛ وهو في هذا الإبداع متمكن وماسك بناصية القول، ومتحكم في
تجربته يصوغها بقدرة ذهنية صهرت محتويات تلك التجربة في سبك محكم جميل.
ويكفي الفشتالي مكانة في عالم الشعر – والمغربي منه خاصة – أنه أعطى للمديح
من خلال مولدياته كياناً يظهر في البناء الذي أقام عليه قصائده النبوية، وأنه كان
شاعراً ميالاً إلى التجديد بما أبدعه من موشحات هي من أكبر الأدلة على أن المغاربة
برزوا في فنها وطوعوه لمختلف الأغراض. بل إن عنايته بالتوشيح تعدت التعبير به إلى
التأريخ له وجمع إنتاج المغاربة فيه، إذ ألف في ذلك "مدد الجيش" تذييلاً
على "جيش التوشيح" الذي أهمل فيه ابن الخطيب ذكر الوشاحين المغاربة.
وفيه – أي في "المدد" – أورد الفشتالي لأهل عصره أزيد من ثلاثمائة موشح،
على حد قول المقري في "النفح". إلا أن الكتاب – على أهميته – ضائع أو في
حكم الضائع، وإن ذكر البحاثة المرحوم عبد السلام بن سودة في "دليل
المؤرخ" أنه كان موجوداً في أوائل هذا القرن بخزانة القرويين ؛ علماً بأنه
توجد في المكتبة الناصرية بسلا أوراق يظن أنها منه، وكان أطلعني عليها المؤرخ
الأديب جعفر الناصري رحمه الله. وهي تضم إحدى عشرة موشحة، اثنتان منها منسوبتان
لشعراء مغاربة، إحداهما للوزير أبي القاسم الغساني في مدح المنصور، مطلعها:
نار الغرام *-* يحمي حما قلب *-* بحمى
غب
وهي واردة في
"روضة الآس" مع بعض الاختلاف. والثانية للفشتالي، وفي مطلعها بعض البتر،
ولا نعلم ورودها في أي مصدر آخر، وفي أولها يقول:
سبَـج
الهـم حيثمـا حـلا -*-
بالطُّلـــــى يُنتَـخ
فارتشـف
من حَبابهـا درا
-*- فيــــه... ســدخ
قهوة زفها الهوى بكرا -*-
دانها خدرها
سبكت في أكوابها تبرا -*-
نارهـا نورهـا
وجرت قواريرها تترى -*-
بررت شقرها
*** *** ***
بهذا وغيره مما تناولته الباحثة، يتبين الموقع البارز الذي يحتله الفشتالي
في ساحة الإبداع الشعري، ومعه يتبين كذلك موقع هذه الدراسة بين الدراسات العديدة
التي وجهت وأوجه العمل فيها، والتي تتسم في مجموعها بالتكامل الساعي إلى معرفة
أدبنا، بالكشف عن أعلامه وفنونه، ومن خلال ظواهره وقضاياه، وعلى امتداد تعاقب
مراحله وفترات نموه وتطوره.
وهو هدف نبيل، وإن لم يكن سهل المنال، لما يحف به من عوائق وعراقيل كثيراً
ما فتت في عضد بعض الراغبين الذين استسلموا أمامها بعد أن حاولوا، وربما قبل أن
يجربوا أو تكون لهم أدنى محاولة.
وإن مما يبعث على الارتياح والاطمئنان ويحث على الغبطة والابتهاج، أن يقترن
سعي الباحثين من طلابنا بطموح وثاب، وهمة عالية، وتطلع إلى تحقيق الكثير، في إيمان
بالذات كبير، ورغبة في الاستزادة دون حدود.
وتشترك الطالبة في ذلك مع زميلها، وتتنافس وإياه في ميادين المعرفة والبحث،
بشجاعة وإقدام، غير قانعة باليسير كما قد يتوهم. وأذكر أن صديقاً لي من العلماء
المعتنين والكتاب المرموقين صادف في أحد مجالسي طالبة جاءت تستفسر عن بعض ما يتعلق
بموضوع دراسة تهيئها، له صلة بالتراث، فلم يخف إشفاقه عليها من مثل هذا النوع من
البحث الذي يتطلب الرجوع إلى الوثائق والمخطوطات، وربما التنقيب في الخروم ونفض
الغبار عن الأوراق المبعثرة. إلا أنها أبدت استغراباً من هذا الإشفاق، وأعربت بثقة
في النفس عن إرادتها أن تتناول ذلك الموضوع بكل ما يقتضيه.
ومن مركز المسؤولية العلمية في تخصص الدراسات العليا المغربية، أشهد أن
باحثات كثيرات أنجزن وينجزن رسائل وأطروحات أهلت البعض منهن للتدريس بالكليات، مما
يعد للجامعة بل للجامعات المغربية في صحائف المفاخر بلا شك.
وإن الباحثة الموقرة – مؤلفة هذا الكتاب عن الفشتالي وشعره – لتقف في صف
الطليعة إلى جانب رفيقات لها ينهضن مثلها برسالة البحث والتدريس والتأطير. وهي
رسالة جامعية غير هينة ولا يسيرة، وهن في أدائها موفقات، طالما أنهن يتحملنها بجد
واجتهاد وضمير حي.
وإني لذلك أشعر بشيء غير قليل من السرور والاعتزاز، وهو إحساس يغمرني وأنا
أكتب هذه الكلمة أقدم بها كتاب الأخت نجاة – وهو باكورة بحوثها – آملاً أن تعم
فائدته الطلبة والدارسين وعموم القراء، وداعياً لصاحبته بمزيد السداد واطراد
النجاح.
وبالله التوفيق.
الرباط (الهرهورة)
18 ربيع
الثانـي 1406هـ
الموافق 31 دجنبر 1985م
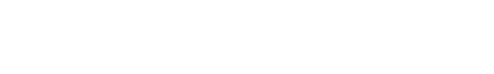
![]()
فن المقامة بالمغرب
في العصر العلوي
دراسة ونصوص
للدكتور محمد السولامي
مطابع منشورات عـكـاظ


بسم الله الرحمن الرحيم
مازال البحث في الأدب المغربي يتتابع ويتوالى متكامل الجوانب موصول
الحلقات، حتى مس مختلف أجناس تعبير هذا الأدب وأنماط تشكيله، لا فرق فيها بين
القديم والحديث أو بين المدرسي والشعبي، يقبل الدارسون على مختلف موضوعاتها في
حماس شديد يتجاوزون به كل العوائق والصعوبات التي يعانون مواجهتها بصبر كبير، ولا
سيما ما يتعلق منها بالنصوص التي غالباً ما يكون غياب جلها أو بعضها بالنسبة
لموضوع ما سبباً في التراجع عنه والتخلي، خشية الوقوع في التسرع والتهافت.
وإن هذا البحث الذي أسعد اليوم بتقديمه بعد أن سعدت بالإشراف على إنجازه،
لَيُعدُّ في طليعة البحوث التي تشكل حلقات أدبنا وتوصل ما بينها، ليبرز هذا الأدب
تام الأجزاء منسق الملامح.
وهو – إذ يدرس المقامات المغربية في العصر العلوي ويجمع نصوصها – لا يخلو
من صعوبة في حقيقته، على الرغم من السهولة التي يوهم بها ظاهره. وهو يبدو سهلاً
بحكم طبيعة الفن الذي يتناوله ومحدودية الفترة التي التزم بها ؛ ولكنه مع ذلك صعب
لعدم توافر النصوص التي ضاع بعضها وتبعثر البعض الآخر، وكذا لقلة المراجع الدراسية
أو انعدامها بالمرة، أعني تلك التي ارتادت هذا المجال من البحث وسبقت إليه.
وهذا ما يجعل الموضوع في صيغته الريادية يثير تساؤلات أولية تنصب على قضايا
ثلاثة:
الأولى : معرفة المغاربة بالمقامات وما كان لهم بها
من عناية.
الثانية : كتابتهم في هذا الفن.
الثالثة : مستوى هذه الكتابة ومدى إبداعهم فيها.
وإذا كان قد شاع عن علماء المغرب المتأخرين عدم الاعتناء بالمقامات، إلى حد
القول بحرمة تدريسها في حلقات المساجد والزوايا، لما قد تتضمنه من هزل ومجون، فإن
هذا الموقف – على ما يبدو – جاء مرتبطاً بفترة تقلص الآفاق الثقافية والعلمية
وجمود البرامج والمقررات الدراسية. وإنه ليكفي للدلالة على غير هذا الموقف في
مراحل أخرى ما نقلته الوثائق وأخبار التاريخ بدءاً من القرن السادس الهجري عن
تدريس المقامات
– والحريرية منها خاصة – بجامع القرويين وغيره، وكتابة شروح عليها. بل إن مما يدل
على أن هذا الفن كان معروفاً ومتداولاً بين العلماء والطلاب حتى في البيئات التي
يظن أنها بعيدة عن مراكز الثقافة التقليدية، ما حدث لليوسي مع شيخ الزاوية
الدلائية أبي عبد الله محمد بن محمد المرابط، لأول قدومه إليها من رحلة في طلب
العلم بالجبل والبادية، حول عبارة "القطائف اللطائف" التي استعملها في
تقريظ مجموع خطب وعظية للشيخ، واعتراض هذا الأخير على التعبير بها لأنها لا تعني
في مفهومه سوى المفروشات المعتادة ؛ إلا أن الطالب الوافد أبرز صحة الاستعمال
اللغوي والأدبي للفظة، باعتبارها "جمع قطيفة بمعنى مقطوفة"، محتجاً بقول
الحريري في مقاماته:
فلا
تعذلوني بعد ما قد شرحته
على
أن منعتم في اقتطاف القطائف
وقد تجاوزت عناية المغاربة بهذا الفن مجال التدريس والشرح إلى الكتابة على
نمطها، كما فعل مالك بن المرحل وعبد العزيز الملزوزي في القرن السابع، وعبد
المهيمن الحضرمي في العصر الذي يليه، وآخرون فيما بعد سبقوا المرحلة التي حددتها
الدراسة.
أما كيف هي هذه الكتابة ؟ أي مدى إبداعيتها وما لها من خصائص مميزة، فإنه
يبدو أن المغاربة تعاملوا مع المقامات دون انضباط صارم بمقاييسها المعروفة
والمقننة، إلى حد التداخل الفني عندهم بين الرسالة والمناظرة والمحاورة وحتى
المقالة، مما قد يعتبر خلطاً يعزى إلى انعدام تصور نظري واضح ومحدد، ولكنه – فيما
أرى – لا يعدو أن يكون مرونة في فهم الفن. وهو ما يتضح مثلاً من الحكاية الخيالية
التي صاغها محمد بوجندار متوسلاً بتعابير منمقة ومقتطفات أدبية.
ثم إن كتاب المقامات وسعوا دائرة موضوعاتها، في تركيز على الوصف وعناية
بالشعر وإلحاح على إبراز اللون المحلي، وهي ملامح يكشف عنها مثلاً ما كتبه
المسناوي عن الزاوية الدلائية، وحمدون بن الحاج عن المولى سليمان ومجلس الشاي
والمقامة التطوانية، وكذا ما كتبه عبد القادر بن شقرون في مقامته الطنجية، ومحمد
غريط في وصف مكناس.
بكل هذه الجوانب وغيرها مما لا تتسع كلمة التقديم لاستعراضه، عنيت الرسالة،
في محاولة جادة لإبراز مساهمة المغاربة في إنشاء المقامات، من خلال تكامل بين
عملين جليلين.
أولهما: جمع نصوص المقامات.
ثانيهما: دراسة هذه النصوص.
وإذا كانت طبيعة البحث قد فرضت على صاحبه أن يوزع الجهد بين هذين المجالين –
على أهمية كل واحد منهما وصعوبته – فإنها أتاحت له فرص التنقيب الدقيق والاطلاع
المستفيض والقراءة المستوعبة، في الوقت الذي مكنته من تجريب التحقيق المضبوط
والتحليل العميق، مع كل ما يقتضيه ذلك من تجلد وأناة وتثبت، وما يتطلبه من نفس
طويل لا يتقطع ولا يضيق.
من هنا تتجلى قيمة هذه الرسالة الجامعية التي رسمت الخطوط الأولى ووضعت
اللبنات الأساسية لموضوع بكر وكبير، محددة له أهم عناصره ومميزاته. ثم إنها جعلت
الباحث السيد محمد السولامي يدخل ميدان الدراسات المغربية من بابه الواسع، إثر
معاشرة ومواكبة أفضتا به إلى التمرس بأدب لا إمكان لإدراك حقيقة مضامينه وأساليبه
بدون هذا التمرس.
يضاف إلى ذلك أن الدارس اكتسب خبرة منهجية حين توسل بأدوات جديدة وأجرى
مقاييس بنيوية وجدها مسعفة له في التعامل مع النص وتحليل مستوياته التركيبية، وإن
كنت لا أخفي أني لم أكن معه على اتفاق تام في بعض ما وظفه من هذا المنهج.
وإن من واجبي – بل من حق الباحث عليَّ – أن أشهد له بالتوفيق الذي حالفه في
هذه الدراسة المضنية التي أبانت عن قدراته ومؤهلاته، والتي جاءت في الحقيقة منسجمة
مع طبيعة شخصيته المتزنة الهادئة.
ويكفي الأستاذ محمد السولامي أنه أنجز هذا البحث الجيد، وأنه يُعَدُّ به في
الباحثين المرموقين، وأنه بذلك يبشر بمزيد من العطاء، والله ولي العون والسداد.
الرباط 20 ربيع الثاني 1409هـ / فاتح دسمبر 1988م
سلسلة منطقة إقليم تادلة وبني ملال
الكتاب الثاني
من تاريخ منطقة
إقليم
تادلة وبني ملال
للأستاذ مصطفى عربوش
مكتبة الطالب – بني ملال
الطبعة الأولى
أبريل 1989
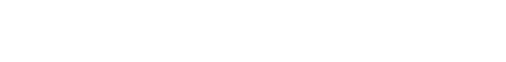

بسم الله الرحمن الرحيم
يتميز المغرب بتنوع بيئاته وتعدد
أقاليمه وكثرة حواضره وامتداد بواديه. وهو يكتسب بذلك غنى على صعيد المناخ
والطبيعة والإنتاج، وكذا على مستوى الحضارة والثقافة والتاريخ، تنعم به جميع
أطرافه ونواحيه، لا يتفرد بعضها عن البعض الآخر إلا بما يتسم به من ملامح ومعالم،
وما له من دور فعال في مرحلة زمنية ما أتيح له فيها أن يضطلع بهذا الدور وينهض به.
ومن ثم كان التعرف إلى المغرب في شتى حقائقه، رهيناً بمدى معرفة ما لمختلف
مناطقه ومراكزه القريبة والبعيدة من وجود في كافة المجالات والميادين، وما لها من
إيجابيات أسدتها لنفسها وأفادت بها المجموع.
وعلى الرغم من أن جهوداً غير قليلة بذلت وتبذل في هذا السياق الإقليمي
الهادف إلى إرفاد الوطن، فإن كثيراً من الأطراف ما زالت بكراً لم يقتحمها
الدارسون، ما أحوجها إلى من يعرف بها، ولا سيما من المنتمين إليها، لأنهم أقرب من
غيرهم إليها وإلى سكانها وتراثها، وأقدر على إدراك واقعها وفهم حركة تطورها.
من هنا كانت قيمة هذه الكتابة المستفيضة التي أنجزها عن بني ملال الأستاذ
الباحث الأخ مصطفى عربوش، وهو من أبناء هذا الإقليم المنتسبين إليه. وفيها حاول أن
يلم بجميع الجوانب التي يقتضيها إعطاء صورة متكاملة عن هذه المنطقة المشهورة
بغناها الخصيب وجمالها الساحر، في تركيز على المعالم الطبيعية والمعلومات
التاريخية والظواهر الاجتماعية وما يرتبط بها من تراث شعبي سجل بعض أنواعه
وأنماطه.
ولعلي في هذه الدراسة أو ما يماثلها مما يدخل في المضمار الإقليمي أن أنبه
إلى أمرين:
الأول: ضرورة البحث عن مكامن الخصوصيات المحلية
لإبرازها، ومن خلالها استخلاص المميزات
التي ينفرد بها الإقليم وما قد يكون له من إضافة.
الثاني: عدم الانسياق – في محاولة إبراز هذه
الخصوصيات – وراء الظن بأن كل ما يتوافر عليه الإقليم هو من قبيل ما يتميز به عن
غيره، لأن الكثير من ذلك غالباً ما يكون
مشتركاً ومتشابهاً مع ما هو موجود في غيره مما يؤكد منظور الشمولية ويقوي أواصر
الوحدة.
وقد بذل المؤلف في هذا الصدد جهداً مضنياً لا شك في أنه تطلب منه زمناً
طويلاً استغرقه البحث والتنقيب والاستطلاع، وإن كنت آخذ عليه بعض التقصير في الكشف
عن الجانب العلمي والأدبي ؛ ولعله احتفظ به لسفر ثان أو أسفار أخرى، ولا سيما
لرسالته الجامعية التي يحضرها بإشرافي عن زاوية الصومعة ببني ملال ومؤسسها أبي
العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي، وكأنه أراد من كتابه أن يضع تعريفاً ميسراً
يتداوله الجمهور، وأن يجعله في نفس الوقت كمقدمة لبحثه الجامعي أو غيره من
الدراسات التي آمل أن ينجزها، وقد وعد ببعض ذلك.
ولست أخفي – وأنا أقدم هذا السفر – ما يغمرني من مشاعر البهجة والسعادة،
لأنه سيملأ فراغاً هائلاً تعانيه المكتبة المغربية، ولأنه بحق إضافة غنية سيفيد
منها الدارسون وعموم القراء.
وإني لأهنئه على هذه الباكورة الجيدة، وأحثه على مزيد من الإنتاج لمتابعة
ما بدأه، وأدعو له بالعون والتوفيق والسداد.
الرباط 10 جمادى الثانية 1409هـ
الموافـق 18 ينايـر 1989م
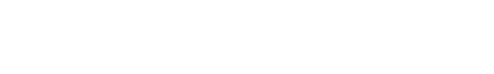

من الأدب المغربي
على عهد الحماية
محمد بوجندار الشاعـر الكاتـب
للدكتور محمد احميدة
منشورات عكاظ
1993

![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت إيجابيات أي منهج دراسي تقاس بما يتوخاه من
أهداف يحققها كـلا أو بعضاً، فإن التوجه المنهجي الذي سلكناه ودعونا إليه أفضى –
وما زال – إلى بلوغ جملة من الغايات يسعى إليها، انطلاقاً من الإطار الإقليمي الذي
اخترناه له، والذي يتسع تارة ويضيق أخرى. فهو إذا كان يتناول بعض الظواهر والقضايا
العامة من خلال رؤية تستقطب المغرب كله، فإنه في عرض موضوعات جزئية غير قليلة
يلتزم البقاء داخل مجال ضيق محدود تفرضه طبيعة هذه الموضوعات، في ارتباطها بواقع
يتسم بالتنوع والتعدد، مما لا إمكان لفهمه وإدراكه إلا بالتتبع التفصيلي الذي ينتهي
إلى لم الشتات بقصد تجميع الملامح وتشكيل الكيان الواحد المتكامل.
في نطاق هذا التصور توضع هذه الدراسة القيمة التي سعدت
بالإشراف عليها، والتي أنجزها الباحث السيد محمد احميدة، عن شخصية كان لها ظهور
أدبي في مدينة الرباط، على مدى سنوات الربع الأول من القرن العشرين. إنها شخصية
محمد بوجندار الذي كانت له مساهمات مبكرة أغنى بها عدة ميادين فكرية وتعبيرية،
بدءاً من كتابة التاريخ إلى إبداع الشعر وغيره من فنون القول.
وعلى الرغم من أن الإنتاج الجنداري لم يتعرض للضياع الذي
عرفه كثير غيره مما صدر عن المغاربة، لأن معظمه طبع في حياته أو نشر في جريدة
"السعادة" التي كانت لها – مع كونها لسان حال الحماية – عناية بالعطاآت
الثقافية في شتى الألوان والأنماط، فإنه عانى شيئا من الإهمال، بسبب الموقف الذي
اتخذ من مؤلفه، وهو يعمل موظفاً في الإقامة العامة الفرنسية مكلفاً بالتحرير
العربي في مكتب المقيم نفسه.
وإذا كان التوجه الوطني قد أدان مثل هذا الموقع ورمى من
يحتله بالخيانة، فإن فئة من خلان الأدب تضم موظفين سامين وذوي مصالح خاصة مع
الإدارة، كانت تلتقي فيه وتلتف حول صاحبه، في شكل ناد ثقافي تميز بما كان يلقى فيه
من مطارحات ومساجلات، هي – على طغيان الطابع الإخواني عليها – تعطي جزءاً من
الصورة التي كان عليها التعبير الأدبي يومئذ.
وقد أثار هذا الوضع إشكالاً جوهرياً أوقع الدارس في
الحيرة والاضطراب، وكاد أن ينتهي به إلى التخلي عن موضوعه، لولا ما اتسم به من
أناة واتزان، والتزام بموضوعية يضبطها رأي علمي سديد، ومنظور منهجي قويم، مما جعله
في النهاية يتحكم في دراسته، قادراً على تناول جانب الكتابة والشعر عند أبي جندار،
في سياق ظروفه المباشرة وملابساتها الخاصة، مبرزاً ما في هذا الجانب من عناصر
إيجابية، غير مركز على ما شابه من إشادة بالاستعمار ومدح لرجاله وأعوانه. على أني
لا أستبعد الاهتمام في وقت لاحق بمثل هذه الشوائب التي صدرت عن بوجندار ومن إليه،
لما تتضمنه من معطيات لا تخلو من فائدة في بلورة بعض حقائق الفترة وإدراك ما لها
من خلفيات قد تكشف ملامح – ولو منكسرة – من الصورة التي كان عليها المغرب يومئذ.
ومن ثم جاء هذا البحث يقدم تعريفاً لأحد أعلام الرباط،
ويلقي عبره أضواء على واقع الفكر والأدب في مرحلة كان المغرب أثناءها يشهد بداية
تحرك عام للنهوض. وجاء بذلك أنموذجاً يمكن احتذاؤه في تناول شخصيات أخرى مماثلة
كان لها دور في الحياة العلمية والأدبية على صعيد حاضرة معينة أو على مستوى أوسع
يحتضن الوطن كله، لولا أنها أساءت إليه باختيار الانحياز لأعداء البلاد، وجعلت
التيار العام – بدفع تلقائي من الوازع الوطني العارم – يعمل على طمس هذا الدور
ونسيانه حين يمكن ذلك، أو على نبذه وإلغائه حين تكون قائمة له معالم ليس من السهل تهميشها
أو محو ما لها من آثار.
لهذا وغيره مما تتميز به هذه الرسالة القيمة الجيدة، أود
الإعراب عن عظيم تقديري للجهد المبذول فيها، وكبير اعتزازي بمؤلفها الأستاذ الأخ
السيد محمد احميدة الذي برهن بهذا العمل الجاد عن مدى ما يتوافر له من إمكانات
ومؤهلات تبوئه مكاناً مرموقاً في حقل البحث العلمي الرصين، مبشرة بما سينتجه من
دراسات غدا مهيئاً لها بتوفيق من الله وسداد.
الرباط، محرم 1413هـ/يوليوز
1992م
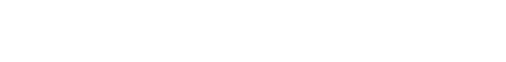
![]()
عبد الله بن العباس الجراري
الأديـب
مكونات الشخصية والثقافة
الإبداع والكتابة الأدبية
للدكتور مصطفى الجوهري
منشورات النادي الجراري رقم 4
الهلال العربية للطباعة والنشر
1995

![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ أن تأسس السلك العالي بالجامعة المغربية في نظامه الجديد، وعلى مدى ربع
قرن بالضبط، سعينا جاهدين إلى إرساء دعائم قوية ثابتة لدرس الأدب العربي في
المغرب، والنهوض بالبحث العلمي في مختلف مجالات هذا الدرس وشتى آفاقه.
ومن ثم عملنا على تشجيع دارسيه من الشبان المؤهلين لاجتياز مرحلتي الدبلوم
والدكتوراه، ورعايتهم ليس فقط بالإشراف وما يقتضي من تتبع وتوجيه، ولكن باحتضانهم
كذلك داخل أسرة هي مع اتساع شعابها وشساعة رحابها تلم الشمل وتقرب الرؤى، على ما
في هذه الرؤى من تنوع غني وتعدد خصيب. ولعل المنهج الذي دعونا إليه وما نزال، كان –
في روحه وإطاره وإن تباينت مفرداته وأدواته – محور هذا اللم والتقريب، وأكاد أقول
هذا الاستقطاب.
وإنه ليكفي إلقاء نظر ولو عابر على الرسائل والأطاريح التي أنجزت في هذا
المضمار، وتأمل موضوعاتها والقضايا التي أثارتها، ليتبين أنها على كثرتها التي
تغني عن كل عد أو إحصاء، تبرز هذا المنحى وما أتاح ويتيح من غمار يخوضها الباحثون
الساعون بعناء ومشقة تمازجهما المتعة واللذاذة إلى التنقيب في خفايا الإبداع
المغربي والكشف عن خباياه. وهم بذلك يتطلعون إلى إظهار بنيات ولبنات عساها إن
اجتمعت أن تكمل أجزاء الصورة وتوضح ملامحها، وتبرز مكانها حيث ينبغي أن توضع،
مضمومة إلى غيرها، مما يبلور في النهاية واقع الأدب العربي وحقيقته في عمومه
وشموليته.
وقد حققت تلكم البحوث ما كان يتوخى لها من أهداف، أو البعض منها على الأقل.
ولعلها – وهي مستمرة تتابع خطاها في غير توان ولا توأد – أن تحققها كاملة. فهي
ترصد ذلكم الإبداع في جميع أنماطه وأشكاله، مدرسية وشعبية، وتجمع نصوصه وتصنع
دواوينه وتعرف أعلامه وتحلل ظواهره وتناقش قضاياه وما يثير من مشكلات.
*** *** ***
وإن هذا السفر الجليل الذي يسعدني أن أقدمه للباحثين والطلاب وعموم القراء،
بعد أن سعدت بالإشراف على إنجازه رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ؛ ليمثل هذا
التتبع الدقيق لجانب جزئي من جوانب غنية برز فيها أحد العلماء المعاصرين، كان في
طليعة الرواد الذين ساهموا بفاعلية وبحكم مشاركتهم الواسعة ومقتضيات المرحلة، في
ميادين متعددة كان من بينها الأدب في مفهومه الشمولي الواسع. وإنه لمفهوم يحتضن
التعبير الشعري والنثر الفني وما أضيف إليهما من قص وتمثيل أو ألحق بهما مما له
معهما اتصال وشيج وارتباط متين، ولكنه يتجاوزهما لاستيعاب علوم وفنون أغنت المجال
الأدبي بما انبثق عنها من مضامين وأشكال جلَّتها أنماط كتابية متميزة.
وقد بذل الباحث الكريم الأستاذ الأخ مصطفى الجوهري جهداً محموداً في التقاط
مكونات هذا الموضوع الدقيق، وكذا في تحليلها والاستنتاج منها، مما جعله يوفق في
إنجاز رسالة حظيت بالثناء الفائق والتنويه اللائق، لما طبعها من تميز وإجادة. وما
كان له أن يدرك هذا الشأو لولا صبره وأناته وتثبته ودأبه على الإتقان، في غير تسرع
ولا ملل، ودونما تباطؤ أو كلل.
وأشهد أني كنت أشعر بطول نفسه وعمق نظره ودقة تحريه، كلما أثار معي بعض
الاستفسارات والاستيضاحات، أو سألني وثيقة نادرة أو كتاباً مخطوطاً، بحكم علاقة
الإشراف، وكذلك بحكم طبيعة الموضوع المرتبط بوالدي رحمه الله وما توافر لدي من
تراثه الغزير.
وهي شنشنة أعرفها فيه منذ كان يختلف إلى فصول الدراسة بالكلية، متطلعاً إلى
مزيد من معرفة الأدب المغربي، في حرص شديد، وفي اجتهاد منقطع النظير، وفي مواظبة
ملزمة. وهي خصال ما زالت – لصدقها ورسوخها – تتجلى فيه مدرساً بمركز تكوين
الأساتذة، يُعدهم بعلمه وخبرته وسلوكه لحمل أعباء مهمتهم الشاقة. وإنها لتسامته
كذلك عضواً في "النادي الجراري" يلتمع اسمه ويأتلق بين قاصديه ورواده،
وينسلك كتابه ضمن منشوراته وفي طليعة إصداراته. وإنه إن كان لذلك أهلاً فهو على
متابعة المسير قدير وبكل تكريم حري وجدير.
وفقه الله وسدد خطاه، وأدام النجاح حليفه وهجيراه.
الرباط 3 شوال 1415هـ
4
مــارس 1995م
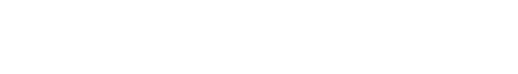
![]()
أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي:
عالم الزاوية الدلائية وأديبها
للدكتور حسن جلاب
المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش
1417هـ - 1997 م
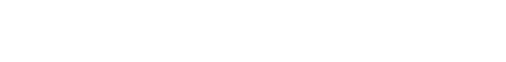

بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل من يتتبع سير البحث العلمي في المغرب، وسير
الكتابة والتأليف فيه على العموم، لا يلبث أن يلحظ التطور الهائل الذي عرفه على
امتداد العقـود الأربعة الأخيرة ؛ مما تجليه المنشورات التي تصدرها دور الطبع، في
تنوع وتعدد لم يتقدم لهما مثيل، إذا ما قيس هذا الإنتاج بما سبق في العهود الماضية،
سواء على صعيد الحجم والكم، أو على مستوى الجودة والكيف.
وقد كان للجامعة المغربية منذ تأسيسها في الرباط، ثم ما
تفرع عنها من جامعات في شتى الجهات والأقاليم، أكبر الأثر في هذه النهضة التي تسنى
لها أن تزهر وتثمر، بفضل الجهود التي بذلها وما زال يبذلها ثلة من أساتذة مختلف
الكليات، ونخبة معهم من الباحثين، مأخوذين جميعاً – إلى جانب تكوين الأجيال – بلذة
الدرس ومتعة التنقيب، يدفعهم إلى إدراك أوجهما هاجس تحقيق الذات وإثبات الهوية،
أقصد ذات الفكر وعَبْرها هوية الأمة.
وإنه لمن حق الجامعة أن تفخر وتعتز بجهود هؤلاء الأبناء
البررة الذين لم تثنهم صعوبات مرحلة التأسيس عن المضي في الطريق، على ما فيه من
عراقيل وعثرات، يحثهم على متابعته في جلد وصبر بصيصُ أمل يراودهم في الأفق البعيد
أن المسير مُفضٍ لا محالة إلى بلوغ ما يتطلعون إليه من غايات وأهداف.
من بين هؤلاء الجنود الرواد – إن لم أقل في طليعتهم –
مؤلف هذا الكتاب، أخي وصديقي الأستاذ القيدوم الدكتور حسن جلاب الذي سعدت برفقته
منذ أولى محطات هذا الطريق، مستبشراً بما كان له من بواكير في البحث العلمي
والكتابة الأدبية، جاءت في أول ملامحها دالة على نبوغ متميز ظاهر، وقدرة دائبة على
الإنجاز والمثابرة. وهما إذا كانا يعتبران لا شك نعماً ومواهب، فإنه نماهما بالعمل
المتواصل والاجتهاد المتلاحق، وحلاَّهما بما يزين شخصه من خلق كريم يلمسه فيه كل
من لقيه أو عاشره أو تعامل معه.
آية ذلك هذا السفر الجليل الذي يغمرني شعور بالغبطة
والابتهاج، إذ أكتب له كلمة تقديمية، بعد أن كنت قبل نحو من عشرين عاما قد سررت
بالإشراف على تهييئه رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها
من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، عُدت من أهم الرسائل الجامعية التي
أمدت التراث المغربي والبحث فيه بإضافات جليلة بلورت حقيقته وأغنت روافده.
وقد أراد المؤلف من دراسته أن تكون تعريفاً عاماً لأحد
أعلام المغرب البارزين في رحاب الزاوية الدلائية، إن لم يكن أبرز علمائها على
الإطلاق، وفق رأي الدارس، هو "أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي" الذي
كان لاسمه من الشفوف والاعتبار، ولفكره من الذيوع والانتشار، ما تجاوز حدود هذه
الزاوية، بل حدود المغرب، بما كان لهما من صيت تردد صداه في بلدان الشرق، لا سيما
وقد تسنى له بعد تخريب الزاوية أن يرحل إلى البقاع المقدسة ؛ وإن عاد بعد ذلك إلى
وطنه ليتابع مهمته في فاس، تدريساً وخطابة، وكان فيهما بارعاً مبرزاً.
ونظراً للموسوعية التي يتسم بها علم المرابط وإنتاجه
فيه، فإن الباحث بعد أن تحدث عن حياته من حيث الأسرة والنشأة والثقافة والشخصية،
فصل القول في آثاره التي جمعت الشعر إلى غيره من أنماط الكتابة، والتي عكست آفاق
اهتماماته، أدباً وفقهاً وأصولاً وتصوفاً ونحواً. ويكفيه تفوقاً في هذا المجال
الأخير أن لقب بـ "سيبويه المغرب" و "سيبويه الزمان"، وأن
كتابه "التحصيل" الذي شرح فيه "تسهيل" ابن مالك نال في أقطار
المغرب والمشرق من الإقبال عليه والثناء ما عزَّ له النظير من بين مؤلفات
المغاربة.
لقد تتبع الكاتب هذه الآثار ونقب عنها ونفض الغبار،
وعرضها مثلما عرض جوانب كانت غامضة أو مجهولة في حياة المرابط، وتمكن بذلك من أن
يقدم تعريفاً لعلم شامخ عبر هذا الكتاب الذي لا شك سيفيد منه الدارسون والباحثون
وطلاب العلم وعموم القراء.
وإنه لكتاب نفيس يسوقه المؤلف ضمن ما سبق له أن نشر من
بحوث قيمة رصينة، خدم بها تراث المغرب في شتى جوانبه وأبعاده ؛ ومن بينها – وعلى
رأسها – أطروحته المستفيضة عن "الحركة الصوفية بمراكش" من خلال
"ظاهرة سبعة رجال"، وكان أصدرها في ثلاثة أجزاء. وهي كلها بحوث متفردة
تنم عن الضبط والتدقيق، وطول النفَس، وأناة الدرس والتحليل، وقبل ذلك عن حسن
الاختيار، مما لا يتيسر إلا للعلماء الملهمين والباحثين المبدعين.
فهنيئا للأخ الكريم والصديق الحميم طبع هذه الرسالة
الجيدة الجادة، تضاف إلى إنتاجه المتواصل النافع، ودعاء إلى العلي القدير أن يديم
له العون والسداد واعتلاء مدارج السؤدد والارتقاء.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1417هـ
الموافـق 13
نـونبـر 1996م
رياض العشاق
ديوان زجل
للأستاذ حُسني الوزاني
نشر جمعية تطاون أسمير
سلسلة إبداع
مطبعة فضالة - المحمدية
ن
1996
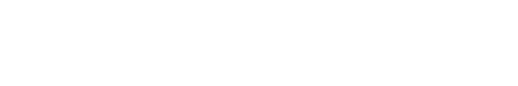

بسم الله الرحمن الرحيم
في كتابة لي سابقة عن الإبداع والتجديد في القصيدة
الزجلية عبْر فن الملحون، كنت انتهيت إلى أن الزجل الحديث والمعاصر يفتقد كثيرا من
مقومات الشعر، إلا ما كان صادرا عمن استوت لهم هذه المقومات أو جلها؛ وذكرت من بين
هؤلاء حُسني الوزاني)1(، وكان يومئذ قد أهداني ديوانا له
مرقونا ضم مجموعة من أزجاله، وجعل لها عنوانا موحيا بمضامينه، هو "الحبُّ
صولة وجولة")2(.
إن مقومات الشعر – أي شعر – تبدأ لا شك من اللغة التي قد
يختار لها المبدع قالبا فصيحا أو عاميا هو الذي يعطيها طابعها المدرسي أو الشعبي ؛
ولكنها لا تقف عند الحد اللغوي باعتباره أداة التعبير أو إحدى أدواته، إذ تتجاوزه
إلى الإيقاع بشتى مكوناته، وإلى الآفاق التصويرية بجميع ما تتيحه للشاعر مخيلته
وما يختزن ذهنه من قوى وطاقات لاختراق هذه الآفاق ؛ في نطاق محتوى فكري غني ومحمول
شعوري فياض.
وحتى على مستوى اللغة، فإن امتياحها من العامية لا
يعطيها وحده ملمح الشعرية الزجلية، ما لم يكن هذا الامتياح نابعا من إمكانات تجعل
الشاعر قادرا على توظيف الألفاظ والتراكيب المتداولة على ألسنة العامة، في سياق
يبلور خفاياها ويكشف شحناتها ويفجر ما في خباياها من طاقات، وربما قادها – إن
توافرت له براعة التعبير– في مسالك غير معهودة ولا متداولة.
وإذا كان الديوان الأول للشاعر الوزاني قد جعلني أحله
مكانا متميزا إلى جانب ثلة من الزجالين المجيدين، فإن ديوانه الجديد "رياض
العشاق" جاء ليؤكد حضوره ويقوي موقعه بين هؤلاء المبدعين.
وهذا هو الديوان الذي يسعدني في بهج وحبور كبيرين أن
أزفه إلى قراء الشعر المغربي عامة وهواة الزجل خاصة. ولولا أن الشعر لا يحتاج إلى
من يقدمه، إذ ينفذ إلى النفوس ويتسرب إلى أعماقها بتلقائية وانسياب، لأفضت القول
عن قصائد هذا الديوان الموقعة على أشكال لحنية متنوعة، والمفعمة بأريج ذات ملتهبة
جياشة لم يحل تأجج مشاعرها وتدفق أحاسيسها دون الوقوف لحظات متأنية للتأمل.
فليهنأ أخي وصديقي الأستاذ الشاعر حُسني الوزاني أن تسنى
له هذا الإصدار، وليتابع إنتاجه الشعري في توفق وتفوُّق دائمين، والله المستعان.
وحرر بالرباط في 3 رجب 1417هـ
الموافق 15 نونبر
1996م
(1)
وهنا كذلك أرى ضرورة التنويه ببعض الزجالين الذي استوت
عندهم الكلمة الشعرية العامية، أولئك الذين يحاولون تطويع هذه الكلمة للغناء أمثال
حسن المفتي وأحمد الطيب العلج وعلي الحداني ؛ أو أولئك الذين لم يوظفوا أزجالهم
لهذا الفن، أمثال أحمد لمسيح ومالك بنونة وعبد اللطيف بن يحيى وحُسني الوزاني. د/
عباس الجراري: كتاب "في الإبداع الشعبي" صفحة 102،
الصادر عن مطبعة المعارف الجديدة سنة 1988.
(2) الصادر
سنة 1982 (بطنجة) مرقونا ومطبوعا على
اسطانسيل.
محمد
المختار السوسي
إعــداد
د. مصطفى الشليح
ذ. أحمد السليماني – د. بوشتى السكيوِي
الناشر:
مؤسسة أونـا
سلسلة: أعلام المغرب
1996
بسم الله الرحمن
الرحيم
لسِيَر الأعلام في الثقافة العربية الإسلامية – وكل ثقافة – حيز لا يضاهيه
أي حيز آخر، لما لهؤلاء الأعلام من دور في إبداع الفكر وتوسيع آفاق المعرفة في شتى
مجالاتها العلمية والأدبية والفنية وغيرها ؛ ولما لسِيرهم في نفوس الأجيال
المتعاقبة من مكانة تتجلى في التعلق بها، والتشوف لمخبآتها، والتطلع من خلالها إلى
تجاوز حواجز الزمان والمكان، واستحضار التاريخ لمعايشته عبر لقطات حية تكشف عن
تجارب الماضين، وتوحي بدروس وعظات من حياتهم، وتحث على الاقتداء بهم، وتنبه إلى ما
على الأخلاف أن ينهضوا به مما لم يتسن للأسلاف ؛ فينتج عن ذلك مظهر لعله أبرز
مظاهر تداخل الحضارات وتواصل الثقافات، دونما انقطاع في المسيرة الإنسانية، وفي
غير صراع كذلك.
ولا بدْع في هذا السياق أن يكون للسِّير حضور متميز في تاريخ المغرب وفكره
وأدبه على امتداد حلقاته وأطواره، وإن لم يُعن المغاربة كثيراً بالتدوين على النحو
الذي يحفظ لتلك الحلقات والأطوار استمرارية متماسكة تجعلهم جيلاً إثر جيل يتابعون
ويلاحقون ويكملون.
من هنا، وعلى كثرة كتب الفهارس والتراجم بالنسبة لغيرها، كان الشعور – منذ
القديم – بالحاجة إلى مزيد العناية بهذا الحقل التأليفي الهام الذي لا شك يرتبط
بمدى الاهتمام بالرواية على العموم، في مقابل الدراية التي كانت أحد أسس التعليم
والتثقيف في المغرب.
وعندي أن هذه هي إحدى الصعوبات التي تعترض اليوم كل من يرغب في تسجيل حياة
الأعلام، حتى حين يكون هؤلاء من المتأخرين وربما من المعاصرين. وتزيد في هذا
التوعُّر مشاق أخرى نابعة من طبيعة الكتابة في هذا الفن، وما تقتضي من ملكات وقدرات
تبدأ من إمكان البحث والتنقيب لاستجماع المادة واستقصائها، إلى التحري في استخلاص
الحقائق بموضوعية تبتعد عن هوى الذات وتيارات العصر الجاذبة، وبإنصاف ينأى عن كل
انحياز. يضاف إلى ذلك ما تتطلبه هذه الكتابة من مناهج وأساليب من شأنها أن تشد
القارئ وتغريه بالتتبع وتفضي به إلى التجاوب والمصاحبة.
من هذا المنظور لأهمية سِير الأعلام وما تعانيه الثقافة المغربية في
مضمارها المُلح، كان ابتهاجي بهذا الكتاب القيم الذي التقت على صحائفه أقلام ثلاثة
من علمائنا الباحثين وأدبائنا الكاتبين، هم الأصدقاء الزملاء، الأساتذة أحمد السليماني
ومصطفى الشليح وبوشتى السكيوي ؛ شغفوا جميعاً بالتراث المغربي قديمه وحديثه، كلٌّ
في دائرة اهتمامه الدراسي وتخصصه الجامعي، وأدركوا بحسهم الوطني وممارستهم العلمية
ما يعانيه هذا التراث من نقص في التعريف بأعلامه، فانبروا لخوض غماره بالاشتراك في
تحرير سيرة أحد أبناء المغرب البررة، قضى حياته مجاهداً في سُوح الوطنية والعلم
والأدب، تعليماً وتأليفاً وإبداعاً ؛ وهو محمد المختار السوسي الذي تشدني إليه
وشائج عميقة منذ طفولتي الأولى، بسبب الروابط المتينة التي كانت تجمعه بوالدي
يرحمه الله وإياه ؛ مما مهد لي سبيل التعارف فيما بعد، وقد قَوِي الالتقاء على
صعيد الأدب والفكر.
ولا أخفي أني أُخذت بالفصول الثلاثة التي يضمها هذا السفر النفيس، والتي
جاءت متسمة كلها بدقة البحث وروعة العرض وجودة التحليل، والقدرة على الغوص في مادة
غنية متراكمة، وتخيُّر عناصر مركزة منها لتقديم ملامح مميزة لشخصية العلامة
المختار، في سبْك منسجم مَسوق بتوافق وتكامل، على ما يطبع كل فصل من خصائص تعكس ما
يتفرد به كل واحد من الإخوة الثلاثة المؤلفين.
وإني إذ أنوه بهذا العمل الجليل، وبما بذل فيه منجزوه من جهد يستحقون عليه
عظيم التقدير وكبير الثناء، أشكر للمؤسسة التي بادرت إليه عزمها على التحفز منه
لتنفيذ مشروع آمل أن يكون مثالاً يحتذى في مجال تقديم سِير أعلام المغرب، للحاجة
الملحة إليها في سد ثلمة كبيرة تعانيها ثقافته، وملء فراغ هائل يشكوه تاريخ هذه
الثقافة قديمه والحديث.
والله ولي العون والتوفيق.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1417هـ
الموافق 18 نونبر 1996م

![]()
شعر الجهاد في الأدب المغربي
من عهد الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي
حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي
للدكتور عبد الحق المريني
رسالة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب المغربي
من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
الجزء الأول
الجزء الثاني
1417هـ - 1996م
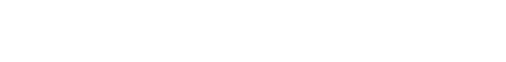
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
من بين أهم السِّمات التي تميز عموم الأدب الذي صدر عن
المغاربة على امتداد التاريخ، والشعر منه على الخصوص، يبرز مَلْمحان متداخلان
ومتكاملان، هما الواقعية والالتزام ؛ إذ يشكلان ظاهرة تكاد لطغيانها أن تُحول
النظر عن هذا الشعر، في غير اعتراف به. وإذا ما التُفِت إليه، فإنه يواجَه بالنقد
المهاجم له والطاعن في فنيته، معتبراً إياه مجرد مستند يضاف إلى وثائق التاريخ.
إلا أني لا أرى الأمر بهذا الإطلاق، لأن الشاعر الملتزم
بصدق والمتحرك في إطار واقعه بحق، ليس هو الذي يقتصر على التدوين والتسجيل، لأنه
إن فعل يكون موثقاً إن لم أقل مؤرخاً ؛ ولكنه الذي ينصهر في هذا الواقع ويستمد منه
وينفعل به ومعه بإحساس مرهفٍ يجعله يَرصُد الأحوال والتناقضات والمتغيرات والعوامل
الفاعلة فيها ؛ ولا يكتفي برصدها، بل يعانيها ويندمج فيها، وينتهي منها إلى موقف
متميز يكون نابعاً عنده من وعي صحيح ورؤية صائبة، ومفضياً به إلى تعبير فني لا
يخلو من إبداع وروعة إذا ما توافرت له إمكانات هذا التعبير.
ثم إن ارتباط الشاعر بواقع مجتمعه، في التزام بقضاياه
الوطنية والدينية وغيرها مما يشغله وأمته من هموم وآمال، لا يحول دون انبثاق شعره
من أحاسيس وخلجات ينطلق منها هذا الشاعر في أجواء حرة، غير مشلول الحركة من جهة،
ولا هارباً من نفسه ومجتمعه في انزواءٍ لا يؤدي إلى غير اجترار آلامِ ذاتٍ مريضة.
من هنا كانت عناية هذه الأطروحة بشعر الجهاد في الأدب
العربي بالمغرب، باعتبار هذا الشعر ظاهرة تلفت انتباه الدارسين المعتنين، وتغريهم
ببحثها، على سعة المادة التي تعكسها، وصعوبة استقصاء هذه المادة ومواجهتها
بالاستقراء والتحليل وشتى أدوات المنهج الملائم.
ولعل غير قليل من الضباب الذي يؤثر على وضوح صورة الجهاد
في الأذهان راجع إلى المصطلح نفسه، بما ينم عنه في مدلوله اللغوي من جهد وجرأة
وشجاعة، وبَذْلٍ وتضحية لحماية النفس والوطن والكيان بجميع مقوماته، ولردِّ مختلف
أنواع البغي والعدوان، ولتحقيق الأماني والآمال، وإتاحة حياة الحرية والعزة
والكرامة والسعادة. وحين يُنظر إلى هذا المدلول من الزاوية الإسلامية، تتحول كل
تلك الأهداف لِتُوجَّه في سبيل الله ونصرة دينه وطلب مرضاته.
غير أن هذين المدلولين لا يبعدان الجهاد عن مجاله
البُطولي، بل يُقويانه ويُرسِّخانه، سواء في بعده الفَرْدي الذي يظهر به الشخص
مُزوَّداً بطاقة عادية أو خارقة يتوسل بها في تحقيق الغلبة والنصر، ومزوداً كذلك
بقيم وفضائل تدفعه إلى خوض غمار الصراع ضد الخصوم والأعداء ؛ وكذا في بُعده
الجماعي الذي يجعل الأمة كلها تتعبأ لمواجهة التحديات التي تسعى إلى المس بسيادتها
ووحدتها، أو عرقلة نموها وتطورها وما تتطلع إليه من رقي وتقدم.
والجهاد بهذا يشكل ملمحاً من ملامح حياة الأفراد
والشعوب، في ارتباط بالروح الديني وما يبث من مكارم، وما يحث عليه من مواقف
للمحافظة عليها والدفاع عنها حتى لا تهان أو تداس.
وهو حين يَرتبط بالتعبير الشعري المُعرِبِ عن الواقع،
يتجاوز كونَه مُجردَ قيمة كبيرة سامية أو مبدإٍ مثالي رفيع، ليتجلى ملموساً كما
مُورِسَ في هذا الواقع، وليتبلور في ذهن المتلقين لذاك التعبير، ويتسرب إلى
إحساسهم، فيدركوه ويستوعبوا أهدافه، من خلال ما يُخلفه في أعماقهم من آثار تجعلهم يستحضرون
نماذج فريدة ومثلا عليا يكيفونها مع مشاعرهم الوطنية، وخلجاتهم الدينية، وذواتهم
التواقة إلى المواقف المجيدة العظيمة.
وفي هذا ما يُفضي إلى تعبئة النفوس ومَلْئِها بالثقة،
وإِفْعَامِها بالتفاؤل، لا سيما في المرحلة المعاصرة التي أخذ فيها الجهاد مفاهيم
وأبعاداً أخرى جَعلت الأدب المعبر عنه يُقدم صوراً جديدة من نضال الأفراد وكفاح
الشعوب، في ظل ظروف وشروط مخالفة، وإن ظلت النوازع والغايات واحدة أو تكاد.
وزاد في صعوبة الموضوع وسَعَة مادته، تناولُه عَبْرَ
فترة طويلة تمتد من منتصف القرن الخامس الهجري إلى منتصف الثالث عشر. وهي فترة
حافلة بالأحداث المتلاحقة فيها والمتعاقبة، وغنيةٌ – نتيجة هذا – بالتحولات
التاريخية التي عكست تطورات سياسية وفكرية واجتماعية، سواء على مستوى المغرب أو
الأندلس أو الأقطار المجاورة ؛ إذ عرفت في عهودها الأولى وحدة بينها جميعاً، كان
للمغاربة دور كبير في حمايتها والذود عنها وتحمل عواقبها، لا سيما بعد انقضاء هذه
العهود وما تلقوه إِثْرَها من ردود فعل انتقامية.
وكان من نتائج هذه الحقائق أن بَثَّتْ في كيانهم على
العموم، وعلمائهم وأدبائهم على الخصوص، شعوراً عميقاً بتلك التحولات، وزادتهم
تمسكاً بالدعائم والمرتكزات، وقَوَّتْ إرادتهم في الصمود والثبات.
وحتى تتبين معالم هذا الجهاد ومواكبة الشعر له، فقد بدأ
الباحث باستعراض هذا الشعر في عهد الفتح الإسلامي عامة، وما كان منه متصلاً
بالمغرب خاصة، مع الإلمام بما قيل منه في ظل الأدارسة. ثم تناول ما كان منه مرتبطاً
بالفترة المحددة، منضوياً تحت أغراض بدأها بالفتوح، لينتقل منها إلى المقاومة، غير
مهمل ما جاء من الشعر الجهادي مدمجاً في المدائح والمولديات. وانتهى بعد ذلك إلى
تأمل خصائص هذا الشعر في جانبيها الموضوعي والفني، مركزاً على أنه مطبوع بميسم
الشجاعة والإقدام، للدفاع عن الأرض والعقيدة ؛ ينوه بالأبطال الذين بذلوا النفس
والنفيس، ويشيد بهم وهو يقدم صوراً حية لمواقع القتال، وللمجاهدين فيها وما كان
لهم من مواقف ومعارك، وما توسلوا به في ذلك. ثم هو يعرض وقع النصر في النفوس وما
تشعر به وتعبر عنه من نشوة، وهي تتغنى بما حققته للدين والوطن، في تحريض على
متابعة الجهاد ومواصلته، وفي حث على الاستشهاد ورثاء الذين استرخصوا أرواحهم فيه.
وغالباً ما يلجأ الشعراء في ذلك إلى التناول المباشر الذي تطغى عليه الألفاظ
الموحية بالحرب والقتال، في تعبير عَفْوي تداخله محسنات محدودة وتضمينات معرفية،
وفي اعتماد على الإيقاعات القوية الملائمة، واللجوء أحيانا إلى الحوار.
ولم يكتف الدارس بهذا، ولكنه بعد أن قدم مجموعة من
الفهارس والمَسَارد، ألحق بأطروحته عدداً من النصوص الغميسة التي رأى إِيرادَها
كاملةً مما يتمم الشواهد التي توسل بها في البحث.
ولا أخفي أن الدراسة بهذا تعتبر مرآة لحال الجهاد كما
عبر عنه الشعر، مما يجعلها إضافة أدبية وتاريخية ذات أهمية قصوى وغِنىً متفرد.
وتعتبر كذلك استفزازاً للوجدان المغربي الذي لم تفتر حيويته، على ما تعاقب عليه من
وقائع وأحداث، وعلى ما قطعه من أشواط رافقها تطور كبير مس مفاهيم البطولة والجهاد.
ثم هي تعتبر نموذجاً يحتذى لمتابعة الدرس في موضوعها الممتد المتواصل.
ومن الإنصاف للباحث الفاضل السيد عبد الحق المريني صاحب
هذه الأطروحة الجيدة التي سعدت بالإشراف عليها، أن أشهد له بالجهد الكبير الذي
بذله في البحث والتنقيب، بأنَـاةٍ وصبر، وتريُّثٍ واتِّزان، وإصرارٍ على مواجهة
الصعب واجتياز الوَعْر ؛ في تواضع جمٍّ جُبِلَ عليه بجميل وَدَاعته ولِين طبعه
وحُسن سلوكه، وفي تطلع دائم عنده لمزيد من الدرس والتكوين، وطموح كبير لإشباع ميله
الأدبي، ورغبة ملحة لاكتساب الجديد من العلوم والمعارف.
آية ذلك هذه الأطروحة التي توج بها أعمالاً علمية كثيرة
حرَّرها في موضوعات مهمة ودقيقة، ككتابته عن المهدي بن تومرت، وعن المرأة، وعن
الجيش المغربي ؛ وكعنايته بجمع ديوان "الحسنيات" الذي يضم الأشعار التي
واكبت المسيرة الحسنية وعنايته أيضاً بجمع عدد من كلمات مولانا أمير المومنين
جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله وأعز أمره، وفق ترتيب يُيسِّر الرجوعَ إليها
والاستفادة منها ؛ وكإعداده بالاستكتاب لدراسات وشهادات عن جلالته ووالده المنعم
مولانا محمد الخامس رضوان الله عليه ؛
وكذا إعداده بالاستكتاب أيضاً لمدخل عن تاريخ المغرب الحديث.
ولا أخفي ما شعرت به من بهَج وحبور حين أخبرني الأخ
المريني بعزمه على إخراج أطروحته من رفوف مكتبته لترى النور، ثم حين طلب مني أن
أقدم لها بهذه الكلمة.
ولست أشك في أن الطلبة والدارسين وعموم القراء سيقبلون
عليها ويفيدون منها في الإطلاع على صحائف مشرقة من تاريخ المغرب المجيد وإبداع
شعرائه المواكب لهذا التاريخ والمُرهِص به في نفس الآن.
فليهنأ الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد الحق المريني
بهذا الإنجاز القيم، وليواصل جهوده المثمرة المعطاء، والله تعالى يوفقه ويرعاه
ويسدد خطاه.
الرباط في 13 شعبان
1417هـ
الموافـق 24 دجنبر
1996م
المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط
سلسلة: رسائل وأطروحات – رقم 43
الشعر المغربي
في عهد المنصور السعدي
956 هـ - 1012 هـ
1549م - 1604م
للدكتورة نجاة المريني
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
الطبعة الأولى 1999

![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
في تاريخ المغرب – على امتداده وغناه – فترات متميزة
بظهورها السياسي والعسكري، وازدهار الحضارة فيها والثقافة ؛ مما يتيح للفكر والأدب
مجالاً خصباً للتألق والإبداع.
ويعتبر العهد السعدي في مقدمة هذه الحقب الثرية
المتفردة، إذ جاء حلقة محكمة بين مرحلتين مضطربتين: إحداهما برز فيها الوطاسيون
الذين أعقبوا الحكم المريني متفرعين عنه، وكانوا غير قادرين على إقامة الدولة وما
تستلزم من مقومات للمحافظة على الكيان ورد التحديات الداخلية والخارجية التي كانت
تواجهه ؛ والأخرى مثلتها بعض الإمارات التي تشكلت في خضم سلسلة من الفتن والقلاقل،
على نحو ما كان للسملاليين وأصحاب زاوية الدلاء ومن إليهم، كأبي محلي والعياشي
وأبي زكرياء الحاحي، والتي كانت بدورها عاجزة – على الرغم من طابع بعضها الجهادي -
مما مهد لقيام الدولة العلوية، ومكنها من إعادة بناء هذا الكيان واسترجاع قوته
وهيبته.
وقد تسنى للسعديين – وهم يحتلون هذا الموقع – أن يجنوا
ثمار الغرس الحضاري والثقافي الذي أخصب في العهود السابقة، إضافة إلى الرافد
الأندلسي الذي صب كلياً في المغرب بعد انتهاء الوجود الإسلامي في الفردوس المفقود
؛ دون إغفال الاحتكاك النِّدِّي مع المشرق الذي كان يومئذ تابعاً لسيادة
العثمانيين، وكذا الصدام الحربي مع البرتغال وما أفضى إليه من انتصار في معركة
وادي المخازن الفاصلة.
ولم يكن بدعاً في ظل هذا الوضع أن تزدهر السياسة وينمو
الاقتصاد ويتسع النفوذ، وأن تتجلى بعض الظواهر التي كانت في نفس الوقت عوامل فاعلة
في إغناء حركة الفكر وإذكاء جذوة التعبير، إذ وقعت العناية بالمراكز العلمية
والمؤسسات الثقافية وما إليها من خزائن ومكتبات، وانصب الاهتمام على بعض المناسبات
الحاثة على لَمِّ المبدعين وإتاحة فرص القول أمامهم، مع رعاية خاصة للاحتفال
بالمولد النبوي الذي كان أُحدث من قبل. وكان لاكتمال الفن الموسيقي أثره في تألق
هذا العصر، بعد أن تم نقل تراث "الآلة" الأندلسية وتوظيفها والإضافة
إليها، مع ما كان لها من أثر في تطوير الأنماط الأخرى المحلية.
وإذا كان العصر السعدي في عمومه قد شهد هذا الائتلاق،
فإن عهد المنصور في سياقه تميز – نتيجة كل تلك المعطيات والمؤثرات – بما بعث في
النفوس من ارتياح كبير ونشاط متتابع وتجاوب تلقائي، مما غَذَّى الأحاسيس وحثها على
التعبير والرغبة في توصيله إلى الآخرين، طالما توافرت لها ممكنات هذا التعبير،
وتسنى لها شعور بالذات بلغ عند البعض درجة الإحساس بالتفوق والاعتلاء، ولم يلبث أن
قاد المبدع إلى تشكيل عالم خاص تكون له فيه رؤى شخصية عَبْرها ينظر ويتأمل ويتفاعل
ويعرب.
*** *** ***
وإن البحث في هذا الإبداع – والشعري منه على الخصوص – هو
الذي قصدت إليه هذه الأطروحة الجيدة التي أنجزتها الأستاذة المقتدرة نجاة المريني،
والتي يغمرني البهج والحبور بتقديمها، مثلما أفعمتني السعادة بالإشراف عليها قبل.
فقد أخذت الباحثة على نفسها أن تدرس "الشعر المغربي
في عصر المنصور السعدي"، من خلال خصوصياته ومميزاته، وأن تكشف الطاقات
والقدرات الذاتية التي تشكله، والتي تدعو إلى إحداث التواصل، في نطاق مشاعر فياضة
وحاجات مشتركة وحوافز دافعة ليس إلى مجرد التلقي والإعجاب، ولكن إلى الإثارة
والاستفزاز، وإلى الحلم كذلك.
وهي إذا كانت قد حصرت دراستها في فترة محدودة هي حقبة
المنصور، فإنها لم تفعل ذلك اعتباطاً أو قسراً، ولكن ليقينها بحق أن هذه الحقبة
تفردت بما لم يظهر في غيرها، خاصة في ميدان الأدب والشعر، ليس فقط نتيجة ما سلف
ذكره من ظروف إيجابية طبعت الواقع وأثَّرت في فنون القول، ولكن أيضاً بحكم ما كان
يتمتع به هذا السلطان من شخصية استقطبت الشعراء حتى قالوا فيه ما لم يتَسَنَّ قوله
في غيره. وكانت الدكتورة نجاة جديرة بخوض هذا الغمار الصعب الدقيق، بعد أن كتبت في
السابق رسالة دبلوم الدراسات العليا عن شاعر السعديين الأول عبد العزيز الفشتالي،
معتنية بصنع ديوانه ودراسته ؛ وكنت قد سررت بالإشراف عليها في هذا العمل وتقديمه
حين نشر.
قد يبدو شيء من التعسف في هذا المنحى من الدرس الذي يربط
الشعر بحقبة محددة، لولا أن الباحثة كانت واعية بتداخل الأزمنة لا سيما حين تكون
متقاربة، ومدركة لما لها من عوامل مؤثرة في الإبداع. وما التحديد إلا محاولة لوضع
الإطار الذي يُمَكِّن من التحكم في الموضوع وضبط أطرافه، وتوجيه الرؤية وتخَيُّر
النصوص وإجراء التحليل واستنتاج الخصائص، في غير فصل للمرحلة عن غيرها، أو بتر لها
عن سابقاتها أو اللاحقة.
من هذا المنظور عنيت الأطروحة بالشعر الرسمي، أو الذي
ارتبط بالبلاط، والمقصود بلاط المنصور ؛ إلا أنها إلى جانب اهتمامها به، قدمت صورة
للعهد السعدي في أهم ما يميزه، وهو التركيز على وحدة المغرب وحماية ثغوره والذود
عنه ضد التحديات التي كانت تواجهه، مع إبراز أهمية الفتوح وما واكبها من نشر كلمة
الإسلام في عمق القارة الإفريقية، مما انعكس على توسع التجارة ونمو العمران
وازدهار الحضارة عموماً والثقافة.
وعلى الرغم من أن شعراً غير قليل قد ضاع، فإن ما احتفظ
به مدوناً في كتب التاريخ أو مبثوثاً في غيرها، كان مسعفاً للأستاذة المريني في
تناول القصيدة ودرس موضوعها وبنائها الفني، وتأمل مدى مسايرتها للنموذج المتداول
يومئذ، أو محاولة تجاوزه، سواء منه المتمثل في الشعر المشرقي أو الأندلسي ؛ مع
محاولة إظهار القدرة على التعبير وتطويره وتجديده. ولا بِدْع، فقد شهدت الحقبة مثل
هذه المحاولة كذلك بالنسبة للأنماط الإبداعية الأخرى، وحتى الشعبية منها كالملحون.
ويلفت النظر في تلك القصيدة طغيان المدح والمولديات والوصفيات، وكذا ما رافق هذه
الأغراض من تشكيل برز فيه التوشيح والبنية الهيكلية المتميزة، في تماسك وتلاحم،
وفي جمع بين المشاعر الدينية والأحاسيس الوطنية، وفي تأثر بالبيئة وما لها من
مكونات. وشعوراً من الدارسة الموقرة بأهمية النص – ولها تجربة غنية في التعامل معه
– فإنها ألحقت ببحثها مجموعة من القصائد اعتبرتها جديدة وجديرة بالتقديم والتحقيق.
*** *** ***
بهذا وغيره، تأتي "الأطروحة المرينية" متقدمة
رسائل جامعية أخرى سعدت بالإشراف على إنجازها متصلة بالعهد السعدي، لتُبين حال
الشعر العربي في المغرب، باعتباره إبداعاً لا يخلو من مقومات تنم عن قدرة الشاعر
المغربي في هذا العهد – أو غيره – على التعبير، أي على الإمساك بزمامه وإبراز ما
فيه من قيم قد تكون ظاهرة حيناً وخفية أخرى، دون إغفال ما قد يعلوه من تميز في
سياق الشعر العربي على العموم. وما أحوج هذا الشعر، وما إليه من أجناس وأنواع
أدبية وفكرية، إلى جهود مماثلة لإظهار تلك القيم وما تكشف من ملامح مشتركة أو
متفردة ؛ بتكاملها يكتمل المنظور للإبداع في كليته.
فهنيئا للزميلة الموقرة الأستاذة الدكتورة نجاة المريني
هذا السفر الجليل، تُغني به المكتبة المغربية والعربية، ودعاء إلى الباري عز وجل
أن يسدد خطاها في جميع أعمالها، ويمدها بعون منه حتى تتابع على هذا النحو الجيـد
الرائـع إخراج المزيد من الكتب القيمة النافعة.
والله من وراء القصد.
الرباط في 24 جمادى
الثانية 1418هـ
الموافــق 27 أكتوبـر
1997م
كلمة قصيرة كتبت على ظهر غلاف كتاب
الدكتورة نجاة المريني:
هـذا الكتـاب
أطروحة متميزة في سياق البحوث الجامعية التي تعنى بالأدب
العربي في المغرب، إذ تتناول فترة زاهية من تاريخه، ممثلة في عصر المنصور السعدي،
شهدت ازدهاراً مس مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ومنها
التعبير الأدبي في جميع أشكاله وأنماطه، ولا سيما الإبداع الشعري.
فقد درست
الأستاذة نجاة المريني هذا الإبداع، كاشفة ملامحه وخصائصه بالقياس إلى النموذج
المشرقي والأندلسي، ومبرزة ما لأصحابه من قدرات فنية على صوغ مشاعرهم الفردية
وأحاسيسهم الجماعية ؛ متحفزين من شخصية المنصور ومواقفه الجهادية، وما عرفت الدولة
في عهده من تفوق وتألق تجليا في المحافظة على وحدة المغرب وحماية ثغوره ومواجهة
التحديات التي كانت تعترضه.
وإن هذه الأطروحة
لتضم إلى الرسالة السابقة التي أنجزتها الباحثة عن الشاعر عبد العزيز الفشتالي،
والتي عنيت فيها بصنع ديوانه ودراسته، لتبوئ الدكتورة نجاة المريني مكانة متفردة
في تخصص هي فيه الحجة والعمدة.
وفـاء و ولاء
منتخبات شعرية من أقاليم المغرب الجنوبية
كتابة الدولة المكلفة بالثقافة
مارس 1998
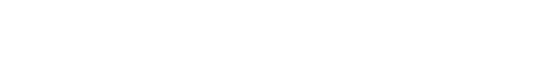

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ديوان يُعرب عن الوحدة كما عبَّر عنها شعراء أقاليم
المغرب الجنوبية من خلال الوفاء والولاء. والحديث عن الوحدة هو حديث عن الذات في
التحام وشائجها، والتئام أواصرها، عبْر روابط متينة لا تنحل وعرى ثابتة لا تنفصم.
وإن هذه الذات لتتمثل في الوطن ببنياته الجغرافية ومكوناته التاريخية ومقدساته
الدينية ومقوماته الثقافية، مما يشكل الهوية التي بدونها لا قيام لهذا الوطن ولا
وجود.
وإذا كانت هذه العوامل مجتمعة – في تركيز من الناحية
الدينية على العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السّني – قد ألحمت بين شمال
المغرب وجنوبه على مدى القرون والأجيال، فإن مدارها كان على نظام
"البيعة" الشرعية التي بها تسنَّى للمغرب أن يحافظ على قوة وحدته وعظمة
كيانه، وأن يواجه التحديات المختلفة التي حاولت عبثا عرقلة سبيله، وأن يصمد لشتى
الزوابع التي لم تفلح في تصديع بنيانه.
ولو حصرنا التمثيل لهذه الظاهرة عند الدولة العلوية
الشريفة – على طول عهدها المديد – لوجدنا سكان الأقاليم الجنوبية يعربون باستمرار
لملوك هذه الدولة الأشاوس عن مغربيتهم، بتقديم البيعة لهم، على النحو المعروف من
الطرق المتداولة، ووفق التقاليد المرعية، سواء بالإشهاد العدلي المكتوب، أو بتوارد
الوفود، أو بإلقاء الخطب وبعث الرسائل، وما إلى ذلك مما هو معمول به حتى اليوم في
ظل مولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني المؤيد بمدد الله المعين.
وإن هذا الإعراب عن الانتماء ليبدو في ظواهر أخرى تعززه،
أذكر منها ما يلي دون تفصيل:
1 – إشارة العلماء الصحراويين في
تراجمهم ومؤلفاتهم إلى نسبتهم المغربية واعتزازهم بها.
2 – اعتماد البرامج والمتون
العلمية المغربية في الدراسة والعناية بشرحها.
3 – ارتباط الزوايا في الصحراء بالطرق الصوفية المغربية، وتبادل الرسائل بشأن
هذا الارتباط.
4 – انتقال علماء وأدباء صحراويين للاستقرار في أقاليم الشمال ومدنه، والعمل
في التدريس أو القضاء أو الإدارة وغيرها.
5 – تبادل زيارة الوفود
بين الشمال والجنوب.
6 – تبادل الرسائل الرسمية والمساجلات الإخوانية والإجازات
العلمية والمسائل الفقهية والألغاز
الشعرية.
7 – عناية الملوك العلويين بطبع كتب المؤلفين الصحراويين.
8 – اتصال شعراء الأقاليم الجنوبية بهؤلاء الملوك، لمدحهم بقصائد
يعربون فيها عن ولائهم، وكذا مدح بعض
الأمراء.
*** *** ***
من هنا يتبين أن الشعر كان – وما يزال – أداة تأكيد للوحدة
والتعبير عنها بامتياز، إذ هو ديوان أهل الجنوب، يقولونه مبدعين فيه، مثلما
يتنفسون هواء الصحراء الصافي النقي ؛ يعبرون به عما يخالج أحاسيسهم وما تكنه
ضمائرهم، ويعربون به عن كُنه وجودهم وحقيقة ذاتهم، ويتجاوبون به مع أصداء بيئتهم،
يمدون عبره النظر إلى أطرافها المتباعدة وآفاقها المترامية، ويكشفون غوامضها وما
فيها من مخبآت. يتبادلونه ويراسلون به، فيجد صداه العميق في نفوس متلقيه، يتلقفونه
ويندمجون فيه، مدركين بواطنه الخفية وأسراره العميقة، إذ بصدق يُبعث، وبصدق كذلك
يتقبل، فيترك أثره في كوامن الذات الفردية والجماعية، مشعراً إياها بأن منها يصدر
وإليها ينفذ، فيقوي العزائم ويحرك الهمم ويحث على مزيد من الخلق والإبداع، ليبرز
حقيقة الانتماء والهوية، ويؤكد دعائمهما الثابتة وركائزهما الراسخة، مع السبق في
بعض الأحيان، على نحو ما فعل محمد البيضاوي الشنجيطي حين بادر إلى تهنئة جلالة
الملك المنعم محمد الخامس باعتلاء العرش، وتعزيته في والده المغفور له المولى
يوسف، في قصيدة قال فيها مازجاً بين الغرضين:
ذهب الإمام أبـو المحاسن سـيـّدا ومحمدٌ كفـؤ الإمــام السيــــــد
التــاج أقـســم لا يفـارق هـامكـم يـا آل حـيـدرة وأل مـحمـــــد
أمحمدا يا بنَ الحـلاحـل يوسف جـدّدْ عهـود محمـد ومحمــــد
وارع الإمـامــة والـرعيـة مشفقــا بسيـاســة ورويـة وتـعـهُّـــــد
واكشـف عـن الأبصار كل غشاوة وغباوة فالجهل أعظم مفســـــد
ويتوالى هذا التعبير الوطني الوحدوي في حلقات متتابعة،
أبرزها القصائد التي أعرب فيها شعراء الصحراء عن تأكيد ولائهم المجسَّد في تجديد
البيعة، على نحو قول أبي بكر مربيه ربه، متحدثاً عن شنجيط ومدى تشبثها بهذه
البيعة، في قصيدة ألقاها وقد حضر ضمن وفد من أبنائها لمقابلة الملك المجاهد محمد
الخامس سنة سبع وخمسين وتسعمائة وألف:
هي في بـيعـة السـلاطيـن قـدمـا
وهي الآن تحت عرش الأميــر
عرش فخر الملوك
رمز المعالـي
ال
خـامـس ابـن يوسف المنصــور
يــا
ظـلالا علـى
الـورى وربيـعـاً
لغــنـــي ومــرمـــل وفـقـيـــر
إن شـنـجيـط قـد أتـتـكم لتجــد
يـد عـهـود الـولا بجـم غفيــر
وتبلغ هذه القصائد أوجها بما قدم هؤلاء الشعراء إلى قائد
المسيرة جلالة الملك الحسن الثاني أعزه الله، وهو يخوض معركة استكمال الوحدة
الترابية، وفق ما قال الشيخ ماء العينين لاراباس في قصيدة يتوعد الإسبان، ويخاطب
جلالته يبلغه نداء رعاياه الصحراويين:
فإن لم تسرْ اسبان مِ
الساقيا الحمرا تـرى مـن دم الأحـرار ساقية حمرا
فإنـا دعـاة السلـم إن جنحوا لهـا وإلا فنـار الحرب نسعـرهـا سـعـرا
أيـا حسـن خير المـلـوك ومـن بـه حبانا إلاه العرش بالنهضة الكبرى
فهـا هـم رعاياكم وخـدام عرشكـم ينـادونكـم مـهـمــا
ألـم بهم قهــرا
أنـقـذت م الأعـدا حواضـر أرضنـا فانقذ مـن الأعـداء مغاربـة
الصحرا
وخلصهم من غاصب ليس يرعوي يروم بأقصى جـهده القطع والبـتـرا
*** *** ***
ذلكم هو الشعر الذي عرف – ويعرف – في الأقاليم الجنوبية
تألقا قل له شبيه أو نظير، على الرغم من اتساع حركته وازدهارها في سائر ربوع
المغرب وعلى صعيد الأمة العربية.
ويبدأ هذا التألق من إعطاء الشعر مفهوما يشترط فيه
الفصاحة التي لا يستطيعها إلا البلغاء القادرون على إحكام صياغته، والإتيان به في
ألفاظ سلسة عذبة، ومعان بكر جديدة لا تمحن فيها ولا تكلف للضرورات، على نحو ما يرى
أحمد الهيبة، داعيا إلى الوقوف على الأطلال، وذكر الديار والفيافي والراحلة،
والاشتياق للغواني والأحباب:
وكذا الشعر ليس إلا فصـيحا
نـحتـتـه مـن ذهنها البلغــاء
بدؤه الذكر والـديار اشتياقــا
والـغـوانـي والعيس والبيـداء
فحل لفظ ونسجه بكـر معنى
مـحكـم اللفـظ أشعلته لظــاء
لم يكن للإسماع أسبق معـنى
من مجال، الأفكار فيه سواء
سلسبيل بل انسـجام فـرات
شـرر لا التضـمـيـن والإقـواء
صـيـغ درا بلا تكلف ذهــن
مـن هـم هـكذا هـم الشعــراء
وهي شروط تربط الشعر بالفحولة والطبع وعدم التكلف وما
يرتبط بذلك وينتج عنه من مقومات عليها كان اعتماد شعراء الأقاليم الجنوبية في
النظر إلى الشعر وتحديدهم لمفهومه والبناء عليه ؛ إذ انطلاقا منه أبدعوا قصائد
كانوا فيها يستوحون بيئتهم وما لها من تأثير على النفس والوجدان والذوق، ويستلهمون
شعر العرب القديم، ولا سيما جاهليه والأموي، يحاولون معارضة قصائده المشهورة،
ويعلنون التنافس مع كبار شعرائه، يلتمسون التفوق عليهم، في تفاخر مكشوف لا يرون
إضماره أو إخفاءه. فكانوا بهذا الاستحضار للتراث يعملون على إحيائه بسبق وعفوية
يستدعيان في نظري مراجعة قضية بعث هذا التراث أو بعضه على يد شعراء المشرق إبان
النهضة الحديثة. وقد كانت لي بصدد هذه المراجعة آراء أولية أرهصت بها، لعلها أن
تعمَّق فيما بعد.
*** *** ***
على أن حركة الشعر في الأقاليم الصحراوية لم تكن تقتصر
على هذا النمط من التعبير المعرب، ولكن تعدته إلى التوسل بالتعبير الشعبي المعروف
بـ: "الحساني". وهو الذي يعتمد اللهجة الحسانية التي لا يخفى انتشارها
في هذه الأقاليم وجاراتها القريبة، وتنسب إلى بني حسان الذين أقاموا هناك، ويطلق
عليها "كلام البيضان"، مع جعل الضاد لثوية ونطقها ظاء:
"بيظان".
ويعرف الشعر الحساني عندهم بـ "لَغْنا"،
ويسمون شاعره "لَمْغَنِّي" وهما مصطلحان يدلان على مدى الارتباط
بالغناء، إذ يرددون قصائد هذا الشعر ومقطوعاته يتغنون بها في أداء لا تصاحبه
الآلات الموسيقية، واعتماد فقط على الإنشاد، مع التمييز بينه وبين أنواع غنائية
أخرى تؤدى مرافقة لتلك الآلات، وأهمها النوع المعروف بـ "أوزان".
ومن تتبع ما تيسر الإطلاع عليه من نصوص ودراسات تقريبية،
يتبين أن الشعر الحساني يخضع لإيقاع أساسه أوزان لا تبتعد عن الأوزان الخليلية، بل
تكاد في بعضها تتشابه، مع مراعاة التأثر بالأنغام والألحان، والاستناد إلى
الحركات، وكذا مراعاة نظام للتقفية يبرز أهمية حرفها في إحداث الترانيم والإتيان
به متتابعا أو متخالفا حسب تقسيم النص إلى أشطار معينة تكون معروفة العدد، وربما
يتفاوت طولها حسب تلك الأوزان. وقد تأتي القصيدة كلها على نسق يعتمد وحدة الوزن
والقافية، مع الميل إلى تلوينها وفق ما تقتضيه الأشكال، وأحيانا يتخذ النص لازمة
تضبط له إيقاع الأداء.
وإذا كانت الوحدة في هذا الشعر تقوم على الشطر وليس على
البيت كما في القصيدة المعربة، فإن ذلك يعطيها غِنى يجعل من الصعب تحديد بحوره
وحصر أوزانه، وإن كان الشائع منها معروفا لدا المهتمين والمعتنين، ومعروفة كذلك
أسماءه الاصطلاحية.
وإن مما يضفي مزيدا من الجمال على شكل هذا الشعر
استعماله لمحسنات بلاغية، ولا سيما الجناس، وكذا اللجوء إلى التشبيه، وتوظيف أنماط
من الصور نابعة من البيئة ومتأثرة بالشعر العربي القديم، مع تلميحات بديعية يدركها
المتلقي المتمرس.
أما موضوعاته فمتعددة ومتنوعة، بدءا من النبويات
والغزليات والخمريات وشعر المدح والحكمة، إلى الوطنيات والقوميات والتعبير عن وحدة
التراب وما يعلوه من روح الجهاد والمقاومة.
وإذا كانت صعوبات كثيرة تعترض التعريف بالإبداع الحساني،
فإن مرد معظمها إلى عدم تدوين نصوصه التي ما زالت تتداول بالرواية الشفوية، والتي
تحتاج إلى أن يعنى بجمعها وكتابتها، حفظا لها من الضياع، مع الانتباه عند التدوين
إلى أساليب أدائها وطرائق هذا الأداء ؛ إذ لا تخفى الأهمية التوثيقية لتلك النصوص
من شتى الجوانب الأدبية والفنية والاجتماعية.
وبهذه الأهمية، يعتبر الشعر الحساني تراثا له قيمته في
حد ذاته، إضافة إلى القيمة التكميلية التي له حين يضم إلى الشعر المعرب، وكذا إلى
الأنماط التعبيرية الشعبية الأخرى كالملحون. ثم إنه دال على القدرة الإبداعية التي
لأصحابه، وهي قدرة تصل عندهم إلى حد الارتجال وتبادل هذا الارتجال في مساجلات
ظرفية تحتمها مناسبات معينة. وقد أتيح لي أن أحضر في مدينة العيون جلسات شعرية
تبارى فيها شعراء المعرب والحساني، في سجال مرتجل ينم بنفسه الطويل عن مدى التحكم
والتمكن.
*** *** ***
في هذا الإطار المبرز للشعر في الأقاليم الجنوبية
المغربية ودوره – بنمطيه المدرسي والشعبي – في إذكاء روح الوحدة الوطنية والتعبير
عنها، واحتفاء بالذكرى السابعة والثلاثين لتربع مولانا أمير المومنين جلالة الملك
الحسن الثاني أيده الله ونصره على عرش أسلافه المنعمين، جمعت هذه المختارات التي
تضم ثمانا وسبعين قصيدة لثمانية وأربعين من الشعراء، ثلاث وخمسون منها معربة، وهي
لثلاثة وعشرين شاعرا من بينهم سيدة، وخمس وعشرون منها حسانية، وهي لخمسة وعشرين
شاعرا.
وقد كلفت بجمعها لجنة سعدت برئاستها والإشراف على
أعمالها، تتكون من الإخوة الكرام السادة: الدكتور شبيهنا حمداتي ماء العينين
والدكتور المختار ولد اباه المعروفين بكبير اهتمامهما بالأقاليم الجنوبية تاريخا
وفكرا وأدبا، والدكتور محمد الظريف الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في دراسة أدب
الصحراء، والأستاذ الشاعر الطالب بوي لعتيـﮓ ماء العينين مدير مركز
الدراسات والأبحاث الحسانية بالعيون.
وكان المنهج الذي اعتمدته اللجنة في جمع هذه المنتخبات
يقتضي أن تكون كلها معبرة عن الوحدة، وأن تكون ممثلة لمختلف أجيال الشعراء
وانتماآتهم القبلية واتجاهاتهم الأدبية، مع البقاء في نطاق المعاصرة، علما بأن ما
قبل هذه المرحلة شهد شعرا كثيرا تغنى بنفس الموضوع على امتداد التاريخ، ومع الحرص
على أن تكون النصوص متسمة بالجدة، تجنبا للتكرار مع ما ضمته "باقة شعر من
أقاليم الجنوب"، وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد أصدرتها في جمادى الثانية 1405هـ الموافق مارس 1985م، احتفاء بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد. وتيسيرا للاستفادة
من نصوص هذا المجموع، فقد ذيل بعدد من الفهارس، خاصة بأسماء الشعراء والقصائد
والقوافي، إلى جانب فهرس المحتويات.
إن هذا الديوان الذي تنشره كتابة الدولة في الثقافة ليعد
عملا جليلا يظهر مدى تمسك سكان الأقاليم الجنوبية بهويتهم المغربية من خلال ما
أبدعه شعراؤهم من قصائد أغنوا بها هذا المجال الخصب من التعبير الذي يلقى عند
إخوانهم شعراء الأقاليم الشمالية من التجاوب ما يملأ دواوين كاملة.
وإني لأود باسم اللجنة وجميع القراء أن أزجي عبارات
الشكر خالصة للسيدة كاتبة الدولة في الثقافة الأستاذة الدكتورة عزيزة بناني،
لاتخاذها المبادرة إلى جمع هذه المنتخبات ودعوة لجنة مختصة لإنجازه. كما أود – في
سياق الشكر – أن أعرب لأعضاء اللجنة عن أصدق آياته، وأن أقدم ثناء خاصا للأستاذ
محمد الظريف لما بذل من جهد متميز في انتخاب القصائد المعربة والتعريف الموجز
بأصحابها، وكذا للأستاذ الطالب بوي لعتيـﮓ ماء العينين للجهد المماثل الذي
قام به في اختيار النصوص الحسانية والتعريف بأصحابها كذلك.
فلعل هذه المنتخبات أن تفي بالغرض منها، معربة عن وشائج
الوحدة وأواصرها المتينة، مع الإمتاع لمن يقرأها، والنفع لمن يدرسها أو يتطلع
لمزيد من المعرفة في هذا المضمار الوطني المتسم بالوفاء والولاء.
والله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق والسداد.
الرباط فاتح ذي القعدة 1418هـ
الموافق 28
فبراير 1998م
الموجز في الشعر المغربي
الملغـز
جمع و دراسة
الدكتور السعيد بنفرحي
الطبعة الأولى
1998
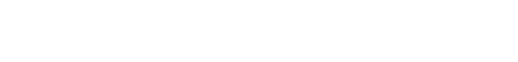

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب يضم مجموعة منتخبة من "الشعر
الملغز"، أي من الشعر صيغت فيه ألغاز.
أما الشعر، فليس يخفى أنه الفن الإبداعي الذي يعبر عن
الأحاسيس الذاتية والتصورات الدفينة والإدراكات العميقة التي لا يسعف الكلام
النثري المباشر في الإعراب عنها والاحتجاج لها.
وهو، لمزيد من التأثير الفاعل في نفوس متلقيه، بعد أن
انفعل به مبدعه وعانى دوافعه ومحركاته،
يتوسل باللغة العذبة والإيقاع الترنيمي والصور الموحية ؛ إلى جانب الصياغة الفنية
الجميلة وما تنم عنه من طبع قادر على التجاوب التلقائي، في غير تكلف، ومن رؤيا
تمكن الشاعر من إلحام التجربة بإيماآت وشحنات تتيح له أن يبتعد عن المألوف
والمتداول، سواء من حيث اللفظ أو المعنى، وأن يأتي في ذلك بالجديد والبكر من
التعابير يفاجئ بها ويدهش.
وأما الألغاز، فتتصل بهذا الشعر، لدخولها في نطاقه عبر
اللون التعبيري الذي عرف بـ"الإخوانيات" التي تدل – كما يكشف اسمها –
على ما يتبادله الإخوان فيما بينهم من مطارحات ومساجلات يعربون بها عما يشعرون به
من نبيل العواطف، وما يحتفظون به من جميل الذكريات، لا تلبث عند استحضارها أن تحرك
قرائحهم للقول في الشوق والحنين ؛ فيأتي هذا القول على شكل قصيدة أو مقطوعة أو حتى
بيت أو بيتين، وربما شطر واحد يلتمسون إجازته. وقد يتابعون هذا الشطر وما أجيز به
يضيفون إليهما، ليصلوا إلى قصيدة كاملة.
وقد ازدهر هذا النمط من القول في شتى المجتمعات العربية،
وعلى مدى مختلف العهود، عاكسا ثقافة العصر واهتماماته وحال التعبير فيه، وإن وصفت
هذه الحال بالجمود والتخلف، لما شاع فيها من قول على ذاك النمط.
ويبدو أن الألغاز من حيث هي، قد ارتبطت بالإنسان منذ
حياته الأولى وما عرف فيها من تقلبات، واضطراره إلى مواجهة غموضها وتحدياتها، على
نحو ما تكشف الحكايات والنوادر التي غالبا ما تروى على صيغة أساطير أو خرافات.
وحين ترتبط الألغاز بالشعر، فإنها تحاول اعتماد التصوير
القائم على إظهار القدرة لإيجاد روابط قريبة أو بعيدة، متشابهة أو مختلفة. وهي في
جميع الأحوال تقصد إلى الإغراب والإعجاب، وإلى التحيير والإدهاش، وإلى التمويه
والخداع ؛ إضافة إلى الإمتاع والإيناس، واختبار البديهة والفطنة، وامتحان الذكاء
والفراسة ومدى إدراك العقل.
وغالبا ما يكون اللغز متعلقا بأمر معروف يسأل عنه عبر
كلام موجز أو غامض، أو إشارة ما إلى إحدى خصائصه ومميزاته. وقد يكون منصبا على
مشكل عويص أو نازلة عميقة تحتاج إلى الشرح والتحليل. ومن ثم، فهو في حقيقته نوع من
الرمز، أو هو رمز مقصود، يحجب حله على الرغم من أن الحل موجود في ثناياه. إلا أنه
يختلف عن الرمز في مدلوله الأصلي والحق، أي الذي يظل غامضا وشائكا ولا يكون له
حلّ، أو لا يكون له حل كامل ومقنع.
ويمكن النظر إلى اللغز الشعري من جانبين: أحدهما معنوي
يعمد فيه الشاعر إلى الشيء الذي يُلغز حوله، فيشير إلى بعض صفاته، مما يذكر بما هو
معروف في سياق أبيات المعاني ؛ وإن كان الملغز غالبا ما يجتهد للابتعاد عن الدلالة
المباشرة. وقد يلجأ إلى التصوير، إلا أن الصورة عنده قد تأتي بسيطة وعارية مكشوفة
يؤيدها المنطق والواقع ؛ وقد تأتي معقدة يزيد في تعقيدها التنميق والزخرفة
المرتبطان بعمق المعنى وغنى دلالاته ؛ وأحيانا تكون على مستوى من التناقض أو
الاستحالة، إلى درجة وهْمية لا يبررها إلا هدف التدقيق أو التحسين. والثاني لفظي،
ويدخل فيه ما يعتمد الكلمة والتركيب والإعراب ؛ وهو الذي يؤسس على الحبْك، مع
التصرف بالقلب أو التصحيف أو الحذف أو ما إلى ذلك، أو مع الإغراب والمغالطة وفق ما
تسعف به بعض الجناسات. وفي هذا النوع من الألغاز يشار إلى الشيء بكلمة أو تلميح
لما يتضمنه، مع اعتماد القياس والمقارنة، إلى حدّ تساق كلمات تدل في ظاهرها على
غير الشيء الملغز فيه، وتحتاج إلى اكتناه ما تبطنه وتخفيه.
وسواء أَنُظِر إلى اللغز من هذا الجانب أم ذاك، فإن
الهدف يبقى واحداً، هو إيقاع السامع أو القارئ في الالتباس، ودفعه إلى التأمل
والتفكر، إضافة إلى التسلية والإمتاع وترويض العقل واستثارة الذهن وإظهار القدرة
على مدى كشف التلاعبات اللفظية والإيحاآت المعنوية، وتمييزها بالاستدلال والمقارنة
والاستنتاج.
وتلخص هذا كله غاية "المحاجاة" و
"التعمية" وسائر الأسماء التي تطلق مرادفة للغز، وإن كانت
مرادفاته كثيرة ؛ وربما خصت في استعمالها ببعض المجالات، كقولهم بأن "اللغز"
خاص بالمسائل الفقهية،
و"المعمى" بمشاكل النحو، و"المعاياة" بنوازل
الفرائض، و"الأحجية" بقضايا اللغة.
في هذا السياق المعروف والمتداول على امتداد تاريخ الأدب
العربي، توضع مشاركة الشعراء المغاربة في إغنائه. وهو ما سعى الأستاذ الباحث السيد
السعيد بنفرحي إلى تقديمه والتعريف به من خلال الألغاز التي صدرت عن هؤلاء
الشعراء، في مراحل طويلة تمتد من العهد الموحدي إلى العصر العلوي.
وقد عمد الدارس الفاضل إلى التمهيد لمجموعة الألغاز التي
انتخبها بمقدمة عرَّف فيها باللغز والمصطلحات المرادفة له، وساق أنواعه وأنواع الإجابات
والحلول، وتحدث عن هيكله وشكله، وعن الشعراء الملغزين. أما المجموعة فضمت نصوصا
قسمها إلى أبواب تتعلق بالأدوات والأسماء والحيوان والطعام والزمان والعملة
والطبيعة، إضافة إلى النحو واللغة وبعض المختلفات.
وإنه لَعَمَلٌ جليل عني فيه بإبراز نمط من التعبير قلَّ
الاهتمام به، على ذيوعه وشيوعه بين المتأدبين، لأنه في نظر كثير من الدارسين
والنقاد يمثل إنتاج فترة أو فترات متدهورة. وهو حكم لا يخلو من بعض الصواب.
وقد أنصف الباحث نفسه حين لم يزعم استيعاب جميع الألغاز
أو معظمها، مكتفيا بنماذج متفرقة هي ما توصل إليه، ومحددا لهذه النماذج إطاراً يدل
عليه عنوان الكتاب، وهو "الموجز في الشعر المغربي الملغز" ؛
وإِنْ وجدته في بعض الأحيان يتجاوز المغرب إلى غيره، ولا سيما الأندلس.
والحق أن المادة في هذا المجال غزيرة، تشملها دواوين
الشعراء، والمتأخرين منهم على الخصوص، وكذا كتب المجالس الأدبية وما صدر عن رواد
الأندية. وهي على غزارتها متنوعة إلى حد يصعب الإمساك بأغراضها وما تثير من
مشكلات.
ولعلي – إغناء لهذا المجموع القيم – أن أشير إلى بعض
الألغاز المتميزة والدالة على ما كان سائدا في تلك المجالس والأندية من قضايا
فكرية وأدبية وما كان مخيما عليها من مشاعر وأحاسيس. وأكتفي منها بذكر نماذج خمسة:
الأول: لغز نحوي قاله الطيب بنكيران، متعلقا
بالألف المنقلبة عن ياء المتكلم في محل جر، كما في "يا حسرتا":
أيهـا العـالـم بالنـحـو الــذي فيـه تمهـر
أين ألفيت ضميراً ألفا للفـرد
والجر؟
فأجاب أبو الفيض ابن حمدون بن الحاج:
أيهـا الملغز في يـا حسرتا ممن تحسر
لا عد مناك
مفيدا ما على الغير تعسَّر
الثاني: مرتبط بالنحو كذلك، وقد دار بين أدباء
أندية الرباط، وله صلة باللغز الذي ساق السيد بنفرحي، صادراً عن محمد الشيخ المامون
السعدي، ومُتعلقا بقول ابن مالك في الألفية: "ينصب تمييزا". ففي نفس
الموضوع، قال أبو بكر بناني:
يـا قــارئ الألـفيـة العجيبــة في أي بيـت قد أتت غـريبـة
لفظة تمييز على الحال نصب فلغزي باد يا أديب فأجب ؟
فتصدى للإجابة جماعة من شعراء الرباط، منهم محمد أبو جندار الذي قال:
جـواب لغزكم بـذا اكتسـاء بوصف
لطفكم أخـا الذكاء
في قول ذي الألفية المحبرة ينصب
تمييزا بما قد فسره
ومنهم كذلك محمد بن اليمني الناصري الذي رد بقوله:
أبديت من أبكار أفكار
الأدب عـروس لـغـز هـي غـايـة الأرب
وافت وطرفها كحيـل الحـدق فـعـلقـت عـقلـي بـفـرط الحـدق
وأقبلت ترفل فـي ثوب البهـا من
حلة الفضل الذكي ذي الدها
مـا زال حاوي في العلا
تبريزا ينصـب بـيـن الأدبــا تـمـيـيــزا
الثالث: له صبغة لغوية، وقد دار بين أدباء سلا،
ويتصل بالبحث عن كلمة "نحل" التي أشير إلى بعض متعلقاتها. وفيه قال أحمد
الصبيحي:
مـا اسـم ثـلاثي مُسمـاهُ شُربنـا لفضلتـه حقــا وصدقــا بـه نشفــى
ولـيـس بذي عقـل ولا له قـوة وصُنـعٌ لـه قد حيَّر العقـل والوصفـا
ولا تـوذه يقلبْ سُمَي فضلةٍ
له وتصحيفه خلق بذي الفضل لا يلفى
وعمَّتنـا تاتي بتصحيف وسطـه كـذا ولـذٌ يـاتـي به حقَّــق الكشـفـا
وقد قال أهل العلم في قطع رأسه كـأنـه
حــل لا
نــزاع ولا خـُـلفـــا
ولا تَعكسنه فهو لحن بلا امترا أجبني
أخ الآداب دمـت لها كهفا؟
فأجاب بعض شعراء سلا على نحو ما قال محمد بن أحمد الناصري:
أيـا سيـدا حـاز النزاهة
واللطفـا ويـا مـلغـزا أبدى لنا فكـره الظَّـرفـا
أتى لغزك المبدي فصاحتك التي هي العسل الصافي الذي به يُستشفى
تـريد بـه اسما سميت به سـورة وقـد رصـف الرحـمـن آياتهـا رصفـا
وأوحـى إليـه اللـه جـل جلالـه وذاك بـإلهـام كـمـا هـو لا يـخفــى
لـه فضلة فيها الشفاء من الأذى فكم قد شفت جسما به الداء قد حفَّا
ضعيفا يـراه النـاس وهـو
مُسلَّـح إذا حاربتْ يوما سقت نفسها الحتفا
تـراه لنفـع الغـيـر يحبس نفسـه وينحـلنـا
نُـحــلا ويطـرفنـا طـُرفــا
هـو النجل إن صحفته أيها الفتى كذا النخل ثم البخـل أقْبِحْ به وصفا
فـهـذا جــواب مــن أخ متملــق علـى الشعر لا يدري اقصَّـر أم وفـَّى
ولا زلـتَ ملحوظ الجناب معظما وفكرك مـن ضوء المعـارف لا يُطفـى
الرابع: ذو توجه فقهي، نظمه أحمد بن المامون
البلغيثي، مثيرا نازلة السيد الذي زوج بنته من عبده دون أن يعتقه، ثم مات السيد
فانفسخ النكاح بمجرد الموت، كان السيد رجلا أو امرأة. قال:
أيا فقيها به الألغاز قد وضحت لمن يحاولها من غير ما خـلـل
فـمـا امـرؤ هلكـت أُمُّ لـزوجتـه فطلقت زوجه من غير ما
مهل
إلا أن أحدا ممن ألقاه عليهم لم يهتد لحله، ففكه هو بنفسه إذ قال:
ها ذاك عبد غـدا زوجا لبنت فتـا ة هـي سـيــدة لـذلـك الـرجـــل
حتـى إذا هلكـت مولاتـه مـلكـت بنت لها زوجها بالإرث عن عجل
وليس
في الشرع ملك الزوج زوجته كذلك العكـس في حكم وفي عـلـل
إن التناقض في الإنفـاق أوجب أن
يدعى إلى المنع في فـرع وفـي أصــل
الخامس: ذو طابع قرآني - وأمثلته كثيرة – يبرز مدى
الأواصر التي تربط بين علماء الأقاليم الجنوبية المغربية وإخوانهم علماء الشمال.
وفيه قال عبد الله العلوي المعروف بابن رازﮔـة مخاطبا علماء فاس وابن زكرى خاصة، ملغزا بأبيات في قوله تعالى من سورة
يوسف متحدثا عن سرقة السقاية أو صواع الملك والبحث عن سارقه:
(فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه)
لماذا لم يقل من وعائه ؟ من هذه الأبيات قوله:
أسـائـلـكم مـا سـرُّ إظهـار
ربنــا
تبارك مجدا من وعاء أخيـه
فلم يأت
عنه منـه أو مـن وعائـه لأمـر دقيـق جـلّ ثم يخيـه
فإن
تـَكُ أسـرارُ الـمعـاني خفيـةً فمـرآتهـا أفكــار كـل نبيـه
وأنـت
ابـن زكـري نَبيـهٌ محقـق تفردتَ في الدنيا بغير شبيـه
إذا غُصتَ في بحث حصلت بدره وخليـت عن سفسائه ورَدِيهِ
من الذين أجابوا عنه محمد بن سعيد اليدالي الديماني بقصيدة منها:
فلـو قال فرضا ربنا من وعائـه فـذا لـكـمُ بعـد التفـكـر فيـه
يؤدي إلى عـود الضمير ليوسف فيفســد معنـاه لـمختبــريــه
لأن الضمير فـي الصناعة عائد لأقـربِ مـذكـورٍ هنــاك يليه
وإن قال منه اختل أيضا لأنــه يــؤدي لعـود مضمـر لأخيــه
فتنزع منه الصاع لا من وعائــه وتأنف من ذا نفسُ كلِّ نزيـه
لما في انتـزاعٍ من أذىً ومهـانـة ولــم يُـردِ الرحـمن ذا بنَبيـهِ
على أن هذا النمط من التعبير لم يكن عند المغاربة مقتصرا
على الشعر المعرب، بل تعداه إلى الشعر الشعبي، إذ عرف "الملحون"
نوعا من الألغاز أطلق عليها "السولان" أي السؤال ؛ وهي غالبا ما
تساق في نطاق تحدي المدعين وهجاء الخصوم. وقد اشتهر فيها شعراء أشياخ كمحمد بن علي
ولد ارْزين والمدني التركماني، على حد قول الأول يسأل خصمه عن ماهية علم الشعر
والمواهب وأقسامه وكيفية تسربها للنفوس. وهي أسئلة لا يعتبر شاعرا من يجهل الإجابة
عنها، إذ من حاول الغوص في بحر الهوى يجده صعبا، إلا من ألهمه الله ومنحه الموهبة.
وهو في عرضه لسؤاله يوصي راوي سؤاله ألا يخشى خصمه الجاهل، لعجزه عن الإتيان بمثل
سؤاله أو شعره:
وانسال امن ادعاو
اعلى علم الشعر ولمواهب
واعلى اشمن اسبيل
يدخل لجسام
كان لهم فالخلق
ارسام
قسموه الفهام
اقسام
من لا يدريها لا
يقول شاعر فالقول ايجيب
واللي داخل بحر
لهوا ابجهلو يلقاه اصعيب
الا من ودُّو
ربنا الوهاب
واللي ادعا اعليك
ابجهلو بالك تستهابو
ما جاب عوض
سولاني
الوا يعيش ما عاش
المرو ولا يجيب لوزان
وتدخل في هذا التعبير الشعبي كذلك الأحجيات التي تعرف
بـ"لمحاجيات" و"الحجايات". وهي وإن كانت في
معظمها عبارة عن جملة أو جمل نثرية، فإن بعضها جاء شعرا أو نثرا موزوناً قائما على
السجع. ومن ذلك قولهم في "الدلاح" الذي هو البطيخ الأحمر:
قبتنـا
خضــرا مبنــيــا بالقــــــدرا
سكانها
اعبيـد وامفاتحها من لحديد
وقولهم كذلك في شهر رمضان:
حاجيتك اعلى
اطبيقنا انقي ما ياكل فيه لا سلطان ولا
افقي
وبعد،
فإن ابتهاجي كبير
بالتقديم لهذه المجموعة من الألغاز التي ضمنها الأخ الكريم الأستاذ السعيد بنفرحي
هذا "الموجز". وإني إذ أهنئه مقدرا جهده وشاكرا له إياه، أرجو أن
يضيف إليه في طبعة أخرى إن شاء الله ما يكمله، دراسة ونصوصا، ليصير
"مبسوطا" كما يؤمل، مع دعائي له بمزيد التوفيق والسداد.
الرباط في 6 ذي
القعدة 1418هـ/ الموافق 5 مارس 1998م
أحمد بن أبي القاسم
شيـخ زاويـة الصـومعـة
ومعه زوايا المنطقة
للأستاذ مصطفى عربوش
مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء
طبعة 1419هـ - 1998م
![]()

بسم الله الرحمن الرحيم
قبل نحوٍ من عشر سنوات، نشر الأستاذ الباحث السيد مصطفى
عربوش سِفراً جليلاً عن إقليم تادلة وبني ملال، عُني فيه بوصف طبيعته وما يُميزه
من ملامح حضرية، في إبرازٍ للجانبين التاريخي والاجتماعي. ثم لم يلبث أن أصدر
كتاباً ثانياً عن أعلام هذا الإقليم، فتَتَبَّعَهُم مُعرفاً بحياتهم وأعمالهم،
ومرتباً إياهم حسب المكان والزمان.
وكنتُ قد سعدت يومئذٍ بتقديم هذا العمل العلمي الجيد، مُنوهاً به وبقيمته
ومقدراً جهد صاحبه وما بذل فيه بحثاً وتنقيباً، وتحليلاً وتحريراً، ثم طبعاً
وإخراجاً ؛ إذ جاء لِيسُدَّ فراغاً هائلاً كانت تعانيه المكتبة المغربية في هذا
المجال المرتبط بالتراث المحلي الذي ما فتِئتُ أدعو إلى ضرورة بعثه والنهوض به،
لأهميته والحاجة الماسة إليه في التعرف إلى حقيقة التراث المغربي في إطاره الشمولي
والمتكامل.
وإيماناً بهذه الرسالة العلمية والوطنية، وسعياً إلى أَدائِها على نحوٍ جاد
ونافع، تابع الأستاذ مصطفى عربوش عنايته بهذه المنطقة، فسجل رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا أنجزها بإشرافي، هي هاته التي أُقدم اليوم بابتهاجٍ وافرٍ وسعادة
غامرة ؛ وقد خص بها أحمد بن أبي القاسم الصومعي، شيخَ زاوية الصومعة. وهو من
الشخصيات البارزة في إقليم بني ملال، وصاحب الضريح المقام بربوة أسردون الجميلة.
بِاسْمِه يُعرف المكان وإليه يُنسب.
فقد تصدَّى الباحث بما لديه من معرفة بتاريخ الإقليم، ومن خبرة بوثائقه
ومصادره، للكشف عن حقيقة هذا العَلَم، بَدْءاً من أصله ونشأته ومختلف علاقاته، إلى
ثقافته وإنتاجه، وما كان له من شيوخ وتلاميذ ؛ مع التمهيد لذلك بالحديث عن زوايا
المنطقة، قبل الوقوف عند زاوية الصومعة وما اشتهرت به ومَن كانوا إليها منتسبين.
ولعل من أهم ما يميز هذه الدراسة أنها قدمت الكثير من المعلومات والبيانات
الجديدة، وأبرزت جوانب غير قليلة كانت غامضة، وصحَّحت كذلك بعض ما كان شائعاً
ومتداولاً على غير حقيقته.
وهي بهذا وغيره تُعد إضافة غنية للتراث الجهوي على الخصوص، والتراث المغربي
والعربي الإسلامي على العموم، سيفيد منها الدارسون المهتمون بالزوايا وما نهضت به
من أدوار سياسية وثقافية واجتماعية، إلى جانب دورها الديني القائم على توعية
المواطنين وتوجيههم، وكذا تعبئتهم وتأطيرهم. كما سيُفيد منها عمومُ القراء، وكذا
السكانُ المتطلعون إلى معرفة ما تزخر به جهتهم من معالم وآثار، مما يُفضي إلى
إحساسٍ بالذات الخاصة، هو بالتلقائية قائدٌ إلى الشعور بالذات العامة التي هي
الكيان والهوية. وما أحوج المغاربة جميعاً إلى ما يَبُث في نفوسهم ذاك الإحساس
وهذا الشعور، حتى يستطيعوا، ليس فقط الاعتزاز بشخصيتهم والتمسك بقيمها والثبات على
مقوماتها، ولكن حتى يَقْدِروا كذلك على الصمود للتحديات التي تواجههم، داخلية
وخارجية.
وهذه كلها أهداف مباشرةٌ وغيرُ مباشرة تَحثُّ على سَوْق الثناء عاطراً
طَيِّباً للأستاذ الأخ السيد مصطفى عربوش، وإزْجاءِ التهنئة له خالصة صادقة ؛ مع
أملٍ كبير أن يُواصل البحث في هذا المضمار الذي غدا فيه المرجع المعتمَد، ودعاءٍ
إلى العَليِِّ القدير أن يجعل التوفيق والسَّداد حليفيه على الدوام.
الرباط 14 ذي القعدة 1418هـ
الموافق 13 مـارس 1998م
![]()
![]()
ديوان
الشيخ أحمد الهيبة
جمع وتحقيق
الدكتور محمد الظريف
طبع دار المعارف الجديدة
1998
![]()
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل متتبع لحال الثقافة في الأقاليم المغربية
الجنوبية، بدءا من سوس إلى أعماق الصحراء، لا يلبث أن يلاحظ طغيان التعبير المنظوم
عليها في تدوين العلوم والفنون وتلقين المعارف وتداولها، باعتبار ما لهذا التعبير
في الألسنة والأقلام من طواعية تتيحها القدرة التلقائية عليه، ويحكمها مراس بمتن
اللغة العربية وديوان شعرها، حتى لكأنهما جماع هذه الثقافة وقوامها، مهما تكن
قطوفها متنوعة وأفانينها متفرعة.
ولا بدع وظاهرة النظم السليقي متجلية على هذا النحو
اللافت للنظر، أن يكون للإبداع الشعري فيها مكان بارز وموقع متميز ؛ لا سيما حين
تتوافر لهذا الإبداع طاقات شعورية أساسها صدق الإحساس وصفاء الذهن ونقاء الفضاء
الواسع المحيط، وكذا حين تتسنى له قدرات ذاتية تتحفز من هذه الطاقات للإعراب عنها
وصوغها تعبيرا شعريا جميلا ورصينا توقعه أوتار القلوب، في تجاوب يكاد يسبق شروط
إيقاع العروض ومقتضيات ميزانه، مما يجعلني على اقتناع دائم برأي كنت أبديته لتلخيص
هذه الظاهرة، وهي أن أهلنا في الأقاليم الجنوبية يقولون الشعر كما يتنفسون الهواء.
وإذا كانت لهذا الشعر ملامح وخصوصيات، بعضها يشترك معه
فيه غيره، وبعضها يتفرد هو به، فإن في طليعة ما يميزه أنه كان – وما زال – أداة
للالتحام الوطني وتأكيد الوحدة الترابية. آية ذلك ما سجلته صحائف التاريخ على
امتداد حقبه، مما صدر عن العلماء والأدباء الذين توسلوا بالقصيدة أو المقطوعة، أو
حتى بالبيت والبيتين، لترسيخ أواصر التواصل وتثبيت روابط هويتهم المغربية المتينة.
وإن مثل هذا النوع من التعبير ليتجلى في إبداع الشعراء،
مواكبا كل العهود وما عرفت من ظروف وأحداث كان اشتداد الأزمات يقوي سياقها الجهادي
الوحدوي، مما تكشف عنه النصوص التي جادت بها قرائح العلماء والأدباء الذين أنجبتهم
الصحراء، والمغرب بقيادة ملوك الدولة العلوية الشريفة يواجه مناوشات الاستعمار
ويتحدى خطره ويجتاز محنته.
وقد أدرك شعر الوحدة ألقه في ظل مبدع المسيرة الخضراء
مولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، إذ استلهم الشعراء من
سياسته الحكيمة الرشيدة ومواقفه البطولية العديدة ما أعطى لهذا الشعر – على وفرة
مادته – سمات متميزة تبرزها القصائد العديدة التي يبدعها هؤلاء الشعراء، مهما تكن
انتماآتهم الإقليمية أو القبلية أو الجيلية، والتي يتشكل منها في كل مناسبة دينية
أو وطنية ديوان أو مجموعة دواوين يمكن اعتبارها وثائق إثبات للتشبث بوحدة الوطن،
إن كان مثل هذا التشبث يحتاج إلى إثبات.
وعلى تشعب الانتساب القبلي في الأقاليم الجنوبية، وتعدد
أسماء الأعلام الذين أنجبتهم هذه الأقاليم، وتنوع وسائل إثبات التوجه الوحدوي عبر
التواصل الثقافي، وإن تفاوت مستوى هذا التواصل ومعه تفاوت التعبير الشعري، فإن
الأسرة المعينية تبقى في الطليعة متميزة بمكانتها في لم الشمل، والقيام بحركة
علمية كان منطلقها من مدينة السمارة وزاوية الشيخ ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل
اللذين كان لهما – ولا سيما للابن – مقام احترام وتقدير بين السكان ؛ كما كانت
لهما حظوة كبير لدى السلطة الشرعية المتمثلة في المخزن، على نحو ما تثبت نصوص
المراسلات والبيعات والمدائح وما إليها من وثائق، وكذا ما تؤكده المواقف الجهادية
التي ووجه بها المد الاستعماري الذي كان يسعى إلى بسط نفوذه على الجنوب المغربي في
وقت مبكر.
وإذا كان الفضل في بدء هذا النهوض وإطلاقه يعزى إلى
الشيخ ماء العينين، فإن فضل مواصلته وتعزيزه يرجع إلى أبنائه الذين كانوا، بسبب
التربية والنشأة والتكوين، أفـذاذا نوابغ، سواء في الميدان السياسي والحربي، أو
المجال العلمي والأدبي ؛ وعلى رأسهم الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه والشيخ
محمد الأغظف والشيخ حسن والشيخ الوليّ والشيخ محمد الإمام، وغيرهم من الذين كانوا
لهم ولأولادهم بعد – وما زال – دور علمي ووطني بارز. وقد تفرد من بينهم الشيخ أحمد
الهيبة الذي كان مهيئا لخلافة والده، إذ كان ساعده الأيمن والنائب عنه في كثير من
المهمات، وكانت هذه الخلافة تقتضي متابعة النضال الوحدوي ؛ مما جعله انطلاقا من
روحه الصوفي القوي، ومن تجديد البيعة للسلطة الشرعية، يقاوم الاستعمار ويواجه
مناوراته، غير يائس ولا مستسلم، حتى حين تعرض للهزيمة بعد أن تخلى عنه عدد من
أتباعه.
وإذا كان الشيخ الهيبة قد خلف والده في حمل راية الكفاح
الوطني، فإنه كذلك خلفه في الرئاسة العلمية والأدبية التي تبوأها عن جدارة، بما
كان له من تبريز في شتى معارف العصر، تدريسا وتأليفا.
وما كان للشعر أن يغيب في سياق إنتاجه، إذ توسل به في
التعبير عن الواقع الذي كان يعاني شتى ظروفه وملابساته، بدءا من بيئة النشأة
وعلاقته بوالده إلى متعلقات انتسابه الصوفي وسلوكه الوطني، مما أعرب عنه في مدائح
ونصائح توجيهية، دون إغفال الجانب الذاتي الذي برع في قصائده ومقطوعاته الغزلية
الرقيقة التي لا تخلو من شحنات روحية جلّتها عنده رموز عميقة الدلالات، ولغة غنية
بالإيحاءات ؛ مع المحافظة على أصالة التعبير الشعري العربي، إيقاعا ومعجما وصورة.
وهي خصائص يقف عليها كل من ينظر في شعره ويتتبع شتاته المبعثر، في انتظار من يعنى
به ويجمعه ويصنع الديوان منه.
وقد قيض الله لتحقيق هذا العمل الجليل، باحثا متخصصا هو
الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد الظريف الذي يحتل موقعا مرجعيا بالنسبة لموضوع
الصحراء المغربية، تاريخا وفكرا وأدبا. فمنذ سعدت برفقته الحميمية، وأنا أتابع جهوده
المتواصلة في مضمار البحث عن تراث الأقاليم الجنوبية ؛ يتردد على الخزائن العامة
والخاصة، ويشد الرحال إلى أقاصي البلدان، يسأل المهتمين والمعتنين، وينقب عن
الذخائر الدفينة يجمعها وينفض عنها غبار الإهمال، يلم شتاتها ويضم أطرافها، مدونا
ومحققا ودارسا.
وإن ما نشر من بحوث ومقالات، وما شارك به من عروض في بعض
المؤتمرات والندوات لأكبر برهان وأسطع دليل على الجهود العلمية الكبيرة التي
يبذلها للتعريف بهذا التراث في مختلف جوانبه. وإنه ليكفي التنويه بالرسالة التي
سعدت بالإشراف عليه في إنجازها لنيل دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب بجامعة
محمد الخامس والتي تناول فيها "الحياة الأدبية في الزاوية المعينية"،
وكذا التنويه بأطروحة الدكتوراه التي سعدت كذلك بالإشراف عليه فيها بنفس الكلية،
والتي أدارها حول "الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية من بداية
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين". وهو تنويه لا ينسيني ذكر أعمال
أدبية أخرى شارك فيها بمساهمة وافرة متميزة، كديوان "وفاء وولاء" الذي
تشرفت برئاسة لجنة جمعه والتقديم له، ويضم منتخبات شعرية من أقاليم المغرب
الجنوبية ؛ وكانت قد أصدرته كتابة الدولة في الثقافة أوائل مارس الماضي بمناسبة
الذكرى السابعة والثلاثين لعيد العرش المجيد.
في سياق هذه الجهود العلمية
القيمة، يقدم الأستاذ الصديق السيد محمد الظريف هذا الديوان، مجموعا ومحققا ومرتبا
ومدروسا أيضا ؛ إذ لم يكتف بما اعتاده صانعو الدواوين من تقديم النصوص، ولكنه مهد
لذلك بمدخل جعله دراسة وافية للتعريف بالشاعر وتحليل شعره، كما ختم بعدد من
الفهارس التي من شأنها أن تيسر الرجوع إلى هذا الديوان والاستفادة منه.
وإنه لإنجاز أدبي مهم، هو لا شك لبنة تضاف إلى سابقاتها،
مما يلقي مزيدا من الضوء على التراث الذي أبدعه أعلام أقاليمنا الجنوبية، والذي به
تكتمل الرؤية الشمولية لتراثنا المغربي خاصة، والتراث العربي الإسلامي عامة.
فهنيئا للأخ العزيز على هذا الإنجاز، ودعاء صادقا إلى
العلي القدير أن يقويه ويعينه كي يواصل جهوده العلمية النافعة التي آمل أن يلتفت
إليها وإلى أمثالها القائمون على شؤون الثقافة وغيرها من المصالح الوطنية،
فيسارعوا إلى نشرها، خدمة لتاريخ المغرب وفكره وأدبه ووحدة كيانه.
والله من وراء القصد.
الرباط في 29 صفر 1419هـ/الموافق 24 يونيو 1998م
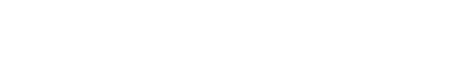
![]()
نبض العشق
للأستاذ عز الدين الإدريسي
1999
![]()

بسم الله الرحمن الرحيم
لا أخفي كم كانت سعادتي كبيرة حين
أخبرني الأستاذ الشاعر السيد عز الدين الإدريسي بأنه بصدد نشر ديوان يضيفه إلى ما
سبق له أن أخرج من مجاميع شعرية. وهو إحساس يغمرني في كل مرة أطلع على إنتاج يصدره
أحد كُتابنا والشعراء، لِما أعرف من شدة المعاناة الأدبية والمادية التي غالباً ما
تكون خلف هذا الإنتاج، والتي لا يجتازونها ويتجاوزونها إلا بما يملأ نفوسهم من
إيمان بالثقافة واقتناع برسالتها والتطلع إلى المساهمة في النهوض بها، على الرغم
من كثرة العوائق وتعدد المثبطات.
وقد زاد شعوري بهذا الإحساس ما أبداه الأخ الكريم من رغبة
ملحة في أن أكتب له تمهيداً يقدم به ديوانه الجديد.
وعلى الرغم من أني لا أرى للشعر – أي شعر – حاجة إلى ما
يُمهَّد به لقراءته، إذ هو بذاته في غِنى عن كل ما يمكن التوسل به من وسائط للوصول
إلى ما يتلقاه، فقد استجبت لهذه الرغبة بتحبير كلمة قصيرة هي إلى الشهادة أقرب
منها إلى التقديم الذي غالباً ما يحاول فيه كاتبه تحديد توجه الشاعر وتوضيح
مفاهيمه واستعراض أدواته، مِمَّا لا يخلو من زعم ودعوى وقع فيهما بعض الشعراء
الممتازين والنقاد المتميزين، وقلَّدهم فيهما حتى الأوساط والرديئون.
وأول ما لفت انتباهي في هذا السفر الشعري الضخم عنوانه
الذي صاغه صاحبه من "نبض العشق". ومن جَسِّي لهذا النبض عَبْر النصوص
المختلفة، تبيَّن لي أن الشاعر عاشق متيم ولْهان، يتجاوز عشقه الإنسان والطبيعة –
وقد أفاض عنهما القول– ليعانق أمكنة وأزمنة بعينها، لها في نفسه تجليات جمالية
شاحنة تحثه على إبداء ما في أعماقه من كوامن نابعة في ذاته الخاصة من سحر تلك
الأمكنة والأزمنة، أو من معاناة الفعل العام المرير الذي مسها وألقى عليها هموماً
تحيد بها عن أن تكون مجرد مناطق عِمارية جامدة أو لحظات وقتية، وصيَّرتها مواقع
شدوٍ وفضاءات غناء يعزف في رحابها وأبهائها ترانيم يمتزج فيها البَهج والحزن،
وينبعث منها التفاؤل واليأس، أو هكذا يحس القارئ وهو يُرجِّع تلك الترانيم، ويحاول
فَكَّ غوامضها وتناقضاتها، وتَمَثُّلَ ما في وجدان الشاعر، واستشراف ما يطمح إليه
من خلال هذا الوجدان وما ينصهر فيه.
إنه نبض ينبعث من بؤرة عشق لا حدَّ لفيضه ولا حصر
لترنحاته، يمد الشاعر بمكونات التجارب والرؤى تتسم بوعي يقود إلى التعبير، ونزوعٍ
لإبداع هذا التعبير، تحفزاً من حِسٍّ فني مرهف رقيق، وتمرسٍ بالقول يتميز بالدقة
والفطرية كذلك.
ثم إني وجدت هذا المجموع يضم نصوصاً لست أدري أهي من
الشعر المنثور، أم من النثر الشعري، أم من نمط لا صلة له بهذا أو ذاك ؛ وإنما يبدو
الشاعر في كتابتها منساقاً وراء الرغبة في التعبير عن النفس، بكل ما تكتنزه من
عوامل دافعة لا تلبث أن تُفضي لتنفيسٍ يستجيب له السمع الذي ينصت ويتأمل ويسعى إلى
استكشاف بالبصيرة، حتى وإن جفاه النظر الذي يمعن التحديق بالبصر.
والسبب أنها نصوص لا تسير على نظام البيت، كما أنها لا
تخضع باستمرارٍ للتفعيلة، وإن اعتمدت نسق السطر أو الشطر غير المحكوم بضوابط مهما
يكن حجمه، سواء أكان ضابط الوزن أم القافية اللذين يتحققان في بعض الأحيان ؛
إِلاَّ ما كان من ضوابط الإحساس المراد الإعراب عنه، وما يستوجب أو يستتبع من نبر
لا يُوقِّعُه أو لا يستطيع توقيعه من لا يتجاوب مع هذا الإحساس ؛ لا سيما إذا كان
هذا النبر يحتوي النص بكامله أو حيِّزاً كبيراً منه ؛ وإن كنت أخشى على هذا
الاتجاه أن يقود الشعر إلى متاهة أو فوضى يكون فيها لكل شاعر قانونه الخاص، أو
هكذا يكون في ظنه، معتقداً أن ذلك من سمات التميز والتفرد.
ومع ذلك، يبقى هذا النبض النابع من عشق الشاعر الإدريسي
مُفعماً بترانيم غنية الدلالات والإيحاءات. وكيف وقد عزفها على أوتارٍ نفسيةٍ
تحاكي ما فيها من مشاعر هادئة تارة ومضطربة أخرى، ولكنها منفعلة على الدوام بما
يحركها من عوامل جمالية، ومنقادة إلى التعبير المنبعث من الإحساس والرافض في غير
قهر أو تعسف لكل نمطية أو اتباع، وإن في محاولته للحفاظ على بناء متماسك أو بنية
متكاملة لا يدركها المتلقي إذا هو لم يندمج مع الشاعر في مكنون أعماقه ومخبإ
خفاياه ليهتدي إلى ما في بواطن تشكيله وخلفياته من أنغام غير مقيدة وتلاحين غير
مقننة، أو هي مقيدة ومقننة بمشاعر نفسه الطليقة وما تبعثه من نبرات تتناغم معها
وتتآلف في تجاوب والتذاذ.
ولَعمري إن الشاعر ليبدو قد جال في رحلات استثمارية
جعلته يواكب مسيرة الشعر المعاصر بكل مكوناتها، ويُغني تجربته هو. وهي تجربة تظهره
شغوفاً بالمنحى الغنائي، مرتبطاً بتوقيعاته وما تؤدي إليه من بث يَتوسل في كشفه
بمختلف الأساليب التي اعتمدها رواد هذه المسيرة ليبلوروا قيماً أصيلة ويحققوا
أبعاداً إنسانية يجددون بها صَوْغ رؤاهم للكون والحياة.
ويخيل إليَّ أن في هذا التوجه يكمن أحد مظاهر
"الحداثة" كما فهمها بعض الشعراء والنقاد، وأكاد أقول
"العولمة" إن صح التعبير بهذا المصطلح الطارئ وأمكن استعماله في مجال
الشعر العربي الذي غدا – أو يُراد له أن يغدو – شبيهاً في شكله وإيقاعه، وحتى في صوره
وصياغتها المنهجية والمعجمية أو الأسلوبية واللغوية، بما في معظم الشعر الذي تنتجه
لغات الدول التي تسعى إلى فرض هيمنتها على غيرها في شتى المجالات ؛ علماً بأن بعض
شعر هذه اللغات لا يخلو من مقاييس شكلية ومعايير بنيوية كان قد استمدها واقتبس أهم
ملامحها الإيقاعية من العروض العربي الزاخر.
وبعد، فإن هذا الديوان الذي
تسعدني الشهادة له، ليضاف إلى دواوين الشاعر الأخرى، ولا سيما منها "حبات
الزهر" ليبرز مدى الطاقة الشعورية والقدرة التعبيرية اللتين اكتسبهما عَبْر
تجارب خصبة في ميدان القراءة وخِضَم الحياة، وما قادت إليه هذه التجارب من إحسـاس
مكثف يتوق إلى الإعراب عنه بشيء غير قليل من العفوية والتلقائية ؛ وإن وجدتُه –
لإطلاق إبداعه أو تقويته وتعزيز رؤاه – يتكئ أحيانا على مقولات غيره، وفق ما يتضح
من التمهيدات المختزلة التي استهل بها كثيراً من قصائده.
فهنيئاً للشاعر الصديق السيد عز الدين الإدريسي هذا
الإصدار الجديد، مع أمل خالص أن يتابع مسيره الإبداعي بالمزيد من التوفيق والسداد.
ومن الله العون والقبول.
الرباط في 9 جمادى
الأولى 1419هـ / الموافق فاتح سبتمبر 1998م
يـا
بـنـي
للأستاذ
أحمد العمارتي
نشر المطبعة الملكية
الرباط - 1419هـ - 1998م
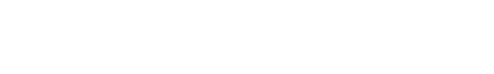

بسم الله الرحمن
الرحيم
للتخاطب بالكتابة أداة معروفة هي الرسائل التي تشكل في الآداب العالميـة
عامة – والأدب العربي خاصة – نمطاً متميزاً بأساليبه ومناهجه وأغراضه، مما يتضمنه
فن الترسل.
وهو فن قديم، ارتبط في نشأته بتبليغ ما جاءت به الديانات السماوية، على يد
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ وفق ما تبرزه الرسالة المشار إليها في
القرآن الكريم مفتتحة بالبسملة، وكان أرسلها سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة
سبأ. ومثلها ما صدر عن بولس في كتاب العهد الجديد الذي يمثل عند النصارى ما كتب من
أسفار بعد المسيح عليه السلام. أما في ظل الدعوة الإسلامية فتذكر رسائل سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم، كالتي وجهها إلى النجاشي أصحمة ملك الحبشة، وكسرى ملك الفرس،
والمقوقس عظيم مصر ؛ ورسائل غيرها بعث بها الخلفاء الراشدون تتعلق بأمور الدين
والدولة.
وكان الشعور بأهمية هذه الرسائل في تدبير الشؤون العامة – داخلية كانت أم
خارجية – هو الدافع إلى تنظيم الكتابة الديوانية منذ أوائل الدولة الأموية، حين
اتخذ معاوية ديواناً للرسائل، إلى جانب ديوان الخراج وديوان الخاتم. وكانت مهمته
تقتضي العناية بمكاتبات الوزراء والعمال والقواد ومن إليهم من المسؤولين ؛ وشهد
تألقاً بما صدر عن عبد الحميد الكاتب.
وقد عرف هذا الديوان تطوراً في عهد العباسيين، على يد الكاتب عمارة بن
حمزة، وبلغ أوجه وبُعده المكتمل في القرن الرابع الهجري، بفضل قلم ابن العميد
وتلميذه أبي القاسم ابن عباد المعروف بالصاحب، وآخرين كأبي إسحاق الصابي وأبي حفص
بن برد ومن جاء بعدهما، قبل الوصول في القرن السادس إلى القاضي الفاضل.
ومما يميز هذا النمط من الرسائل أنها كانت مع توضيح الغرض منها، تعمد إلى
فنية متميزة، بلورها أسلوب بياني يقوم على جمال الديباجة والتحسين البديعي
والتشكيل البلاغي، مع تضمين لأنواع من المعارف وحسن الاستشهاد بالآيات القرآنية
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار العربية، في نطاق ما يتناسب والغرض
ومقام الجهة المرسل إليها الخطاب.
ومن ثم جاءت هذه الرسائل تكتسي قيمة تاريخية عن العصر، وأخرى علمية نظراً
للموضوعات المختلفة التي تناولتها، ثم قيمة أدبية بفضل هذا الأسلوب الفني الجميل
الذي كانت تعلوه سمات الفخامة والجزالة، وإن وقع بعض كتابه في ظاهرة التكلف، على
الرغم من كونهم بلغاء متمرسين.
وإلى جانب هذه الرسائل الرسمية العامة، حبر الكتاب على مر العصور خطابات
خاصة، وصفت جميعها بأنها أدبية. وتضم المناظرات والمفاخرات والمحاورات والإخوانيات
وما إليها مما كان يقصد به إلى أغراض، كالتهنئة والتعزية والتقريظ والإجازة
وغيرها. وهي تنطلق من الذات ورؤيتها وأحاسيسها الخاصة، وتعبر عن مواقف شخصية، مع التزام
جانب من الموضوعية يرتبط بمدى ما تتناوله الرسالة من مضامين تستمد من خارج الذات،
لكن في سياق عاطفي وسبر لأغوار النفس وأحوالها وما ينبعث عنها من فضائل سامية
ومعان داخلية ومشاعر وجدانية يكشف عنها مدى قدرة الكاتب على الوصف الذي يتجاوز به
المرئيات والمحسوسات، يؤديه في تعبير جميل قد يختلف بساطة أو تعقيداً، ولكنه يعتمد
الأسلوب القائم على الصور البيانية.
ويمكن الإشارة من بين كتاب هذا النمط إلى أبي حيان التوحيدي في القرن
الرابع، وأبي العلاء المعري في الخامس والقلقشندي في الثامن. وقد صدرت عن المعري
رسائل صوفية يعرب فيها عن موقفه من الحياة والمجتمع وغيرهما من الأوضاع العامة
للدولة ورجالها وما يكتنفها من حقائق وأخبار.
ولم يخل أي عصر من كتاب اشتهروا بتحرير الرسائل الأدبية، ومن بينهم في
المرحلة الحديثة أدباء، كالمويلحي وناصف اليازجي، وغيرهما من الذين طوّعوا قلمهم
لهذا التحرير.
وربما لوحظ على بعض أشكال هذه الرسائل الأدبية ما كان أصحابه يتناولون فيه
مشاعر إنسانية يحللونها بأسلوب يكاد أن يكون تجريدياً يبعدها عن أن تكون مرتبطة
بذات معينة، أو بجانب موضوعي صرف ؛ وكأنهم يفعلون ذلك لإبراز مهاراتهم في هذا
التناول، أو لمجرد التمرّس والتمرن، إن لم يكن بهدف التسلية والاستمتاع.
ويقترب من الرسائل الإخوانية ما كان يكتب للنصح والتوجيه، مما يدخل في نطاق
الوصايا، وفق ما أورد القرآن الكريم على لسان لقمان في مخاطبة ابنه وهو يعظه. ومن
هذا النوع وصايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدين، على نحو ما
كتب سيدنا علي كرم الله وجهه لابنه الحسن يقدم له توجيهات وحكما سلوكية. ومثلها
رسالة الحسن البصري للخليفة عمر بن عبد العزيز، ووصية هارون الرشيد لمعلم ولده
الأمين. وهو ما امتد حتى المرحلة الحديثة على يد بعض الكتاب، كأحمد أمين في كتابه إلى
ولده.
*** *** ***
وقد كان لكتاب الأندلس والمغرب نصيب وافر في تحبير فن
الرسائل بشقيها العام والخاص، إذ برزت من بينهم على مدى العصور أسماء، كأبي عامر
بن شهيد بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، وهو صاحب رسائل نِزَالية توسل بها
في مواجهة خصومه ؛ وكمعاصره ابن حزم الذي اشتهرت رسائله مع أصدقائه وغيرهم، وما
كتب عن العلوم مما يكمل النظر إلى فكره وفلسفته الاجتماعية، وينم عن شخصية علمية
عارفة بأصول الثقافة الإسلامية خبيرة بأحوال النفس الإنسانية. ومثله في هذا القرن
ابن زيدون الذي ذاع صيت رسالتيه الجدية والهزلية، والقاضي عياض، والفتح بن خاقان،
وابن أبي الخصال في العصر المرابطي ؛ ثم أبو جعفر ابن عطية، وأخوه أبو عقيل، وأبو
الحسن بن عياش، ومن إليهم من الذين كتبوا للموحدين. وبعدهم يشار إلى أبي المطرف
ابن عميرة الذي انتهت إليه رئاسة الكتابة بين القرنين السادس والسابع، واشتهرت
رسائله الديوانية والإخوانية وما كتبه لقضاء حوائج الناس. كما يشار إلى ابن سعيد
المغربي في هذا القـرن، وقد ذاعت الوصية التي وجهها لابنه إذ عزم على السفر ؛ ثم
إلى لسان الدين ابن الخطيب في الثامن، من خلال رسائله العامة والخاصة؛ فعبد العزيز
الفشتالي ومحمد بن علي الوجدي في عهد المنصور السعدي بين العاشر والحادي عشر.
وإذا كان هؤلاء الكتاب وأضرابهم قد طوروا النثر وأغنوا مجالات القول فيه
بأسلوب محكم بليغ تداخله عناصر التفنن، من سجع وبديع، مع الإشارات المعرفية
الظاهرة والخفية، فإن غيرهم من الذين حرروا رسائل على امتداد القرنين السابع
والثامن، كانوا غير محتفلين بهذا الأسلوب، كابن العريف وابن عربي وابن سبعين إلى
ابن عباد الرندي. واتسمت رسائلهم بتوجُّهها الصوفي، إذ تكشف واقع هذا التوجه
وأحوال الروح، في استبطان للنفس الإنسانية ومعانيها الخفية.
وسيعرف المغرب في أواخر القرن العاشر وما بعده كتابا كأبي بكر الدلائي،
وأبي علي اليوسي، وأبي سالم العياشي، وأحمد بن عبد القادر التستاوي، ومحمد ابن
ناصر الدرعي، وغيرهم الذين تناولوا جوانب صوفية واجتماعية، وأخرى ذاتية ؛ مع تميز
لليوسي الذي كانت رسائله – إلى جانب روحها الصوفي – مفعمة بمسائل دينية مقتبسة من
علمي التوحيد والفقه، كان القصد منها إلى التوعية والتوجيه، إضافة إلى ما تتعرض له
من أحوال المجتمع ومصالح الأمة والعلاقة مع السلطان ومن إليه، في إظهار لدور
العلماء ومسؤوليتهم في محاربة البدع والضلالات.
وقد جاءت رسائل هذه المرحلة مختلفة من حيث طولها والقصر، مع الميل إلى عدم
الإطالة، في أسلوب يكاد أن يكون سهلاً بسيطاً لا تكلف فيه ولا تعقيد. وربما كانت
الغاية التعليمية والتوجيهية منها تحث على هذا النمط من الأسلوب.
وإنه لمن حسن الحظ أن حفظ من هذا النوع من الإبداع المغربي المتمثل في
الرسائل، تراث ضخم ضمته دواوين مجموعة نشر بعضها ؛ كما ضمته كتب التاريخ ومدونات
السياسة وغيرها، مما يدل على أن الكتابة في هذا الفن مستمرة منذ الرسالة التي خاطب
بها المولى ادريس المغاربة أول قدومه سنة اثنتين وسبعين ومائة للهجرة، إلى الرسائل
والوصايا التي صدرت عن ملوك الدولة العلوية الشريفة، موجهة إلى أبنائهم أو إلى
الشعب المغربي أو الأمة الإسلامية جمعاء، مما تكفي فيه الإشارة إلى الرسائل التي
بعثها المولى اسماعيل إلى ولده وخليفته بتافيلالت وسائر الأقاليم الصحراوية الأمير
مولاي المامون، والإشارة كذلك إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك المغفور له محمد
الخامس إلى فلذة كبده وولي عهده يومئذ صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني أعزه الله،
بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لمولده يوم تاسع يوليوز سنة ست وخمسين وتسعمائة
وألف، وكذا إلى خطابه قدس الله روحه للشعب المغربي حين التنصيب الرسمي لجلالته في
ولاية العهد يوم تاسع يوليوز عام سبعة وخمسين. أما الرسائل المبعوثة إلى الأمة
الإسلامية، فتأتي على رأسها رسالة مولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني
نصره الله، بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر، سيراً على التقليد المتعارف عليه مع
أجداده الغر الميامين. وهي محررة بفاس يوم الأحد فاتح محرم عام واحد وأربعمائة
وألف الموافق تاسع نونبر سنة ثمانين وتسعمائة وألف.
وعلى الرغم من العناية الفائقة بإبداع هذا النوع من الكتابة في جانبيها
العام والخاص، وعلى الرغم كذلك من أن قسطاً كبيراً من هذا التراث حفظ من الضياع،
فإن غير قليل مما كان متداولا من مراسلات ذاتية لم يكتب له أن يصان، إما لضنِّ
أهله به أو استهانتهم بأهميته، وإما لعوامل أخرى ظل بسببها في أدراج النسيان. ولست
أشك في أن مادة هذه المراسلات غزيرة، إذ أغناها معظم العلماء والأدباء على امتداد
الحقب والعصور. وإني – على سبيل المثال – لأعتز شخصياً بالرسائل التي تبادلتها مع
والدي رحمة الله عليه، وكذا مع إخوتي طوال السنوات العشر التي استغرقها مقامي خارج
الوطن بين الخمسين والستين، إضافة إلى ما لي من مكاتبات مع زوجتي وأولادي، ومع
أعلام من المشرق والمغرب. ولعل الله تعالي أن يوفق لإخراجها – كلها أو بعضها – في
وقت قريب.
*** *** ***
وعلى كثرة ما أنتج المغاربة في هذا المضمار وما اكتسبوا من مراس في كتابته
بتفرد وتميز، فإنه يبدو أن وسائل الاتصال الميسرة اليوم – بدءاً من الهاتف إلى
البريد الآلي فجميع ما أتاحته ثورة التقنيات المعاصرة – جعلت الناس يستغنون في
الغالب عن كتابة الرسائل، مستبدلين بها تلك الوسائل التي ألغت المسافات مهما تكن
متباعدة، وجعلتهم يلتقون سمعا ورؤية بسرعة فائقة ليس معها أي انتظار. وهو الأسلوب
الذي أخذت تعتمده الأسر في الاتصال بأولادها حين يكونون في بلاد الغرب. وقلما يقع
اللجوء إلى كتابة الرسائل التقليدية، إن لم يكن ذلك قد انتهى أو كاد.
من هنا، لا أخفي إعجابي بهذه المجموعة المنتخبة من الرسائل التي أطلعني
عليها الأخ الكريم الأستاذ السيد أحمد حسن العمارتي، وكان بعثها إلى ولده الشاب
النجيب السيد حسن الذي يتابع دراسته العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتضم
خمسة عشر خطاباً يرافقه في أولها منذ اللحظة التي امتطى فيها متن الطائرة، ليذكره
بالهدف الذي من أجله يتغرب، وبالمقومات التي عليه أن يستند إليها ويستعين بها،
بدءاً من البيت وما نال فيه من تربية، إلى المعارف التي حصلها، والخصـال التي نشأ
عليها ؛ قصده أن يبث فيه قوة العزيمة لمواجهة شتى المواقف، ويقوي فيه رغبة تحقيق
حلمه ؛ دون إغفال رباطه بوالديه وحبهما العفوي ونصائحهما الصادقة ودعائهما الدائم
له.
ويتابع معه أولى خطواته بعد وصوله بأسبوع. وهي مدة قصيرة، إلا أنها طالت بالنسبة
للوالدين. لذا فهو لا يترك هذه الملاحظة، من غير أن يشير إلى الحياة وما تقتضي من
جد وحزم للتغلب على متاعبها، وعدم الانسياق لمداعباتها الخلابة، وما ينبغي
استحضاره في بلاد الغربة من ضرورة السعي إلى بلوغ الغاية من الهجرة طلباً للعلم
والمعرفة ؛ مما يجعل الوالد يقدم نصائح هي وليدة تجربته، مركزاً فيها على اختيار
الصديق والرفيق والتعامل بعفو وتسامح.
وانطلاقا من اعتبار الخطاب رسول محبة وباقة عطر فواح بجميل المشاعر، فإن
الوالد يبثه حديثاً عن ألم الأسرة لبُعد فلذة الكبد وفراقه، وأثر سفره وما ترك من
فراغ يعانيه جميع أفرادها الذين لا يحثهم على الصبر سوى الأمل في لقاء قريب. وهو
أمل مقرون إلى التطلع بما سيكون عليه الابن البار من سمو في الفهم، وبُعد في
النظر، واستقامة في الرأي، وشفافية في الفكر، ونضج في معالجة القضايا المختلفة ؛
هذه القضايا التي ينتهز الوالد فرصة الرسالة لتذكيره بما اعتاده من محاورات حولها،
ولتنبيهه إلى ما يتطلب الحوار من قبول الاختلاف مع الآخر.
إلا أن مثل هذه الإثارة لا تجعل الأب ينسى الإعراب عن حالته النفسية، وهو
يكتب له، أياماً قليلةً بعد رحيله ؛ كما لا ينسى أن يقدم تصوره عن عظمة البلد الذي
انتقل إليه ومظاهر هذه العظمة ومقوماتها المؤسسة على الحرية. وحتى لا ينحرف مفهومه
لهذه الحرية، فهو يسترجع معه المثل العليا التي تربى عليها، في إلحاح على حسن
السلوك، بدءاً من الصدق وما جاءت به الفضائل الإسلامية في هذا المجال.
في بحبوحة هذه الأحاسيس، لا يلبث الوالد يعرب عن متعة الكتابة إلى ولده،
وقد غمرته لحظة سكون ينصت فيها إلى نبض قلبه، ويستشف لواعج وجدانه، فيتحدث عن
أحوال النفس والحاجة إلى إعطائها حقها من الهدوء والراحة لتجدد نشاطها، ولتحافظ
على التوازن الذي هو سر الحياة السوية. وهو موضوع يقود إلى التحذير من الانقياد
لملذات هذه الحياة، إذ في هذا الانقياد انصراف عن الغايات السامية والأهداف
الشريفة التي بها يحقق الإنسان لنفسه حاجتها من السعادة، في وسطية يقف الخطاب
عندها باعتبارها في منظور الإسلام جماع الخير كله.
وإن حرص الأب الحنون والمربي على هذه القيم يجعله لا يمل من تذكير الولد
البار بها، حتى عبر مكالمة هاتفية يؤكدها الوالد كتابة، حاثاً على التأمل والبحث
والملاحظة وإعمال الخيال الذي هو عنده النافذة التي يطل منها العقل والذهن
لاستشراف العوالم الغريبة.
ولم يكن غريباً في هذا السياق أن يقيم الأستاذ أحمد العمارتي مقارنة بين
الوطن وبلاد الغربة، ومدى ميل النفس إلى هذا أو ذاك، لا سيما وأن الابن الشاب قد
يؤخذ بما في العالم الجديد من شتى ألوان الحضارة ومعالم التقدم والرقي. ومن ثم فهو
يدعوه إلى أن يظل مرتبطا بوطنه وأسرته، أي بهويته التي يريدها أن تكون حاضرة في
وجدانه وفكره باستمرار.
وتتاح الفرصة للوالد أن يسافر إلى حيث هاجر ولده، في ركب رحلة ملكية موفقة،
إلا أن ظروفا تحول دون لقائه، مما يدعوه إلى الحديث عن مفاجآت الحياة وما قد
يعتريها من خلل، في نطاق أقدار إلهية ينتهز مناسبة ذكرها للإشارة إلى مدى حرية
الإنسان واختياره لأفعاله. وإن هذه المسائل وأشباهها لتجعل الوالد يعود أكثر من
مرة للكتابة حول الحياة باعتبارها مدرسة كبيرة تتلقى فيها علوم ومعارف لا تتعلم في
أية مؤسسة، هدفه وهو يستعرض لقطات من حياته هو، أن يفتح عين الولد على حقيقة هذه
الحياة كي يستفيد منها على نحو إيجابي صحيح.
وتتسنَّى المناسبة بعد العودة من هذه المرحلة لإعادة التذكير بتجارب الحياة
الغنية، سواء بالنسبة للأفراد أو الدول والشعوب، إذ يتقدم قوم ويتخلف آخرون. ومن
هنا يفتح المجال للتحدث عن واقع المغرب الحضاري، وما كان عليه في السابق، وما يشهد
اليوم من نهضة شاملة.
وقد جرَّه هذا الموضوع إلى محاورة الولد في موضوع سبق له أن تناوله مع
زملائه ورفاقه الطلبة، ويتعلق بالتوكل والتواكل ؛ مما يتخذه الوالد سبباً للحديث
عن الإسلام عقيدة ومنهجاً وسلوكا. والتركيز على هذا السلوك يجعل الأب يناقش مع
ابنه الصديق موضوع الحياء، باعتباره صفة حميدة وخصلة سامية تختزل جملة من المعاني
الكبيرة والقيم الأصيلة التي بها تعلو النفس وتتدرج في مراقي الكمال.
ولأهمية هذا الجانب، فإن الوالد يشرك ولده في مناقشة دارت مع أخته حول
أهمية المال ودوره في الحياة، ومدى الحاجة إليه بالقياس إلى غيره من الموارد
كالماء وما إليه، إذ هو مجرد وسيلة لا غاية في حد ذاته. وهي فرصة أخرى سانحة
لإثارة الرؤية الإسلامية إلى هذه الموارد.
وتطول الغيبة ومعها يكبر الشوق وتنمو القضايا الكبرى التي تتناولها
الرسائل، لتصل إلى مسألة أساسية تتمحور حول الثقافة، وكانت تشغل الابن وهو في أول
أيام رحلته الدراسية، كما أنها تحرك فضول الأب الذي يكتب عن منابع هذه الثقافـة،
متمثلة – إلى جانب المؤسسات التعليمية – في أدوات أخرى من بينها الكتاب والمسرح
والإذاعة والتلفزة والوسائل العصرية التي جاءت بها ثورة الاتصال، على ما فيها من
سلبيات ينبغي أخذ الحذر منها والاحتياط.
*** *** ***
إن إعجابي بهذه الرسائل التي حررها الصديق العزيز الأستاذ أحمد حسن
العمارتي ليقترن بالتقدير الكبير للطابع المتميز الذي جاءت عليه، والذي جعلها تمزج
بين جانب معرفي عام، وجانب ذاتي خاص ؛ بل لعله من خلال الذات كان ينظر إلى القضايا
التي يناقشها، مما أعطى للمجموعة سمة تكاد أن تكون بها شبه سيرة ذاتية للكاتب، بما
تعرضت له من حالات نفسية وهواجس فكرية. وهي إذ تنم عن فكر ناضج خصيب وتأمل مرن
عميق، تكشف عن رؤية صافية وأحاسيس صادقة. ولا شك أن التقاء هذين العنصرين يفضي
تلقائيا إلى الإقناع بالمقومات يثبت عليها، وبالهوية يرسخها، من خلال وصايا عفوية
وتوجيهات تلقائية يبثها مباشرة وغير مباشرة، لا تلبث أن تنفذ إلى العقل والقلب في
غير تردد ولا استئذان ؛ ولعمري إن هذا لا يتأتى لغير المربين الخبراء بنفسية
الأجيال الناشئة، العارفين بكيفية التعامل.
وقد أحسست بالأخ العمارتي يسير مع سجيته وهو يصوغ هذه الرسائل، بدون عنت
ولا تكلف، فينقاد له القلم ليسطر ما يجيش به وجدانه ويعتمل به فكره، في سلاسة
تعبير وجمالية خطاب، حتى لكأن أسلوبها من السهل الممتنع الذي لا يستقيم لغير
الكتاب المبرزين، مع قدرة على التصوير واستعمال التشبيه والتمثيل، والاقتباس من
القرآن الكريم، والاعتماد على آراء فلسفية ونفسية واجتماعية وسياسية دالة على نفس
عميق وتحليل دقيق، مع التوسل بنصوص بعض الأدباء للاستشهاد. وهو يخضع الرسالة بعد
هذا لتخطيط منهجي يتجلى ليس فقط في عرض المضمون، ولكن حتى في الهيكل والشكل، بدءاً
من البسملة والتحميد والتصلية أو الدعاء والتحية والتسليم وتأكيد رضا الوالدين،
وختماً بالدعاء وتجديد صيغ الرضا وعبارات الأمل المتوهج. وهو في ذلك كله يلجأ إلى
الخطـاب المباشر الذي يعتمد فيه كاف الخطـاب والنـداء "ولدي" أو
"يا بني".
وإضافة إلى سائر المزايا التي تفردت بها هذه المجموعة، فإنها مفتاح لشخصية
كاتبها وربما شخصية ولده كذلك. وهي نموذج متميز في مجال المراسلة، على الآباء
والأبناء أن يقتدوا به ويستفيدوا منه كيفية التعامل التربوي وأسلوب مواجهة الغربة،
وطريقة تكوين الشخصية وبناء الهوية. وهي غايات أصبحت اليوم متعسرة على الأسرة وحتى
على المدرسة والمجتمع.
فليهنأ أخي وصديقي الأستاذ أحمد حسن العمارتي أن وفقه الله للسير في هذا
المسعى النبيل، آخذاً بيد نجله البار السيد حسن وهو يعاني غربةً هجيراه فيها
متابعة تعليمه وبناء كيانه ؛ مع الرجاء الصادق للوالد بالمزيد من التوفيق لمتابعة
هذا السعي، والدعاء الخالص لابنه بالنجاح والصلاح.
الرباط في 27 صفر 1419هـ
الموافق 22 يونيو 1998م
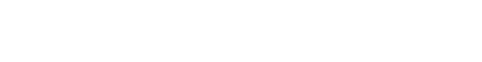

جامعة سيدي محمد بن عبد الله الإذاعة والتلفزة المغربية
كلية الآداب
والعلوم الإنسانية إذاعة فــاس
ظهر المهراز – فـاس
الصحراء المغربية
في البحوث الجامعية
للدكتور علي الغزيوي
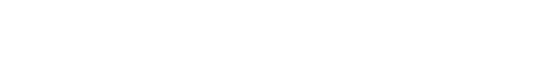

بسم الله الرحمن الرحيم
يتفرد المغرب بمميزات اجتمعت فيه قلَّما تسنى التئامها في غيره، لعل في
طليعتها موقعه على رأس قارة عظيمة، ومجاورته القريبة لأخرى، وإطلاله على بحرين
لُجيين، وتنوع طبيعة أرضه ما بين سهول خصيبة وجبال شامخة وأودية سائلة وسواحل
ممتدة وصحارى شاسعة ؛ مما أعطى لهذه الطبيعة تكاملاً وتوازناً تكونت بهما بيئة
متناغمة عبْر حواضرها وبواديها انتسجت وحدة التراب وتمَّ التحام الوطن.
انطلاقا من هذا الواقع البيئي وما أنتج من أوضاع اقتصادية ونظم اجتماعية
وأنماط سلوكية واحتكاكات خارجية، وما ترتب على تفاعل ذلك كله من ذهنية تمثلت في
ملامح محددة وسِمات معينة، تشكلت حضارة المغرب وثقافته، في توجه وحْدوي كان دائماً
يغتني بروافد تنوعت بتنوع ظواهر هذا الواقع ومظاهره.
ومن ثم كان إبداع تلك الحضارة والثقافة نابعاً من إمكانات محلية، ومرتبطاً
بقدرات جهوية، ليصب عند نهاية المطاف في البوتقة الوطنية بكل ما تحتضنه من أبعاد
وتحتويه من آفاق، في غير تمركُز ضيق قد يُفضي إلى التقلص والتقوقع، ولكن في انفتاح
من شأنه أن يؤدي إلى انصهار الأجزاء في الكل واندماج الفروع في الأصل.
ولهذا، كان البحث عن حضارة المغرب وثقافته لمعرفة حقيقية وكاملة بهما يقتضي
اعتماد ما ظهرت به في سياقهما المراكز الحضرية الكبرى، واعتبار ما أُنتج على مستوى
سائر الجهات، والوقوف على ما يتميز به هذا الإنتاج من خصوصيات، وما يتضمنه بذلك من
إضافات هي التي – حين يُضم بعضها إلى بعض – تقود إلى تحقيق تلك المعرفة، فتتبلور
بها الهُوية الوطنية على أساس من مقومات ثابتة ومكونات راسخة.
*** *** ***
في نطاق هذه المعطيات وتحفزاً منها، كانت الدراسات المغربية، على اختلاف
مناحيها ومنذ تأسيسها في الجامعة المغربية، تتوخى إدراك تلك المعرفة الشمولية
باعتبارها هدفاً بعيداً لا إمكان لبلوغه والتوسل إليه غير البدء بالتعرف إلى
الفرعيات والجزئيات.
وهذا ما جعل الدرس والبحث معاً – ولا سيما في العلوم الإنسانية – ينصبان
على الظواهر والقضايا، وعلى النصوص والأعلام، وما إلى ذلك مما يكشف النبوغ المغربي
في شتى ملامحه، وعلى النحو الذي يبرز مدى مساهمة جميع المناطق والأقاليم في تمثيله
وتجسيمه. وكان للصحراء من هذا الاهتمام نصيب وافر جلاَّه الحيز الفسيح الذي خصص
لها في المقررات الدراسية، وكذا في البحوث التي ينجزها الأساتذة والطلاب.
وسيْراً مع هذا التوجه وما رافقه ووافقه من منهج، كنت منذ المرحلة المبكرة
للجامعة، أسعى في تدريس مادة الأدب المغربي إلى فتح نوافذ على مختلف جوانب
المساهمات الإبداعية والفكرية التي ظهر بها أبناء الصحراء، وفق ما أبرزت في:
"موشحات مغربية" و"وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ"
و"الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه".
وقد أتيح لي بعض التوسع في الموضوع عبْر الكتابة عن
"ثقافة الصحـراء" و"شعر الصحراء"، مما تسنى به إظهار بعض
عناصر الحق لإثبات مغربية أقاليمنا الجنوبية. وهي عناصر زادت في إبرازها الرسائل
والأطاريح الجامعية التي أنجزها الباحثون المغاربة، والتي سعدت بالإشراف على
بعضها، والتي شهدت وتشهد تقديمها مختلف الجامعات المغربية، مع سبق لجامعة محمد
الخامس بالرباط، وجامعة محمد بن عبد الله بفاس.
*** *** ***
وإن المتأمل في هذه الدراسات لينتهي إلى تأكيد أواصر
الوحدة التي ربطت على امتداد التاريخ بين شمال المغرب وجنوبه. وإذا كانت هذه
الأواصر تظهر في مجالات متعددة، في طليعتها البيعة التي تقدم في جميع المناسبات
ومختلف الأوقات عبْر شتى المظاهر الرسمية والشعبية، في مواكبة لها دائمة من مواقف
الجهاد للدفاع عن الشرعية والوحدة، فإنها في المجال الثقافي تبرز واضحة من خلال
التواصل الذي لم ينقطع قط، والذي جلَّاه الأعلام الصحراويون وهم يصرحون في أسمائهم
بالانتساب إلى المغرب، إضافة إلى وحدة توجههم العقدي ومذهبهم الفقهي وطريقتهم
الصوفية، وإلى اعتمادهم في برامجهم التعليمية على متون مغربية، وكذا عنايتهم بشرح
هذه المتون.
وقد تقوى هذا التواصل بالزيارات التي كانت تقوم بها الوفود على أصعدة
ومستويات مختلفة، وبإقامة عدد من العلماء والأدباء الصحراويين في المدن الشمالية،
وما كان لبعضهم من اتصال مستمر بملوك المغرب وأمرائه، وما صدر عن شعرائهم من مدائح
قدموها إليهم ؛ كما قدموها إلى أقطاب الزوايا التي كانوا إليها ينتسبون.
وزاد في تمتين هذه الأواصر الثقافية ما كان يتاح لهم من فرص لطبع مؤلفاتهم،
وما كان يتبادل بينهم وبين أقرانهم في الأقاليم الشمالية من رسائل وإجازات وفتاوى
وألغاز ومساجلات، وما إليها من أنماط النثر وفنون القريض ؛ جاءت كلها دالة على
ثقافة أصيلة ومتواصلة، مع إلحاح في التعبير الشعري على استحضار النموذج القديم
وتمثله، في عملية إحيائية شكلت عند شعراء الجنوب مدرسة أبانت عن مدى قدراتهم
الإبداعية وما كان لهم من سبق للتوسل بهذا النموذج في مواجهة آثار التدهور الذي مس
هذا التعبير طوال العهود المتأخرة.
*** *** ***
في هذا السياق المثبت للوحدة والمؤكد لها، وعلى هذا النحو العلمي الموثق،
تم إنجاز تلك البحوث الجامعية القيمة التي لو تيسر طبعها ونشرها والتعريف بها على
أوسع نطاق، لكانت أفصح لسان ناطق بالحق وأسطع برهان دال عليه. ولكن الأسف شديد أن
معظمها، إن لم أقل كلها، ظلت حبيسة رفوف مكاتب أصحابها وخزائن الكليات التي قدمت
فيها، تشكو النبذ والإهمال والنسيان، في وقت يفتعل الخصوم ألواناً من الأباطيل
والأكاذيب، يتوسلون بها لتزييف الحقائق والوقائع، أملاً في تمرير ادعاآتهم وجعلها
مقبولة لدا المحافل الإقليمية والدولية.
من هنا تأتي أهمية هذا السفر الجليل الذي ألفه الأخ الكريم الأستاذ البحاثة
الدكتور علي لغزيوي، يلقي فيه أضواء كاشفة على هذه الدراسات، وإن في غير استقصاء
لها، قصده أن ينبه إلى قيمتها، ويلفت النظر إلى ما يبذله الدارسون المغاربة من
جهود تجاه قضية الوطن المصيرية.
والكتاب في أصله مجموع أحاديث إذاعية كان المؤلف يلقيها على أمواج إذاعة
فاس وكانت تُتلقى باستحسان كبير وتخلف أصداء طيبة واسعة، إذ كانت نافذة مفتوحة على
ما يجري "في رحاب الجامعة" ؛ وهو عنوان البرنامج الأثيري الذي قدمت هذه
الأحاديث في نطاقه عام ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف. وحسناً فعل حين لمَّ شتاتها
بين دفتي هذا المصنف، ضاماً بعضها إلى بعض ؛ مما جعلها وثيقة متناسقة ومتكاملة،
ليس فقط من خلال البحوث التي قدمتها والحوارات التي أجريت مع أصحابها، ولكن كذلك
بما أضفاه عليها الأستاذ الفاضل الدكتور علي لغزيوي بحسن الاختيار وجودة التنسيق
وإحكام التبويب ودقة الترتيب، وبما أضافه إليها من مدخل عام ومقدمات مهد بها لتقريب تلك البحوث إلى عموم القراء.
وقد جاءت كلها غنية بالمعلومات الدالة على حس دقيق بالتاريخ، ووعي عميق
بالواقع المتحرك، وإدراك مستنير لمختلف القضايا المثارة ؛ كما جاءت من حيث صياغتها
مكتوبة بأسلوب جميل يطبعه الوضوح والتلقائية. وهو عندي مثال يحتذى في النمط
الإذاعي الذي لا شك يتميز بخصوصيات تمرس بها الأستاذ الدكتور علي لغزيوي، حتى غدت
تنبع فياضة من قلمه البارع السيال وهو يحبر عروضه، وتتفتق على لسانه المعرِب
الفصيح وهو يلقيها سلسة جزلة.
فهنيئاً للصديق العزيز هذا المصنف النفيس، ودعاء لأُخوته بالمزيد مما أخذ
على نفسه القيام به وما يتطلع إليه قراءه ومستمعوه بتوق وشوق.
وبالله التوفيق والسداد.
الرباط 25 ذي القعدة 1419هـ /الموافـق 14 مارس 1999م

![]()
في بـلاغـة
القصيدة
المغربية
للدكتور مصطفى الشليح
الطبعة الأولى 1999
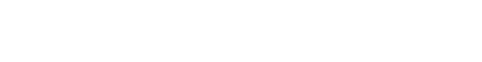
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
لعل أي معتن بدرس الأدب العربي، لا يلبث حين ينظر فيما كتب حول هذا الأدب،
أن ينتهي إلى أن جزءاً كبيراً من الاهتمام به ينصب على الشعر، وعلى البحث عن مدى
إبداعية ما يصدر فيه من إنتاج غزير ؛ مع ما يطبع هذا الإنتاج من توجه نحو القصيدة
المعاصرة، سواء في شكلها أو المضمون.
وتكاد الملاحظة نفسها أن تنطبق على الدراسات التي ينجزها الباحثون المغاربة،
في اعتنائهم بالقصيدة المغربية، لا سيما على الصعيد الجامعي بمختلف مستوياته ؛ في
تركيز على الظاهرة الشعرية من حيث هي ؛ بغض النظر عن طبيعتها – نوعاً ودرجة - إذ
الساحة ما زالت قابلة لتعايش النمطين: الموروث والجديد، في تنافس جلي تارة وخفي
أخرى، لإبراز التفوق واعتلاء مكانة الصدارة ؛ مع ما يتبلور عبر ذلك من مواقف
يتخذها الشعراء والنقاد، وحتى الدارسون الأكاديميون.
ومن باب الإنصاف لجملة الرسائل والأطاريح التي قدمت في رحاب الجامعات
المغربية – وقد كان لي شرف توجيه الكثير منها – أن يعترف بأهميتها في تحقيق معظم
الأهداف الآنية والمستقبلية المتوخاة منها، مع شيء من التفاوت لا مجال لإنكاره يصل
ببعض تلك الدراسات إلى حد التفرد والتميز.
وما إخالني أتردد في الإدلاء بهاتين السمتين العاليتين، شهادة في حق
الأطروحة التي يضمها هذا السفر الجليل، والتي تناول فيها الأستاذ الدكتور مصطفى
الشليح موضوعاً ما كان له أن يغوص في أعماقه ويتغلب على صعوباته، لولا ما توافر له
من قدرات الباحث المدقق المتمكن من أدوات معرفية وذوقية، مزج فيها الموضوعية بشيء
من ذاته، مثلما مزج الإحصاء والتتبع بالقراءة الحوارية التي لم تخل من تأويل. وقد
سبق له أن جلى الكثير من هذه الأدوات في مقالاته النقديـة، وفي رسالته التي نال
بها – تحت إشرافي كذلك – درجة دبلوم الدراسات العليا في موضوع "الحياة
الأدبية في سلا" ؛ وإنما جاءت هذه الأطروحة لتبلورها على نحو أكثر ظهوراً
ووضوحاً.
فقد نظر الدارس إلى شعرية الخطاب في القصيدة المغربية على امتداد العقود
الثلاثة التي حددها ؛ وتأملها وتشربها، ثم فحصها وتمحصها برؤية تناسقت أبعادها
التصورية المنهجية، وتكاملت مادتها النصية والنقدية، في ملاءمة بين قوانين الشعرية
العربية وغيرها من الشعريات، وبين معطيات النص المدروس، المتخير بسعة وشمولية، وفي
توفيق بين مكونات شتى لتلك الشعرية، على تعدد محدداتها، وكثرة وسائل إدراكها،
وتباين طرق تحليلها ؛ بدءاً من الإيقاع في مختلف مستوياته، إلى اللغة في تنامي
معجمها وتناسله، فالصورة فيما هو معتاد منها أو ما هو متخيل مبتكر ؛ دون إغفال
الأثر البيئي في ذلك، وكذا أثر التواصل مع الموروث الذي ظل حاضراً باستمرار، ومع
الإنتاج المعاصر المنقول من بقية الأقطار.
ووفْق ذلك كله، تسنى للباحث – على طريقته – أن يثبت للقصيدة المغربية
شعريتها وشخصيتها كذلك، مع التداخل بين أجيال المبدعين، وحضور دائم لعنصر المعاصرة
والالتحام مع الثقافة في توترها المؤثر تلقائياً في التعبير.
وهي استنتاجات تؤيد رأيي في الشعر الذي أبدعه المغاربة، ليس فقط في المرحلة
المدروسة، ولكن أيضاً في غيرها من المراحل. وهي كذلك تعزز ما انتهى إليه الدارسون
السابقون فيما تصدوا له من بحوث مست فترات ونصوصاً أخرى، وتضيف الكثير إليه.
ولا أخفي أني منذ اللحظة الأولى التي انطلقت منها هذه الأطروحة، أي منذ عرض
عليَّ الباحث مشروعها، كنت على شبه يقين، إن لم أقل على يقين تام، من أنه سيصل بها
وبموضوعها الشائك إلى خلاصات علمية إيجابية من شأنها أن تقوي الدرس المغربي للأدب،
وأن تفضي بذلك إلى شيء من الاطمئنان على القصيدة التي أبدعها شعراؤنا في مختلف
العهود، لا سيما في هذه الفترة التي حددها البحث، والتي شهدت مخاضاً وطنياً كانت
له تجليات عديدة، سياسية وثقافية وأدبية.
فما عرفت السيد مصطفى الشليح إلا قارئاً فاحصاً وناقداً ممحصاً، وصاحب رأي
شجاع يبديه باقتناع وإقناع ؛ إضافة إلى مرهف حسه ورقيق شاعريته. وهي ملامح كانت
بادية عليه، منذ كان يختلف إلى فصول الدراسة بكلية الآداب في الرباط، ثم لم تلبث
أن نمت بفعل مواصلة الاجتهاد والتكوين الجاد، حتى غدت له مميزات تطبع فكره وتحدد
شخصيته.
فليهنأ الصديق العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى الشليح بهذه الدراسة القيمة
التي لا شك أنها ستكون ضمن المراجع الأساسية للشعر المغربي الحديث والمعاصر، إن لم
تكن في طليعتها. وليكن إصدارها حافزاً له إلى مواصلة النشر بطبع رسالته الأولى،
وكذا طبع دواوينه الشعرية التي ستزيد في إبراز ما يتميز به إبداعه في النمطين، بعد
أن شرع في ذلك بإخراج ديوانه الأول "عابر المرايا".
وبالله التوفيق والسداد.
الرباط فاتح محرم 1419هـ
18
أبـريـل 1999م
مقاربة دراسية لرحلات
عبد الله الجراري
1934- 1956
للدكتور عبد المجيد بنجيلالي
مطبعة بني يزناسن
منشورات النادي الجراري – 21 –
1421هـ - 2001م
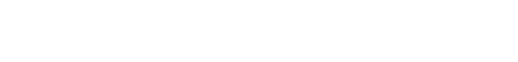
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
من بين الأنماط الكتابية التي عرفها الأدب العربي في
المغرب، يتميز فن الرحلة بخصوصيات تمس مضامينه وأشكاله وأساليبه، على نحو مكتمل
ناضج تجليه أسماء غدت معالم يشار بها وإليها عند التأريخ لهذا الفن، أو حتى مجرد
التحدث عنه ؛ سواء على الصعيد العربي الإسلامي، أو على المستوى العالمي، من أمثال
ابن بطوطة والعبدري وابن رشيد والعياشي والناصري، ومن إليهم من الذين أنتجوا رحلات
أرسوا بها للكتابة في هذا النمط من التعبير تقاليد ترسخت على امتداد العصور.
وإذا كانت هذه الرحلات قد تنوعت حسب وجهتها والدافع
إليها، ما بين حجازية وسفارية وعلمية وسياحية وغيرها، فإن ما ألف منها في سياق
أداء فريضة الحج وما كان يقتضيه الطريق إلى البقاع المقدسة من مراحل، يكاد يشكل
أعلى نسبة. والسبب كامن في الشوق الدائم إلى تحقيق هذه الأمنية، واغتنام بعد
المسافة للتوقف في أقطار غالباً ما كان المغاربة يودون المرور بها ومشاهدتها، إما
للزيارة والتبرك كالقدس الشريف، أو للإطلاع والارتواء العلمي كبلاد الكنانة ؛ مع
كل ما يصاحب هذه الغاية أو تلك من ذكر للمواقع والآثار، ووصف لأوضاع الثقافة،
وتعريف بالعلماء والأدباء وما يكون معهم من لقاء وتبادل الأخذ والعطاء ؛ ومع كل ما
ينبثق عنها كذلك من أحوال النفس، معاناة ومقاساة، أو ارتياحاً واطمئنانا.
وعلى الرغم من أن الحديث عن فن الرحلة غالباً ما ينصرف
إلى ما دُون فيه متصلاً بالخارج، للسبب المشار إليه، فإن ما كتب فيه مرتبطاً
بالداخل لا يقل أهمية، إن لم تكن جدواه أكثر، لما يقدمه من مادة غنية قد لا يعثر
عليها أو على معظمها في غيره.
وقد وقع إقبال كبير على تحرير الرحلات الداخلية في
المرحلة الحديثة، لا سيما بدءاً من هذا القرن وعلى مدى نصفه الأول، وفق ما تثبت
النصوص التي ما زالت في بعضها مخطوطة في خزائن عامة أو حبيسة مكتبات أصحابها لم تر
النور بعد. وتكفي الإشارة منها إلى ما كتب أحمد الكردودي وأحمد سكيرج وعبد الرحمن
بن زيدان والمختار السوسي ومربيه ربه ومحمد بن عبد الله الغلاوي وعبد الله الجراري
الذي يمثل إنتاجه نسبة عالية من بين الرحلات الحديثة، إذ ألف ثمان رحلات على مدى
الفترة الممتدة من 1934 إلى 1956 ؛ وهي حسب تأريخ تأليفها كالآتي، وإن كانت آخرتها زمناً
تخص سفراً إلى القطر الليبي الشقيق:
1 – عشرة أيام في مراكش
2 – نزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس
(أو: نتيجة الاقتباس ...)
3 – قرة العيون من سبعة أيام في مكناسة الزيتون وجارتها زرهون
4 – الرحلة السطاتية (أو السكيرجية)
5 – جولة في وجدة
6 – الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية
7 – رحلتي الصيفية
8 – ملخص الرحلة الليبية (أو : موجز الرحلة الليبية)
وهي زاخرة جميعها بالمعطيات الفكرية والأدبية المرتبطة
بالبيئة المشاهدة وتاريخها، والنابعة من الواقع الذي كانت عليه يومئذ، ومن كان
يشغله من شخصيات بارزة في ميادين العلم والتعليم والوطنية وغيرها مما كان يلفت نظر
الكاتب وهو يلتقط بدقة ويدون، في انفعال بما يرى وتجاوب مع من يلقى، وفي حرص على
توجيه ذلك كله وتكييفه مع ما يعتمل في أعماقه من مشاعر جهادية وأحاسيس نضالية هي
وليدة رأيه الثابت وموقفه الصامد وسعيه الحثيث للم شتات الذات حتى تستطيع النهـوض
وتقدر على المقاومة.
ونظراً للأهمية التي لهذه الرحلات، فإن الوالد كثيراً ما
كان يفكر في نشرها مجموعة أو مفردة، لولا أن الأجل وافاه ونقله إلى جوار ربه. ولا
أخفي أني عقدت العزم مراراً بعد وفاته رحمه الله على طبعها في إطار مشروع
"منشورات النادي الجراري"، ولكني كنت أتريث، معتبراً أن الحاجة ماسة إلى
إصدارها محققة، نظراً لما يملأها من أعلام وإشارات مختلفة قد يصعب على القارئ
إدراكها إن لم توضح له على نحو علمي صحيح.
وقد ظل الأمر كذلك أملاً يراود، إلى أن قيض الله لإنجازه
الباحث المتمكن الأستاذ عبد المجيد بن الجيلالي الذي ما كاد يحرز دبلوم الدراسات
العليا حتى أبدى تعلقاً بنصوص تلك الرحلات، في افتتان بها وإعجاب دفعاه إلى
اختيارها موضوعاً لأطروحة الدكتوراه.
وما كان لي أن أتردد في قبول الإشراف عليه في تهييئها،
وقد خبرته من قبل في مرحلة "تكوين المكونين"، ثم وهو يحضر رسالته التي
نال بها درجة دبلوم الدراسات العليا، والتي أدارها حول "القضايا الفكرية
والأدبية واللغوية في الأدب المغربي الحديث من خلال المقالة بدءاً من 1912 إلى حدود 1930"، وكنت أشعر بسعادة وأنا أشرف على إنجازها ؛ لما يتحلى به من رغبة في
التحصيل، وإدراك للذة العلم، وقدرة على بذل الجهد الذي يتطلبه البحث في أناة وصبر
وتطلع إلى المزيد، مع تواضع جم وتمسك بالقيم الثقافية والسلوكية اللازمة.
بهذا وغيره مما يتمتع به من مواهب ومؤهلات، تسنى له أن
يحقق تلك النصوص، ويجتاز الصعوبات التي تثيرها، دون ملل ولا كلال، وبتوفيق وسداد
حالفاه في كل ما تصدى له. ولم يكتف بذلك، ولكنه زاد فوضع دراسة مقاربة كانت وحدها
كافية لمنحه الشهادة المرجوة.
وحتى لا يتضخم العمل ويأخذ أبعاداً تتعدى ما هو مطلوب في
هذه المرحلة الجامعية، فقد ارتأى ألا يضم إلى هذه المقاربة إلا نصين اثنين، هما:
1 – عشرة أيام في مراكش
2 – الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس
العلمية
ونظراً لأن العمل، سواء في إطاره الكامل الذي هيأه
الباحث، أو على الشكل الذي قدمه في الأطروحة، يتسم بشيء غير قليل من الاتساع في
المادة، من حيث النوع والحجم، فقد أخضعه لمشروع مجزأ، يستهله بنشر المقاربة ؛ وهي
التي يتضمنها هذا الكتاب القيم الذي أسعد بتقديمه، على أن يتبعه إن شاء الله بأسفار
يفردها لمتن الرحلات. وإنه لمشروع جليل يستحق عليه الصديق العزيز الأستاذ الدكتور
عبد المجيد بن الجيلالي أخلص عبارات التنويه والتقدير، مشفوعة بأصدق الدعاء له
بالمزيد من الإنتاج في هذا المجال من التخصص، بعد أن شق طريقه الوعر وانقاد له ما
صعب من مسالكه.
وبالله العون والتوفيق.
الرباط في 5 صفر 1420هـ
الموافـق 20 مايو 1999م
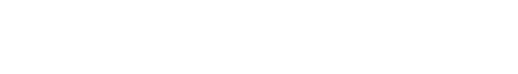

مختارات من الشعر العربي
في القرن العشرين
منتخبات الشعـر المغـربي في
القـرن العشرين(1)
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين
للإبداع الشعري
الجزء 4
الكويت - 2001م
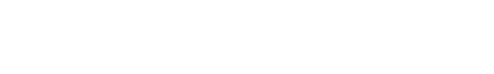
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
يتبين لكل متتبع لمسيرة الشعر العربي في المغرب، أن هذه
المسيرة عرفت مراحل متداخلة ومتفاوتة كان فيها الإبداع يتأرجح من حيث مستواه
وقيمته، سواء بالنسبة إلى ذاته أو بالقياس إلى غيره. وكان في ذلك متأثراً بعوامل
كثيرة كان من بينها العنصر الفاعل في أحداث التاريخ، وما له عادة من انعكاس على
مختلف البنيات، ولا سيما على الثقافة والفكر والأدب، وما يكون فيها جميعاً من
إنتاج يبرز مدى القدرة على العطاء الجيد والمتميز.
وإذا كانت النشأة في مرحلة الأسلمة والتعريب الأولى، على
امتداد نحو ثلاثة قرون، قد اتسمت بفتور في التعبير الشعري وصل إلى حد الضعف
والرداءة، فإن الاستواء لم يلبث أن اكتمل لهذا التعبير في شيء غير قليل من
الازدهار والتألق، متأثراً باستقرار الدولة ووحدتها وما كان لها من تفاعل عميق
ووثيق مع المشرق والأندلس، تحفزاً من شخصية قوية بما كان لها من نفوذ واعتبار، ليس
على صعيد المنطقة فحسب، ولكن على صعيد مجموع الأقطار العربية والإسلامية كذلك.
وما كادت دولة الوحدة الكبرى تميل إلى التقلص والانعزال،
بدءاً من منتصف القرن السابع الهجري الموافق للثالث عشر الميلادي، حتى دخل المغرب
في عزلة زاد في تضييق نطاقها عليه موقفه من التحديات الخارجية التي كان يواجهها،
والتي فرض على نفسه – لرفعها، أو تأجيل وقوع خطرها – أن يغلق دونه الأبواب
والنوافذ، حماية لاستقلاله، ورداً للعدوان المتلاحق الذي كان يهدف إلى مس هذا
الاستقلال.
وتحت تأثير هذه الظروف التي لم تكن تخلو من مخاضات
عسيرة، بدا الشعر بدوره منكمشاً على الذات، ومحصوراً في دائرة ضيقة يجتر نفسه،
بإعادة وتكرار لم يفرزا غير نصوص باهتة في أشكالها ومضامينها، مرتبطة بالنماذج
القديمة المتداولة، تسعى إلى محاكاتها وتقليدها، وإن لم يخل بعضها من ملامح
إبداعيـة رائعـة. ولكنها – لقلتها – لم تبوئ الشعر العربي مكانة الصدارة التي
احتلتها قصيدة "الملحون" الشعبية التي شهدت على امتداد هذه الفترة
مقومات تطورية ظهرت في قوالبها الهيكلية، ومعانيها المتجددة، وفي الصدى الواسع
الذي كان لها لدى المتلقين.
وقد كان لحادث الاستعمار والوقائع التي مهدت له أثر
إنذاري تجلى في بث وعي جديد حث على النهوض ومراجعة الذات في علاقاتها مع نفسها ومع
الآخر، مما أفضى إلى محاولات لتصحيح كثير من البنيات الداخلية، ولا سيما في مجال
الفكر، بما يكونه وما ينتج عنه. وبهذا دخل المغرب مع بداية القرن العشرين طوراً
مبشراً بانبعاث كانت خلفه أسباب، من بينها – إلى جانب إرسال البعثات ودخول المطبعة
مما كان عرفه في السابق ولكن دون جدوى -:
1 – المقاومة المسلحة ضد
الاستعمار، وما صاحبها من روح دفاعية عالية.
2 – انتشار الفكر السلفي الإصلاحي، سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى
العلماء والأدباء، مما تكشفه الكتابات الشعرية والنثرية.
3 – ظهور الحركة الوطنية العاملة في حقل السياسة، وما كان
لها من دور إيجابي كبير في بث الوعي بالمغرب وهويته، إضافة إلى دورها في النضال من
أجل تحرير البلاد.
4 – العناية بالتعليم في توجهه العربي الإسلامي، عكس ما
كانت
ترمي إليه إدارة الاستعمار.
5 – ازدهار الصحافة الوطنية، مما يتمثل في الجرائد والمجلات
التي كانت إلى جانب مقالاتها السياسية، تخصص حيزاً بارزاً للكتابات التي تهتم
بتاريخ المغرب وفكره وأدبه، مع عناية خاصة بالشعر.
لقد كان طبيعياً، والمغرب يقبل على مرحلة صعبة يواجه
تحدياتها بيقظة وبمقومات ثقافية جديدة، أن ينفتح على عهد يتسم، في الإبداع الأدبي
عموماً والشعر منه على الخصوص، ببوادر تطوير وتجديد هي التي تعكسها النصوص التي
يسعى هذا المجموع إلى عرض نماذج لها تمثل مختلف الأجيال التي تعاقبت على التعبير
طوال القرن العشرين، مع ما لها من ملامح الالتقاء والافتراق، بدءاً من الرعيل
الأول الذي ظل يواكب القديم، إلى الفئة التي أظهرت الثورة على هذا القديم، مروراً
بالذين كانوا يحاولون السير بتؤدة واتزان والتوفيق بين مختلف الاتجاهات.
وكانوا جميعاً – كل في توجهه وتأثراً باقتناعه – ينطلقون
من مفاهيم للشعر تبدأ من امتلاك أدوات التعبير والقدرة عليه، إلى مستوى آخر يجعله
مجالاً لإظهار المهارة الصناعية والبراعة في عرضها، تحفزاً من التكوين العلمي الذي
كان الشعر مجرد عنصر مكمل له ومزين لصاحبه.
وإذا كان هذا المنحى الشعري قد تألق على يد شعراء، هم في
الأصل علماء وفقهاء، فإنه لم يلبث أن ظهر عند فئة أخرى راعت السجية والوجدان، وإن
كانت هذه المراعاة منصبة على محاولة تقديم نظري للمفهوم، وليس على الممارسة
الشعرية نفسها. وهو ما يلاحظ عند شعراء أشادوا بدرر صياغتهم، كما يلاحظ عند آخرين
ألحوا على مخاطبة الوجدان. وكان المدح عند هؤلاء وأولئك مجالاً لإثارة قضية التصنع
أو التعبير عفو الخاطر، في حين كان عند آخرين مناسبة للاعتزاز بالفصيح البليغ
الدال على الفحولة التي لا تكلف فيها، وعلى غنى العواطف وعذوبة التعبير.
وعلى الرغم من بعض الذين كانوا يضيقون بالابتعاد عن
القديم ويناهضون كل محاولة للتطوير، فإن التطلع إلى التجديد كان يقوى يوماً إثر
يوم، تأثراً بظروف النهضة التي بدأت تعطي ثمارها، مع استهلال سنوات الأربعين،
ساعية إلى مواكبة التغيرات التي مست الواقع يومئذ، وأتاحت للفكر والأدب أن ينطلقا
في خط تعميق الإحساس بالذات والوطن، والتعبير عنهما بمضامين مستحدثة، مع الإبقاء
على بعض الأغراض التقليدية وتناولها برؤى وأساليب لا تخلو من جديد.
وهذا ما جعل فئة من الشعراء تربط الإبداع بالواقع
والحقيقة بالقيم، وبما يترك سحره في النفوس، من تحفز لتحريك السواكن والكوامن، والتطلع
إلى المعالي والأمجاد، والحث على استرجاعها والتحرر من الاستعمار قبل ذلك وبعد.
ولم يلبث هذا الاتجاه – وقد قوي تأثره بالحركة الشعرية المتجددة التي عرفها المشرق
– أن فتح لنفسه آفاقاً رومانسية تربط التعبير بما تختلج به الأحاسيس وما يعتمل في
الضمائر من هموم وآمال، وما تهفو إليه الأرواح من حرية وجمال، في غير تخلّ عن
المسؤولية التي يتحملها الشاعر في مجتمعه، مما أبرز ظاهرة الالتزام التي اتخذ
البعض منها موقف الرفض، باعتبارها مجرد قيد يحول دون انطلاق الإبداع، لا سيما وأن
من هؤلاء من أخذ ينادي بتجاوز القيود الشكلية للقصيدة.
وتأثراً بالواقع الذي بدأ المغرب يعيشه بعد استعادة
سيادته، وتجاوباً مع التحولات التي كانت تفرزها الحركة الشعرية في عموم الأقطار
العربية، ظهرت مفاهيم تربط التعبير بالحياة الجديدة وما كانت تتيح للبعض من أحلام،
وما كانت تترك عند آخرين من رغبة في الانتقاد بهدف التغيير. وعند هؤلاء وأولئك
احتدم الصراع، مقابلاً بين المتمسكين بالشكل التقليدي للقصيدة، والداعين إلى
تجاوزه والثورة عليه.
وفي غمرة هذه المخاضات، ومع أواخر القرن، برز تيار شعري
ذو نفس إسلامي قوي ومتماسك يجعل من التعبير مسؤولية نابعة من مكانة سامية يتوحد
فيها المبدع بمعاناة صوفية مع الكون والحياة والإنسان.
وفي مواكبة لمختلف المفاهيم التي عبر بها الشعراء، سار
النقد – وإن بخجل واستحياء – يؤيد تارة ويعارض أخرى، متأثراً في الغالب بثقافة
أصحابه وانتماءاتهم، مما جعله يبدأ نقداً لغوياً وبلاغياً وعروضياً، ليتحول في آخر
المطاف إلى نقد إيديولوجي صرف. وهو ما حال دون ظهور نظرية شعرية تبرز توجهاً أو
توجهات، من خلال نصوص إبداعية متميزة قابلة بعد اكتمالها أن تصبح نماذج تغري
الدارسين النقاد بالكشف عن ملامح تفردها، وتجعل الشعراء يحتذونها، لتتضح بعد ذلك
معالم مدرسة يتوافر لها نسق وخصوصيات.
وإذا جاز أن نختصر مسيرة الشعر العربي في المغرب على مدى
القرن العشرين، فلن تعبر عن هذا الاختصار سوى كلمة واحدة صغيرة لا تخلو من أهمية
قصوى كبيرة بالنسبة إلى المرحلة، ألا وهي "التطور". فقد كان الشعراء من
مختلف مواقعهم وعلى تباين إمكاناتهم يسعون إلى أن يتحقق هذا التطور في مظهر ما من
مظاهره مهما يكن بسيطاً أو ضئيلاً. وكانت المضامين أكثر قابلية له وقبولاً كذلك،
وفق ما تجلّيه الأغراض التي انصبت على الفرد والمجتمع من جهة، وعلى الوطن والأمة
من جهة ثانية.
فانطلاقاً من الوجدان وإليه، كان الشعراء تحت ضغط ظروف
الاستعمار، لا يجدون أنفسهم إلا عندما يخلون إليها للكشف عما يكتنفها من عواطف
وأحاسيس قد تكون بهيجة تارة وحزينة أخرى، لا سيما حين تصدر في حال السجن أو النفي
وما يفضيان إليه من شعور بالغربة والوحدة والشوق والحنين. وقد يؤدي هذا الشعور
أحياناً إلى استحضار الطبيعة والتغني بها، في تجسيمها للوطن بكل ما يمثله من روعة
وجمال، وما يوحي به من متعة ونشوة، وكذا بما يبعثه من ألم وحسرة في نفس الشاعر
المتطلع إلى فكه من القيد الذي عاناه تحت وطأة الاستعمار، أو تخليصه من السلبيات
التي رافقت ممارسة الاستقلال.
وستستمر هذه النزعة مصحوبة بتسابيح وابتهالات عند بعض
الذين تأملوا نفوسهم، في تأرجحها بين اليأس والأمل والشقاء والسعادة، فمالوا إلى
الفخر بالذات، أو إلى الانطواء عليها لاجترار ذكريات الماضي والعيش في أحضان حلم
جميل، لا يخرجون منه إلا للتساؤل عن وهم الحياة وسر الوجود، في نفور أحياناً من
الواقع المليء بالتناقضات، وربما في هروب إلى ما يحث على النسيان ويخلص من الهموم
والأحزان. ومع ذلك، فمن بين ثنايا هذا القلق والاضطراب، كان ينبعث روح متفائل
بالكون والحياة، يخفت ويقوى حسب ظروف كل شاعر وأحواله.
وموازاة مع هذا التوجه الفردي، كان الاهتمام بالواقع
الاجتماعي يدعو إلى التجاوب معه والاندماج فيه، وإلى الانشغال بقضاياه والتوعية
بها.
وكان الصراع بين الطرقية والسلفية، أو بين الشيوخ
والشباب، بداية هذا الاهتمام، في سعي إلى بث وعي ديني وطني صحيح خال من الشوائب
التي علقت بالأفكار والأذهان على مدى حقب الركود، والتي انعكست على السلوك متجسمة
في كثير من العادات السيئة المتفشية، وفي الانحراف عن القيم والاستهانة بها.
واقترن هذا التوجه بانتقاد الأوضاع المتأزمة التي عاشها المغرب، سواء وهو يعاني
وطأة الاستعمار وويلات الحربين العالميتين، أو وهو يواجه بعض الظروف السلبية التي
بدأت تظهر في عهد الاستقلال، متجلية في مشكلات اجتماعية نتجت عن سوء التدبير وعمق
الفوارق المعيشية، كظاهرتي التسول والهجرة، مما لفت الأنظار إلى الفلاح في علاقته
بالأرض، وما يواجه فيها من محن الجفاف والفيضان واستغلال الإقطاعيين. وهو وضع أفضى
بعدد من الأطفال والشباب والفتيات إلى التشرد والتسكع والوقوع في براثن التخدير
والإجرام والدعارة.
وكانت العناية بالتعبير الوطني خير مجال للكشف عن الآمال
والتطلعات، وسط ظروف صعبة كان الشاعر فيها داعية البحث عن الذات والمصير المتوقع
لها في غمرة ركام الأحداث المتلاحقة واضطراب الأزمات المتناقضة، وما كانت تبثه
المواقف الجهادية من تفاؤل في النفوس. وكان الالتفاف حول المؤسسات الممثلة للوطن
محور التعبير الذي دار حول العرش المغربي، وحول شخص الملك باعتباره رمز هذا الوطن.
ولم يلبث هذا التعبير أن غدا مجالاً لدعوات الإصلاح
والتحرير، تحفزاً من المناداة بالتعليم، مع تركيز على تعليم الفتيات.
وارتبطت معركة التحرير بالتشبث بالوحدة الوطنية التي كان
الاستعمار يحاول تمزيقها. وكانت مناسبة الاحتفال بعيد العرش فرصة للتعبير عن
المشاعر الوطنية، خاصة وأن عهد الحماية لم يكن يبيح مثل هذا التعبير، بل بلغ به
التضييق إلى حد نفي الملك وأسرته، مما زاد في إذكاء المشاعر وتقوية العزم على
التحرر الذي لم يلبث بعد اندلاع المقاومة أن تحقق بعودة الملك من منفاه يحمل بشرى
هذا التحرر. كما كانت المناسبة بعد استرجاع الاستقلال فرصة للتجاوب مع المنجزات
والإعراب عن التطلعات وإثارة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، مع الإلحاح على قضية استكمال الوحدة الترابية، سواء حين تعلق الأمر
بالصحراء التي استعيدت بالمسيرة الخضراء، أو حين تعلق بمدينتي "سبتة"
و"مليلية" والجزر المجاورة التي ما زالت تحت الاحتلال.
وعلى غرار هذه المناسبة، فإن المناسبات الأخرى – وطنية
ودينية – لم تكن تمر دون أن تنتهز لإذكاء الشعور بالهوية والكيان، والإشادة بالقيم
والمبادئ والبطولات والانتصارات، والإعراب عن الآمال والتطلعات وشتى الانشغالات،
مما يدل على أن التعبير الوطني قد تشعب حتى كاد يمس كل الأغراض.
وما كان هذا التعبير لينغلق على نفسه في دائرة ضيقة
محدودة لا تتجاوز المغرب، ولكن تعداها إلى معانقة القضايا القومية، معرباً عن قوة
الانتماء الحضاري والثقافي إلى الأمة العربية، وتجاوبه مع قضاياها، في اعتزاز
بالروابط اللغوية والتاريخية وما يشدها من أصـول مشتركة، إلى جانب وحدة الهموم
والمشاكل والمصير ؛ دون إغفال عنصر الدين الذي هو في إحساس المغاربة وفكرهم
ولاوعيهم كذلك أساس القومية، إن لم يكن هو هي، مما جعلهم ينظرون إليها ممتزجة
بالإسلام. وهذه لا شك رؤية متطورة بالقياس إلى ما كان معهوداً من قبل أن يُعرف
المفهوم القومي، وهي كذلك متميزة بعدم إلغائها الجانب الديني، إذا ما قورنت بما
كان سائداً في الساحة العربية لفترة طويلة.
وإدراكاً من الشعراء لأهمية التعبير عن هذه الأحاسيس،
لإثبات الأصالة وتأكيد الشخصية العربية الإسلامية، وتثبيت الموقف من الاستعمار
الذي كان يحاول أن يسلبه ملامح هذه الشخصية، فإنهم لم يتركوا أي حدث عربي إسلامي
إلا وتجاوبوا معه، وأعربوا عما يختلج في أعماقهم من صدق الانفعالات ومتانة
الروابط. وهو ما كان يظهر في الفرح باستقبال شخصيات مرموقة، وفي رثاء أعلام
بارزين، وفي مشاركة بلد بهجة نيل استقلاله وفي مساندة جميع قضايا التحرر.
وكانت قضية فلسطين في مختلف مراحلها حافزاً للتعبير
القومي وإغناءاً له، منذ الثورة على وعد بلفور إلى انتفاضة أطفال الحجارة. ومثلها
قضية الجزائر التي ساندها المغاربة بالقول والفعل وعملوا على تحريرها، في تجاوب
مطلق مع الثورة والتحام بها، وكذا قضايا العراق ودول الخليج وما كان لها من أثر في
تعميق الجرح العربي الإسلامي.
وكانت مؤتمرات القمة التي انتظمت على المستوى العربي أو
الإفريقي أو الإسلامي فرصاً أخرى للشعراء المغاربة كي يعربوا عن مواقفهم القومية
وتضامنهم اللامشروط مع قضايا الأمة، في توجه انتقادي أحياناً عند بعض الذين كانوا
يتوقون إلى أن تكون لهذه المؤتمرات جدوى ملموسة وحقيقية.
وإذا كان الشعر العربي في المغرب قد انشغل بهذه المضامين
وأبرزها وجعلها محاور للتعبير، فإنه في هذا التعبير كان يخضع لمقومات القصيدة
باعتبارها بنية متكاملة ومتناسقة تتجاوب مع السياق الشعوري لتجربة المبدع، يتوسل
في تشكليلها بمكونات إيقاعية ولغوية وتصويرية بدونها لا تكون القصيدة بل لا يكون
الشعر.
وقد شغل الإيقاع شعراء المرحلة، بدءاً من الذين ارتبطوا
بالبحور الخليلية في التزام بالإطار التقليدي، إلى الذين حاولوا التحرر منه ومما
اعتبروه رتابة، بكل ما في محاولاتهم من اضطراب لم يفلت منه إلا بعض المتمكنين من
أدوات التعبير، وبما في بعض هذه المحاولات من بعد عن الشعر، لا سيما التي زعمت
إبداع قصيدة نثرية. في حين جرب آخرون أن ينوعوا في التقفية، وأن يقوموا بتشكيلات
شعرية، على نحو ما يلاحظ عند الذين نظموا على نمط التوشيح، أو النشيد الذي ارتبط
بالمناسبات الوطنية، أو غيرهما من الأنماط القائمة على نسق المقاطع.
وباعتبار اللغة هي الوعاء الذي يصب فيه الشعر، ليس من
حيث هي مجرد تراكم لفظي أو كتل حرفية متراصة، فقد أولاها شعراء المرحلة عناية
خاصة، سعياً منهم إلى الخروج بها عن المألوف والمعتاد في الكلام، بخرقها ومحاولة
الصعود بإمكانياتها إلى أعلى درجات التفجير وطبقات الانزياح، بهدف خلق علاقات بين
مكونات هذا الكلام، مما يعطيها سمة الفن وملمح الجمال.
وإذا كانت اللغة عند شعراء العقود الأولى قد اتسمت
بالتزام المنحى التقريري المباشر الذي لا يخلو من نبرة خطابية فخمة، مع الميل
أحياناً إلى الغرابة وحتى إلى التكلف في اصطناع بعض الظواهر اللغوية، فإن شعراء
العقود الأخيرة كانوا يجتهدون في تجنب هذا المنحى، متوسلين بالانزياح اللفظي
وتجاوز المعاني المألوفة، مع اللجوء إلى التضاد والتنافر واستعمال الرموز وما
إليها مما يساعد على تشكيل لغة خاصة.
وكانوا في مثل هذه التجارب يحاولون التوفيق بين اللغة
وأساليبها، والمضامين التي يعالجونها، وكذا الأنماط التي جربوا تطويعها، كالشعر
القصصي والمسرحي. ومن ثم جاءت لغة بعضهم، والشباب منهم على الخصوص، موسومة بالتوتر
والإثارة والإيحاء، مما أفضى إلى الغموض الذي جاء عند المقلدين وغير المجيدين مجرد
أحاج وألغاز قد لا يفهمونها هم أنفسهم.
وعلى النحو الذي سارت فيه اللغة والإيقاع، جاء التصوير
عند شعراء الفترات الأولى من القرن، مرتبطاً بما كان مألوفاً ومتداولاً عند
القدماء، في عناية بالوصف والارتكاز فيه على التشبيه والتوسل بالمجاز والاستعارة.
وقد جاء الوصف عند البارعين فيه بعيداً عن النقل الآلي
الجامد، بما يبعثون في الشيء الموصوف من حركة وتشخيص، وبما يبثون فيه من فكرهم
ورؤاهم، وبما ينتج عن ذلك من ابتكار للصور تتدخل فيه الحالة النفسية المتولدة عن
الانفعال العميق بما يريدون تصويره، مما يجعل المتلقي يتمثل التجربة حية نابضة
تحفزه إلى التجاوب.
وستتطور الصورة عند شعراء المرحلة المتأخرين ولا سيما
منهم الجدد الذين استفادوا من الجماليات البيانية والبديعية التي قننتها البلاغة
العربية، ولكنهم لم يقفوا عندها ولم يكتفوا بها، وسعوا إلى إيجاد محسنات نابعة من
طاقات التفجير وإمكانات التأويل التي لا يوفق المتلقي دائماً في تمثلها، إلا أن
يكون من الذين أدركوا رؤيا الشاعر واندمجوا فيها معه. وهذا ما أفضى إلى استعمال
الرمز، باعتباره أسلوباً يقوم على الإيحاء والتلميح، ويتوسل به المبدع ليغير
طاقاته ويوجه إيحاءاته في مجال الكشف عن الخبايا المجردة، دون أن يقع في عالم
التجريد المطلق، ومن غير أن يصل في استعماله إلى حد التعبير الذاتي المغلق، فضلاً
عن التعسف والافتعال في هذا الاستعمال. وقد طوع شعراء الاتجاه الإسلامي هذا
الأسلوب، متوسلين بألفاظ قرآنية وأسماء ذات دلالات دينية وتاريخية.
وكما اعتمد بعض شعراء المرحلة على الرمز، كذلك اعتمدوا
على الأسطورة، لما تتيحه من تخيل واستحضار أشخاص وصراعات ومواقف تجعلهم يطرحون
واقعاً معيناً يعرضونه أو يحللونه ويفسرونه، بوساطة ما تزخر به الأسطورة من إشارات
فنية متعددة. وكانوا في البحث عن الأسطورة يلجأون إلى التراث الشعبي المحلي تارة،
وإلى التراث الشرقي القديم تارة أخرى، دون إغفال لجوء شعراء آخرين إلى ما يزخر به
القرآن الكريم وكتب التراث الإسلامي من أعلام ومرجعيات دينية وتاريخية، رمزوا بها
عندما رأوا أن التعبير المباشر لا يسعفهم في الإعراب عما يعتمل في نفوسهم من مشاعر
وانفعالات وتأملات وتوترات.
إن مثل هذا الرجوع إلى التراث والامتياح منه في المجال
المشار إليه، يستدعي إثارة قضية أوسع وأشمل حول مدى تأثر شعراء المرحلة التي تنتمي
إليها هذه المختارات بنصوص شعرية أو غيرها مما تفاعلوا معه. وهي قضية في جانبها
النظري لا تفضي إلى نفي الإبداع وتميزه، إذ على الرغم من أن التناص وارد في أنماط
كثيرة من التعبير، والشعري منها على الخصوص، طالما أن المتن الشعري يشكل فضاءً
واحداً متشابهاً على الأقل، مما تستبعد معه القطيعة الكلية أو الانفصال التام، فإن
لتجربة الشاعر وما له من قدرة على الكشف عنها ما يحتم التمايز والتفاوت كذلك.
ولأسباب كثيرة، أبرزها الواقع العام النفسي والفكري،
وثقافة الشعراء وما تولد عنها من منظور ووعي، كان للنص الديني أثر كبير في
إبداعهم، متمثلاً في القرآن الكريم، ثم في الحديث النبوي الشريف، من خلال تضمينات
مباشرة أو استيحاءات لجأوا إليها في أغراض كثيرة، كالمولديات والوطنيات ؛ مع شيء
من التطوير في التوظيف ظهر عبر الارتباط بالقيم الإسلامية والمعاني الإنسانية
السامية، عند الكشف مثلاً عن الواقع المرير الذي يعيشه الإنسان عامة، ويعاني
ويلاته في غيبة المقومات، متخبطاً في التناقض والصراع، غير قادر على أن يهتدي إلى
ما ينجيه أو يخفف عنه.
ويبقى بعد هذا أن التأثر كان واضحاً بالتراث الشعري
العربي، القديم والحديث، سواء بالاقتباس أو المحاذاة أو المعارضة، أو حتى
بالاقتفاء والمحاكاة والنسج على نفس المنوال. والسبب أن هذا التراث يمثل لدى
شعرائنا المرجع والذاكرة، إذ قرأوه وانفعلوا به وتأثروا، إلا أن منهم من سار في
ذلك على نهج التقليد المكشوف، ومنهم من كان أقدر على إخفاء ملامح هذا التقليد.
والمنطلق عند الجميع أن التراث الشعري العربي، بمختلف
محطاته الزمنية، هو من قبيل النبع المشاع الذي لا مالك له بحقوق تحول دون الأخذ
منه، بل قد يتم هذا الأخذ بشيء من الاعتزاز والافتخار بالتتلمذ على كبار مبدعي
العربية في المشرق والأندلس، بما يمثلانه من كيان واسع يرى شعراؤنا أنهم منضوون
تحت لوائه دينياً وفكرياً وشعورياً، وأنهم يشاركون في صنعه وتشكيل خصوصياته
ومميزاته، وأنهم بذلك يخرجون من حدود الإقليمية الضيقة، ويقوون أنفسهم للدفاع عن
الذات وإمدادها بمزيد من القدرة لمواجهة تحديات الغرب.
وانطلاقاً من هذه الأحاسيس، لم يلتفت شعراؤنا إلى
الإنتاج الشعري الأوربي على الرغم من الاحتكاك الكبير الذي كان بأوربا
الاستعمارية، إلا أنه احتكاك لم يغر بالنظر في شعرها الذي كان يعتبر دون مستوى
الشعر العربي من حيث أشكاله ومضامينه. وهذا ما جعل نهضة شعرنا الحديث، سواء في
المشرق أو المغرب، تحاول البعث بالرجوع إلى الشعر العربي القديم وإحياء نماذجه
الجيدة الرائعة، في حين أن نهضة الكتابة النثرية التفتت إلى ما أنتج الغرب من
أنواع وأجناس.
ومع ذلك، فلم يخل شعر المرحلة المؤطرة لهذه النصوص
المختارة من محاولات، بالترجمة أو الاقتباس أو الاستيحاء، دلت على تأثر طفيف
بالشعر الأوربي عند البعض، ولكن من غير أن يكون لها وقع يذكر، فضلاًَ عن أن يكون
لهذا الوقع صدى كبير.
على هذا النحو، كان شعراء المغرب في هذه المرحلة – على
امتدادها قرناً من الزمان – مرتبطين بالتراث العربي، وبحركات التجديد التي ظهرت في
المشرق، مع التدرج في هذا الارتباط، من مجرد محاكاة النماذج القديمة في نطاق نمطية
محصورة في موضوعات محددة وقوالب شكلية، قصارى همهم فيها أن تنقاد لهم اللغة وينضبط
إيقاع الوزن والقافية، إلى اقتحام ميادين جديدة كانوا فيها مشدودين إلى الواقع
وقضاياه، ومتطلعين إلى فتح آفاق مستقبلية باستمرار، يواكبون بها مستجدات المرحلة
وما كانت تثيره من تناقضات.
وقد دفعت بهم هذه المواكبة إلى التوسل بالقصيدة الجديدة
التي طغى التعبير بها عند جيل الشباب، بإجادة مرة، وبمجرد المحاولة التي تفتقر إلى
مقومات الإبداع مرات كثيرة. وما كانت هذه الرغبة التحديثية لتمر دون إثارة مواقف
نزالية بين أنصار الشكل القديم والرافضين له، في غيبة نقد موضوعي قادر على إنارة
الطريق، إلا ما كان من بعض الكتابات المحدودة كما سلف القول، وكذا في غيبة إدراك
حقيقي لطبيعة التطور الذي يجتازه الفكر والأدب وعموم مظاهر الحياة، بالنسبة إلى
مختلف الأقطار العربية، والحاجة في نطاق هذا التطور إلى تعبير متجدد في جوهره قبل
أن يكون متجدداً في شكله. ولعل هذا ما تسعى جميع التجارب لتحقيقه عبر مخاضات مبشرة
في الغالب، وإن لم تثمر بعد ما يمكن أن يعتبر النموذج أو المثال.
وسيلاحظ القارئ لهذه المختارات، أن النصوص التي أنشأها
شعراء ينتمون إلى أجيال شابة، تتميز بسمات يمكن إجمال أبرزها في ما يلي:
1– أنها تعكس تجربة فردية تحاول
معانقة الجماعة، من خلال رؤية ذاتية هي أساس الإبداع بلا شك. وهي رؤية نابعة من معايشة
الواقع السياسي والاجتماعي، والاحتكاك به داخل معادلة يلتقي فيها الحلم بالممارسة
والوعي باللاوعي، وإن كانت هذه المعادلة لا تكشف بوضوح وعلى مستوى كبير علاقة
شعورية تبلغ من الاندماج والانصهار ما تتجاوز به مجرد التعاطف والانتماء.
2–
أنها تدل على مدى التشوف للتعبير بحرية، والاقتناع بهذا
التعبير، وإن بخرق بعض الأنظمة والضوابط، ولا سيما الشكلية منها، وهو منحى يؤدي
عند غير المتمكنين من الأدوات والمتحكمين فيها إلى اضطراب يشوش على الإيقاع الذي
هو أساس الشعر، مهما تكن مكونات هذا الإيقاع.
3– أنها تسير في دهاليز الغموض الذي لا يكون دائماً نابعاً من غور التجربة
وعمق التعبير عنها، بقدر ما يكون دالاً على تعقيد يفتعله الشاعر لإخفاء ضعف تجربته
أو اضطرابها، وانفلات أدوات الكشف عنها، لغة وتصويراً، مما يوقعه في تقليد يفقد
شعره كل ما يمكن أن يستتبع الغموض المشروع القادر على تجاوز المعنى الواضح الصريح،
للتحليق في آفاق تخييلية تعيد صياغة المألوف والمتداول.
وعلى الرغم من بعض التعثرات، فإن مسيرة الشعر العربي في
المغرب تنم بجلاء عن جرأة يتحلى بها الشعراء – إلى حد المغامرة – لمسايرة التوجه
الحداثي الذي يفرض نفسه على حضارة الأمة وثقافتها، والاندماج فيه، وإن بشيء من
الانسياق الأعمى لا ينتبه في معظم الحالات إلى ما يمس القيم الجوهرية والمقومات
الثابتة التي هي محور الأصالة الحق، والأساس الذي منه يكون كل تحديث صحيح.
ومع هذا التحفظ، يبقى الشعر في طليعة الكتابات التي تظهر
مدى التطلع إلى هذا التحديث الذي بدونه لا تستمر الحياة، بما يجعلها في مختلف
جوانبها تتطور وتنمو، وتحقق الرقي والازدهار للذين ينعمون أو يعرفون كيف ينعمون
بمستجداتها، ويعملون في الوقت نفسه على غنى متزايد لهذه المستجدات.
وبالله العون والتوفيق.
الرباط 28 صفر 1420هـ
الموافق 12 يونيو
1999م
(1) شارك
في وضع هذه المنتخبات عباس الجراري والدكتور أحمد الطريبق، وكانت في الأصل تضم نحو
عشرين ومائة شاعر، إلا أن نظر المؤسسة اقتضى أن يقلص هذا العدد إلى أربعة وستين،
من غير استشارة الواضعين. الأمر الذي دفعهما للتفكير في إعادة نشر المنتخبات
كاملة.
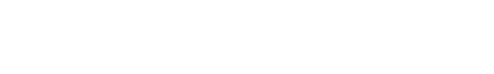

ديوان شاعر الحمراء:
روض الزيتون
محمد بن ابراهيم المراكشي
ضبط وتنسيق وتعليق
الدكتور أحمد شوقي بنبين
الطبعة الأولى (1)– مطبعة النجاح الجديدة
الدارالبيضاء 1421هـ - 2000 م
ن
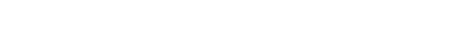

بسم الله الرحمن الرحيم
الشعر إحساس وتجريب وانفعال مع الذات الخاصة أو العامة،
في شتى العناصر المؤثرة فيها إيجابا وسلبا، مهما تكن هذه العناصر منسجمة ومتلاحمة،
أو متعارضة ومتناقضة. ثم يأتي التعبير بكل مقوماته اللغوية ومكوناته الإيقاعية
وأبعاده التخييلية، وبجميع الحوافز الحاثة عليه، والنابعة في حال الاستواء من ذهن
صاف شفاف، ورؤية واضحة لا حدود لما ترمي إليه من آفاق.
وعلى كثرة ما ينشد أو ينشر منسوبا إلى هذا النمط من
التعبير، فإن القليل منه هو الذي يكون جديرا بهذا الانتساب، في استحقاق لسمة الفن
والإبداع، لا فرق في ذلك بين قديمه والجديد، وما صدر عن أدباء المشرق أو المغرب،
مع تفاوت لا ينكر تتحكم فيه عوامل ثقافية وحضارية هي وليدة الزمان والمكان وما
يعتمل فيهما من مؤثرات بيئية مختلفة.
ولعل المتتبع لما أنتجه المغاربة من شعر على الخصوص،
وأدب وفكر على العموم، لا يلبث أن يلاحظ مدى انسلاكه في هذا السياق، وإن كان شيء
من الغموض يلفه، إن لم أقل شيئا من الاضطراب يكتنفه، بحكم العوامل نفسها، أي تلك
التي من شأنها أن تحرك مجراه وتبعث على نهوضه وحيويته. وما ضياع غير قليل من
النصوص أو تبعثرها وتشتتها إلا أحد ملامح هذا المظهر ؛ إضافة إلى الأحكام غير الدقيقة
التي ألقيت عليه، والتي لم تكن في غالبها مبنية على نظر نقدي فاحص حصيف.
وإذا كان مثل هذا الرأي ينطبق على الشعر المغربي القديم،
نتيجة ظروف تاريخية وأدبية واجتماعية ونفسية، فإنه منصب كذلك على حديثه والمعاصر ؛
مما قد يفضي إلى بعض التعجب والاستغراب، ويدعو إلى مزيد من الدرس والتمحيص، لتجاوز
هذا الموقف، بتأكيد المسير ومتابعة خطاه كأنه قدر ومصير، أو بمراجعة الرأي في هذا
الشعر، للنهج به في سبيل مخالفته ووضعه في إطار آخر.
وعلى طول مصاحبتي للشعر العربي قديمه وجديده، وما أنتج
المغاربة فيه، فما زالت تراودني هذه الأفكار وتعاودني بها هواجس. وهي تضغط علي
بإلحاح في كل مرة أستمع إلى قصيدة أو أقرأ ديوانا أو أطالع دراسة كتبت عن أحد
الشعراء.
وقد أحسست بهذا الشعور قويا في نفسي، وأنا أتصفح هذا
السفر الذي يضم مجموعة من القصائد والمقطوعات والأبيات والخواطر، أنشأها محمد بن
ابراهيم، هذا الشاعر الذي ارتبط اسمه بمسقط رأسه مراكش الحمراء، وإن تعدى صداه
مختلف حواضر المغرب وأقطار أخرى غيره ؛ في تألق دام نحوا من ثلاثة عقود، على مدى
سنوات الثلاثين والأربعين والخمسين، ملأ خلالها حيزا من ساحة الشعر وشغل الناس ؛
وأظنه ما زال يعتلي هذا الموقع، وإن مضى على وفاته زهاء نصف قرن.
والسبب أنه عاش فترة انتقالية غنية بالأحداث التي كانت
تحفها أزمات شتى وتناقضات متعددة، والتي تعكس لمتأملها واقع الحياة السياسية
والاجتماعية والثقافية ثم الأدبية بعد ذلك.
فهي فترة شهدت وسط أتون الاستعمار نهوضا متميزا بلوره
الفكر السلفي وما أعقبه من ظهور لحركة التحرير الوطنية بكل التحديات التي كانت
تواجهها. وكان هذا النهوض يحمل في طياته روافد وعي متحفز ومعالم ثقافة جديدة،
واكبها تطوير التعليم وبروز منابر أتاحت كتابة شعرية ونثرية كانت أساليبها تنزع
إلى تجاوز التقليد، وإن كانت في الحقيقة تعايشه، إذ ظلت بصماته قوية التجلي سواء
في الفكر أو في التعبير.
في أحضان هذه الفترة وجد شاعر الحمراء، وفي رحاب مراكش
التي كانت يومئذ تجسم الواقع بمختلف اضطراماته ومضاداته، عاش ينعم أحيانا ويشقى
أخرى ؛ إن لم أقل إنه كان ينعم بشقاوته ويشقى بنعمائه ؛ في عبث أو لا مبالاة ما
أظنهما عنده إلا يخفيان موقفا مما حوله ومن الناس كان مقتنعا به وعليه يسير. وكان
نمط حياته يساير هذه الأحوال، ويحث مع هذه المسايرة على قول شعر ينم عن حس مرهف
وسرعة بديهة ونفس متقدة وقدرة على التعبير الذي لم يكن يخلو من جودة وإبداع، ومن طرافة
النظم كذلك ؛ وإن لم يكن يعنى بتنقيحه وتثقيفه، ليس لعدم الحاجة إلى هذه المراجعة،
ولكن لأنه كان يلقي شعره وفق ما تمليه طبيعته اللامبالية وسلوكه العابث.
وكان هذا الشعر يذيع وينتشر، تصحبه حكايا وقصص هي – على
واقعيتها – أقرب إلى أن تكون من نسج الخيال، مما غدا به محمد بن ابراهيم أسطورة أو
يكاد.
من هنا تأتي أهمية هذا الديوان الذي أعاد صنعه الصديق
العزيز البحاثة المدقق الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين، بعد أن كان مجموعا من
قبل.
ولست أشك في مدى الجهد المضني الذي عانى في تنسيقه وضبطه
والاستدراك عليه، والتحقق من صحة نسبة بعض ما فيه إلى الشاعر، لا سيما وقد ظُنَّتْ
منه أشعارٌ كان ينشدها أو يرددها. وقد قصد المحقق كذلك إلى تجنيب الديوان ما رآه
مسا بالمقدسات والشرعية الوطنية، مما صدر عن ابن ابراهيم تحت تأثيرات معينة هي
وليدة الظروف التي عاش في كنفها، والتي كانت لا شك تلبي حاجاته وتستجيب لرغباته ؛
وإن كان في بعض شعره ما يدل على روح وطني صادق وولاء للعرش خالص، على حد ما يثبت
القليل الذي قاله في بطل التحرير الملك المجاهد مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه
وأكرم مثواه، وفي التجاوب مع التوجه الإصلاحي والتضامن مع شبان الحركة الوطنية في
كفاحهم ومقاساتهم من الاستعمار وأعوانه. ولعل الشاعر كان مع ممدوحه باشا مراكش
الحاج التهامي الـﮔلاوي كما كان المتنبي مع كافور،
أو هكذا كان يريد أن يكون، وإن لم يتسن له أن يفعل، على الرغم من أنه كان يصرح
بشيء من هذا، وفق ما نقل عنه بعض الذين كان يفضي إليهم بما في فكره وشعوره.
ثم إن الباحث السيد بِنبين بذل جهدا آخر في إعادة ترتيب
النصوص، وفي تحقيقها، والتعريف بالأعلام الواردة فيها أو المرتبطة بها، مما لا
يدرك صعوبته إلا من جرب هذا النوع من العمل الشاق الذي لم يهونه إلا تبريز المحقق
القدير وما له من باع في هذا المجال الدقيق وما يتطلبه من علم وتقنية قلما
يتوافران للباحثين في التراث ؛ إذ سار على منهج ميسر من شأنه أن يجعل القارئ
المختص وحتى العادي يرجع إلى الديوان ويستمتع بقراءته ويفيد من هوامشه غير
المثقلة.
وإني – لهذا وغيره – لأسعد بتقديم هذا الديوان الذي
طالما تاق عشاق الشعر إليه، وإن كنت لا أخفي أنه لا يقدم عن صاحبه ملامح الصورة
التي ارتسمت في الأذهان عنه أقرب ما تكون إلى الأسطورة. فقد ضاعت لا شك نصوص كثيرة
لم تكن منشورة أو مدونة، مما احتفظت به ذاكرة بعض رفاقه وأصدقائه الذين كانوا
يتندرون بها ويتلذذون بترديدها في مجالسهم الخاصة. وأكاد أجزم أنه كانت من بين تلك
النصوص وطنيات وإخوانيات وغيرها مما ظلت نتف منها دائرة على لسان بعض أدباء مراكش
وأحباء الشاعر.
ومع ابتهاجي بصدور هذا الديوان، أود أن أعرب عن تقديري
للأخ الكريم الدكتور أحمد شوقي بِنْبِين الذي أتمنى أن يتابع إخراج مثل هذه
النصوص، شعرية كانت أو غيرها، مما تزخر به الخزائن المغربية، بدءا مما تضمه
الخزانة الحسنية التي هو محافظها العارف الخبير ؛ مع تهنئتي إياه، والدعاء له
بدوام التوفيق واطراد السداد.
والله من وراء القصد.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الأول 1421هـ
الموافق 11 يونيو 2000م
(1)
أعاد طبعه بعد الزيادة والتنقيح في جزءين تحت عنوان :
"روض الزيتون: ديوان شاعر الحمراء" – المطبعة والوراقة الوطنية
الداوديات بمراكش 2002م.
فهرس
الموضوع
الصفحة
تقديم...................................................................................................... 9
الشعر الوطني في عهد الحماية 1912- 1956.................................... 17
الشعر الدلائي.................................................................................... 33
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972.. 43
شعر عبد العزيز الفشتالي............................................................. 61
فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي..................................... 71
من تاريخ منطقة تادلة وبني ملال............................................... 77
من الأدب المغربي على عهد الحماية........................................ 83
محمد بوجندار الشاعر الكاتب
عبد الله بن العباس الجراري........................................................ 89
مكونات الشخصية والثقافة
الإبداع والكتابة الأدبية
أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي
عالم الزاوية الدلائية وأديبها 95
رياض العشاق : ديوان زجل..................................................... 101
محمد المختار السوسي................................................................. 105
شعر الجهاد في الأدب المغربي من عهد الأمير يوسف بن تاشفين 111
المرابطي حتى عهد السلطان المولى عبد الحمان بن هشام العلوي
الشعر المغربي في المنصوَر السعدي956هـ - 1012هـ ت 1549م - 1604م 119
وفاء وولاء ..................................................................................... 127
منتخبات شعرية من أقاليم المغرب الجنوبية
الموجز في الشعر المغربي الملغز............................................. 139
أحمد بن أبي القاسم شيخ زاوية الصومعة ومعه زوايا المنطقة 151
ديوان الشيخ أحمد الهيبة.............................................................. 157
نبض العشق..................................................................................... 165
يا بني................................................................................................ 171
الصحراء المغربية في البحوث الجامعية................................. 187
في بلاغة القصيدة المغربية......................................................... 195
مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري 1934م – 1956م... 201
مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين.................... 209
ديوان شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم................................... 229
الفهرس............................................................................................. 237