عباس الجراري
الإصلاح المنشود
منشورات
النادي الجراري
- 33 -
الإصلاح المنشود
جميع الحقوق محفوظة
الإيداع القانوني : 2005/1545
ردمك : 05-14-893-9981
الطبعة الأولى
جمادى الثانية 1426 هـ يوليوز
2005م
مطبعة الأمنية
الهاتف : 39 48 72 037 الفاكس 27 04 20 037
- الرباط -
مقدمة
مشكـل الإصـلاح

قبل ثلاثة وثلاثين عاماً، وبالضبط في شهر غشت من سنة اثنتين
وسبعين وتسعمائة وألف -
وبعد أن كنت نشرت أطروحتي عن "القصيدة"(1)
الزجلية، ودراسة مُستجمعة "من وحي التراث"(2)،
وأخرى عن "الحرية والأدب"(3)
- أصدرت
مؤلفاً بعنوان : "الثقافة في معركة التغيير"(4)، جمعت فيه كتابات تهم قضايا تلكم
المرحلة، كمسألة التراث والمعاصرة، ومالها من تأثير في معركة المصير، وكذا الثورة
والثقافة الوطنية، ودور المثقفين، وأهمية الجامعات في إحداث التغيير.
يومئذ
كان الحديث عن هذا التغيير يثير متاعب لمن يجرؤ على تناوله ؛ بل كان مجرد التلفظ
بكلمته يجر الويلات على من يستعملها أو يذكرها، ولا سيما حين تقرن
بالمعركة أو بالثقافة، ويجعله في عين خصومها يصنَّف ويُسلك ضمن تيارات لم تكن
حينئذ منظوراً إليها برضى واطمئنان. وقد عانيت من ذلك على مختلف الواجهات -
بما فيها الجامعية التي يُفترض فيها أن تكون الموقع الثقافي بامتياز -
ما لو أردت أن أتحدث عنه لاحتجت إلى مجال لا تتسع له صحائف هذا الكتاب، فضلاً عن
أسطر مقدمته.
والأسف
شديد أننا إلى الآن، وعلى الرغم من مضي أزيد من ثلاثة عقود، ما زلنا على صعيد
أمتنا العربية والإسلامية نناقش الموضوع نفسه، بتردد ويأس حيناً، وباقتناع وتفاؤل
حيناً آخر ؛ مع أن الظروف المحلية والإقليمية والعالمية تطورت،
وأفرزت بإيجابياتها وسلبياتها إكراهات تأكد أنه لا سبيل للتغلب عليها
ورفع تحدياتها إلا بالتغيير الشامل، وإن وقع الميل - في الغالب وفي شبه
اتفاق - إلى استبدال الإصلاح بالتغيير، بعد أن غدا شعاراً يتردد
على جميع المنابر، وكأنه يبدو أخف وطئاً وأَدعَى للقبول؛ مع
أنه هدف قد يكون التغيير إحدى وسائله.
*** *** ***
إن
العرب والمسلمين اليوم يواجهون مشكلات كثيرة تراكمت خلال فترات طويلة.
وهم واعون بها منذ بدء احتكاكهم بالغرب، وإدراكهم مدى تقدمه وتخلفهم عنه، وإن لم
يستطيعوا - رغم يقظتهم نتيجة هذا الاحتكاك والإدراك -
أن يضعوا على أنفسهم السؤال العميق حول هذه الحقيقة : لماذا تأخروا هم وتقدم غيرهم
؟ أو بالأحرى لم يستطيعوا الإجابة الواضحة والصريحة عن هذا السؤال القديم الجديد،
وما يتبعه من استفسار عن دور المسؤولين عن ذلك، وإن كانت الإشارة غالباً ما توجه
إلى النخبة الممثلة في المفكرين، والمثقفين
عامة، أولئك الذين توافرت فيهم جملة شروط، بدءاً من المعرفة في أوسع مجالاتها، إلى
رهافة الحس، وعمق الوعي، وحيوية الضمير، والتشبع بالقيم، والتمتع بالمصداقية،
وإمكان كسب ثقة الآخرين عن جدارة. وهي الشروط التي تؤهل
المستحقين للانتساب إلى الثقافة، أن يكونوا أصحاب رؤية ورأي،
قادرين بهما على التعبير والتخطيط والتنفيذ، ثم على الإنتاج والتأثير الفاعل به.
فعلى
الرغم من ظهور دعوات إصلاحية نادى بها علماء ومفكرون من هذا الصنف، على امتداد
أطراف العالم العربي والإسلامي منذ بداية نهوضه قبل نحو قرنين، فإن هذه الـدعـوات
ظلت غير ذات صدى، أو كان لها صدى خافت لم يحقق الهدف المنشود.
والسبب
أنها كانت، بحكم طبيعة الفترة ومنظور أصحابها وثقافتهم، غير قادرة على ملامسة بعض
القضايا العميقة وإثارة المشكلات الناتجة عنها. ثم إنها بقيت حبيسة
تلك النخبة، لم يتح لها أن تصل إلى أولي الأمر بسبب عوامل داخلية وخارجية معقدة،
أو وصلت ولكنها كانت بدون رد، فضلاً عن أن يكون هذا الرد بالإيجاب.
كما لم يتح لها أن تبلغ الجماهير التي كانت - لطغيان الأمية
عليها - منعزلة عن كل ما يجري في الساحة، والتي كانت غير مبالية
بمثل هذا الشأن، لتخبطها في مشاكل الحياة اليومية بمعاناة قاسية.
ولعل
هذه الحقيقة الأليمة ما زالت للأسف قائمة
لحد الآن، مع الإشارة إلى أن تطورات كثيرة - ثقافية وحضارية -
مست المجتمعات العربية والإسلامية طوال المرحلة المذكورة ؛ ومع الإشارة في الآن
نفسه إلى تقلص دور المثقفين الذين اضطروا أمام ضغوط كثيرة، إلى التوقف عن أداء
رسالتهم، أو الوقوف تجاهها حائرين، إلا ما كان من فئة محدودة
مغلوبة على أمرها لم يعد لها التأثير اللازم، إذ بدا قصورها واضحا عن قيادة المجتمـع
والنظر في قضايـاه الملحـة، على الرغم من الجهود الحثيثة
التي تبذلها صادقة مخلصة.
ومن
ثم، لا يُستغرب إذا ما لوحظ اتجاه شرائح شعبية عريضة نحو من استغلوا هذا الفراغ،
وأخذوا يملأونه بأفكار خرافية تدجيلية أو دعاوي غالية متطرفة، أو غير هذه وتلك مما
يُلهي الناس ويبعدهم عن الهموم الحقيقية، وربما يبلد إحساسهم ويصرفهم عن كل ما
يقتضيه الإصلاح ويدعو إليه. وقد يتخذون مواقف عشوائية هي
في الغالب ضارة بهم وبالمجتمع ومؤخرة لأي إصلاح. وهذا ما فتح الطريق
لبديل من الإصلاح يُفرض من الخارج، وإن كان مرفوضاً على ما يبدو من الجميع.
*** *** ***
إن رفض العرب
والمسلمين لأي إصلاح يكون موحىً به ومخططا له من جهة خارجية، هي الولايات المتحدة
القائدة للنظام العالمي الجديد، هو في الواقع رفض لما يكمن خلف سياسة هذه الجهة من
عمل على أن تبقى إسرائيل، ليس فقط في موقع آمن إلى جانب مواقع أخرى آمنة كذلك،
ولكن على أن تكون لها السيادة والنفوذ في هذه المواقع.
وهو
الوضع الذي تظن القيادة الأمريكية - خطأ - أنه هو وحده الضامن
لمصالحها المرتكزة في المنطقة على مصادر الطاقة، والمفضية بالتحكم فيها وفي
مواقعها الاستراتيجية إلى إظهار التفوق وفرض السيطرة الاقتصادية، ثم العسكرية
والسياسية على العالم الذي غدت، بما لها من قوة ونفوذ، وكأنها وصية على جميع دوله،
تختار لهم أو تمنع عنهم ما تشاء ؛ ولاسيما بعد أن بدأت تهتز
دعائم الاتحاد الأروبي، على إثر رفض عدد من الدول المعنية لدستوره.
ولو تسنى لهذا الاتحاد وجود قوي، لكان بحق عنصر توازن وتخفيف لحدة تلك القوة وذاك
النفوذ.
وحتى
تكون دول المنطقة مسعفة في تحقيق ذلك الهدف التوسعي وطيعة له كذلك، فإن الولايات
المتحدة ترى ضرورة إعادة تشكيل خارطة هذه الدول وتطوير أنظمتها، وإدخال بعض
الإصلاحات الديموقراطية فيها. وهي تدعوها لذلك، كي تكون
قابلة لهذا النمط من العولمة والتحديث ومدعمة له وجزءاً منه ومستهلكة له، حتى ولو
أدت الثمن من قـدرات اقتصادها الوطنـي، إضافة إلى مالها
من إمكانات ثقافية تكون معرضة للضياع أو التشويه.
ذلكم
أن العولمة، وخاصة في هذا الجانب الاقتصادي الذي تتحكم فيه وتحتكره شركات كبرى
دولية عابرة للقارات، تثير الكثير من المشكلات التي يرجع بعضها إلى صعوبة تحرير
الاقتصاد المحلي وتأهيله، وما ينتج عن هذا التحرير من مس بالسيادة الوطنية، ومن
إحداث أزمات داخلية أبرز مظاهرها كساد الوضع التجاري بمختلف مكوناته، مع ارتفاع
نسبة البطالة وما يتبعها من فقر يزيد بتفاحشه في تضخيم الفوارق الاجتماعية
وإظهارها.
كما أن
التحديث المرتبط بالحداثة الغربية وما بعدها، ينبغي أن يراعي الاختلاف بين الظروف
التي نشأت فيها هذه الحداثة في الغرب، وبين واقع المجتمعات العربية والإسلامية.
ومن ثم فإن التحديث المأمول يقتضي - حتى يكون إيجابيا -
مراعاة ذاك الواقع، وعدم الابتعاد عن القيم، سواء في جانبها الخاص المتصل بالدين
ولغة المجتمع وثقافته ؛ أو في جانبها العام المعتمد على حرية الإنسان
وكرامته وحقوقه ؛ مع اعتبار منظور متفائل ومتسع للكون والحياة فيه وللمستقبل
ومسيرة التاريخ كذلك.
هذا،
بالإضافة إلى أن الرفض لأي إصلاح يُفرض من الخارج، نابع من الحق في رفض أي تدخل
أجنبي غير مشروع نحو أقطارنا العربية والإسلامية، وحتى نحو أي قطر آخر، سواء من
الناحية القانونية أو السلوكية. كما أنه نابع من الحق في أن
تدافع كل دولة عن سيادتها ومكونات ذاتها ومقومات كيانها. وهو نابع بعد هذا
من الحق في أن تكون لهذه الدولة اختيارات تبني عليها سياستها ومواقفها، بغض النظر عن مدى
ملاءمة هذه الاختيارات لما عند غيرها.
في هذا
السياق، وتجنباً لكل سوء فهم، وحفاظاً على علاقات طيبة عريقة مع العالم العربي
والإسلامي، فإنه ينبغي للولايات المتحدة أن تزيل الوهم الواقعة فيه بأنه بعد
انهيار الاتحاد السوفياتي وزوال الخطر الشيوعي، فإن ما أصبح يهددها هو هذا العالم
الذي تتهمه وعقيدته بالتطرف والإرهاب، وما نتج عن هذه التهمة الباطلة من إشاعة
مشاعر كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا). هذا في وقت يفترض
فيه أن يكون العرب والمسلمون أصدقاء لها وحلفاء. وهو افتراض قد
يتحقق إذا ما أزيل ذلك الوهم، وإذا ما أنهي الاحتلال التدميري للعراق وعولجت آثاره
النفسية والمادية. وإنه لأمر ممكن وغير مستعص إذا وجدت الإرادة
اللازمة له، خاصة وقد ظهرت بوادر رغبة في المحادثة بهذا الشأن مع الجهات المقاومة
لها وللاحتلال.
ولعل
التقارب الملاحظ الآن في السياسة الأمريكية على الصعيد العام تجاه الحركات
الإسلامية المعتدلة، أن يكون بداية مرحلة جديدة في العلاقة مع العرب والمسلمين، ما لم
يتبين أنه مجرد سلوك عابر تمليه المصلحة الوقتية، والأمل في احتواء هذه الحركـات،
لما لها من تجذر في الجماهير الغاضبة، وربما استغلالها لإزعاج الأنظمة القائمة.
والحديث
عن الاختيارات يقتضي البدء بالمسألة السياسية (5)التي كثر تناولها
في
هذه
الأيام
مقرونة إلى الإسلام، ما بين
القابلين أن يكون لهذا الدين دخل فيها وتوجيه لها، وبين الرافضين لذلك، الداعين
إلى علمانية تعتمد فصل المجالين، وبين الذين يرون تأجيل النظر في الأمر، ويبدون
تردداً وتحفظاً فيه لما له من خطر وأهمية.
إلاّ
أن هذه المواقف جميعها لا ينبغي أن تؤدي إلى القول بأن الإسلام لا صلة له
بالسياسة، أو أن العلماء - والمثقفين عامة -
لا ينبغي أن ينشغلوا بها. فالسياسة ميدان واسع يمس مختلف
شؤون الحياة، والذين لا يعنون بها أو يبعدونها عن اهتماماتهم هم في الحقيقة بعيدون
عن مجتمعهم، وغير مبالين بهمومه. وهي إلى هذا الملمح الواقعي،
تضيف ملمحاً آخر يؤهلها لاحتلال مكان بارز في هذا الميدان، والنهوض بدور فاعل فيه،
بما لها من قدرة على التوقع، من خلال رؤية مستقبلية لا يمكن أن تصدر إلا عن وعي
ثقافي وعمق فكري وقدرة على التدبر البعيد.
وبناء
على هذه الحقيقة، فإننا نرى أن القضية تحتاج إلى إعادة النظر بتأن واعتدال في
مختلف الأنظمة التي تسير عليها الأقطار المعنية، من خلال رؤية إسلامية صحيحة
وواضحة، تهدف إلى تحقيق التنمية الشمولية، وإرساء دعائم الديمقراطية الحق في بعدها
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع تعميق التأمل عبر الشورى في قضية الحكم. ونعتبر ذلك من الأولويات التي تلزم العناية بها
في الإصلاح ؛ مع التنبيه إلى أن الديموقراطية - أو الشورى -
بدون أهلية لممارستها قد تتحول إلى نقيضها لتركز الديكتاتورية، ولا سيما
في غياب التنمية ببعدها الإنساني المتكامل.
إن
عدداً من المعضلات التي تواجه هذه الأقطار، يكمن - ليس في التمسك
بالدين والإلحاح على ضرورة اعتماده كما يظن - ولكن في الاختلالات
التي تعرفها أنظمتها عامة، والتي تكفي الإشارة منها إلى تعثر الإجراءات
المتخذة لإحلال الديموقراطية فيها وفق النمط الغربي، إن لم نقل فشلها، وإلى تفاقم
المشاكل الاجتماعية التي تتمثل في تفشي الأمية وتضخم الفقر وتزايد الإقصاء وتفاحش
البطالة واتساع الفوارق الطبقية وانتشار الفساد في مختلف صوره، والتي يتوقف حلها
على إجراء إصلاح شامل ومتكامل.
صحيح
أن هذا الإصلاح وارد بل حاصل لا ريب، سواء في أمد قريب أو بعيد،
أي بغض النظر عن نوعه وعن الموقف منه ؛ ولكن حتى لا يكون على غير ما تستلزمه
الحاجة، وحتى لا يتم على يد قوى أجنبية من المؤكد أنها ستوجهه لصالحها، فإنه لابد
من إرادة محلية لإجرائه.
والمقصود
بالإرادة أن تكون الرغبة في تحقيقه داخلية، ومنطلقة من الوعي بأهميته وجدواه،
والإحساس بضرورته وحتميته. وإن وجود هذه الإرادة ليقترن -
ويجب أن يقترن - برؤية واضحة تنطلق بتواضع وفي غير استعلاء، من نقد شجاع
للذات في جميع مستوياتها، على ألا يكون قصده بث روح اليأس فيها والإحباط، ولكن كشف
الأخطاء والمصارحة بها والبحث عما به تُصوَّب وتُصحّح.
*** *** ***
ومن
ثم، تفضي الرؤية بتفاؤل واستبشار إلى التخطيط لذاك الإصلاح وتوجيهه، حتى لا تصيبه
الفوضى أو العشوائية. وهي مسؤولية النخبة الواعية والمتنورة، من علماء
ومفكرين ومثقفين عامة، ممن ينطبق عليهم الوصف الذي سلف ذكره.
إن
هؤلاء الذين يلقى عليهم العبء بكل تبعاته - أو بعضهم على الأقل
- يقفون اليوم في حيرة من أمرهم أمام هذا الواقع المرير،
مترددين في اتخاذ الموقف اللازم منه ؛ أبالتعاون معه والانخراط في دواليبه رغم ما
ينخره من خلل وفساد ؟ أم بالابتعاد عنه والاحتفاظ بالقدرة على انتقاده والجرأة على
تقويم اعوجاجه حسب الإمكان ؟
ويبدو
أن هذا التردد راجع إلى ما يتملك تلك الفئة من المثقفين ويسكنهم من قيم يومنون
بها، ولا يمكنهم التخلي عنها ؛ وإن تخلوا ضاعت مصداقيتهم مع
ذاتهم ومجتمعهم. وهم يخشون تعريضها للضياع إن قبلوا الاندماج في هذا
الواقع والمشاركة في تسييره، دون إمكان تحقيق التصحيح المطلوب لجميع بنياته.
والسبب
أن مثل هذا التصحيح يتطلب مراجعة كثير من هذه البنيات - سياسية واقتصادية
واجتماعية وفكرية - وكذا جل المساطر والتشريعات التي أسست عليها أو
اعتمدتها. وقد لا تتسنى هذه المراجعة قبل تشكُّل جديد للرؤى وما
يترتب عليها من مظاهر شتى للحياة والإنسان، في نطاق مشروع مجتمعي تتأكد فيه الحقوق
والواجبات، مع التركيز على هذه الواجبات التي غالباً ما تُهمل وتُنسى في سياق
المناداة بتلك الحقوق، حتى ما كان منها غير مشروع، والتي يتطلب النهوض بها نشر قيم
العمل والإنتاج، في إطار من الجد والمثابرة والصدق والإخلاص.
وسيتبع
ذلك لا شك - أو يسبقه -
إجراء معاودة تحديثية لوضع النخب التي هي القوى الحقيقية لتوجيه المجتمع، بما
يلائمه في سيره، وما يتحكم فيه من نواميس وقوانين، وبما يُغني هذه النخب من طاقات
شابة، ويجعلها مؤهلة لتمثلات جديدة تستفيد لا شك من الاستقطابات
السياسية والثقافية السائدة، على الرغم من أن هذه في بعضها لا تثبت للمعاودة وقد
لا تقبلها.
ولعل
المفكرين والعلماء والفقهاء الذين يحتلون الموقع المتميز في هذه
الاستقطابات، هم أكثر حاجة من غيرهم إلى التحديث الذي قد يسعفهم في الانتقال -
عن جدارة إذا ما تجاوزوا عوائق الوصول - من ثقافة القضية
إلى ثقافة السلطة، أي من ثقافة الانعزال بما يكتنفها من تردد وحيرة أو سخط وتذمر
مهما يكن فيها من نقد إيجابي، إلى ثقافة ميدانية عاملة، قادرة على البناء والتأسيس،
تكون مرتكزة على العلم والعقل والإبداع، أي على الاجتهاد
الذي لا يكون موجّهاً لتبرير تصرفات منحرفة ؛ مع المحافظة على القيم الحقيقية
والمبادئ الصحيحة، في غير تضحية بها قد تؤدي إلى انتهازية متزلفة أو انهزامية
محبطة. وهو وضع قابل للتبديل، إذا ما استعاد المثقفون الثقة
بأنفسهم وفكرهم، وبدورهم الحق يؤدونه بحرية وشجاعة ومسؤولية، غير لاَبِسين
الحق بالباطل ولا كاتميه عن قصد وعلم، وكذا إذا ما أتيحت لهم فرص الاندماج.
وإن
هذه الإتاحة لتتوقف على مدى عناية الدولة بهم، مع كل ما تستوجبه هذه العناية من
تكريمهم واعتزاز بكفايتهم وجهودهم، مع الاستماع إليهم والعمل بآرائهم وتوجيهاتهم،
وكذا تقريبهم من مراكز المسؤولية وإشراكهم فيها تخطيطاً وتنفيذاً، حتى لا يصيبهم
التهميش والإقصاء وما ينتج عنهما من مواقف غالباً ما تكون مجرد رد فعل قد يصل إلى
حد بعيد في الرفض والإنكار والعداء.
على أن
الحديث عن المثقفين وأهميتهم لا ينبغي أن يفهم منه إلغاء الجماهير أو التقليل من
شأنها ؛ بل إن قيمة دورهم تكمن في مدى ارتباطهم
العضوي بها والتعبير عنها واستمداد القوة منها والقدرة على الفعل والتأثير، بما
لهم من مسؤولية يتحملونها، سواء أكانوا في مواقعها الرسمية إذا تسنت لهم الظروف
الملائمة، أم كانوا خارجها حين لا تتاح تلك الظروف كما هو الحال في ظل الأوضاع
الراهنة.
*** *** ***
ومع
ذلك، فإن الثقافة في بداية الأمر ونهايته - وليس غيرها -
هي وحدها القادرة على التخطيط لإصلاح حقيقي وعميق في جميع جوانبه السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والنفسية، بكل ما يستلزم هذا التخطيط من أدوات
وآليات. وذلكم تحفزاً - كما سبق القول -
من رؤى ومناهج قائمة على تشخيص سليم للواقع وما فيه من أزمات خانقة. وهو
ما يستوجب التحلي بالجرأة اللازمة لبحث هذه الأزمات والكشف عن أسبابها وتوعية
الشعوب بها وبما يتطلب حلها، حتى تقتنع وتساير وتشارك، في غير وقوف للشماتة
والتشفي، أو انتظار الذي لن يأتي أبداً بناء على آمال سرابية ووعود كاذبة.
والتحفز
من الرؤى المتسمة بالشمولية والتكامل، والدالة على وعي بمختلف الملابسات وإدراك
لحقيقتها، يعني منظوراً للمستقبل قد يراه بعض المعتنين ممكنا إذا وقع التخلص من
الماضي، بما فيه من مرجعيات وما أنتجت من تراث يشد إلى الوراء -
كما يقولون - لما علق به من شوائب على امتداد فترات التاريخ.
صحيح أن شوائب كثيرة تشوه تراثنا وتسيء إليه، ولكنها ليست
مبرراً لرفضه وإنكاره، فضلاً عن الهجوم عليه والطعن فيه. إن النظر السديد إلى هذا التراث
للاستفادة منه، يتوقف على تصفيته من تلك الشوائب، بوضعه في ميزان العلم والعقل،
وكذا على محك التاريخ وما عرف من تطورات وتقلبات، ثم تأمله - بثوابته ومقدساته - في ضوء الواقع بكل مكوناته وما
يحتاج من إصلاح. فذلكم هو
وحده الكفيل بإبراز ما لهذه الثوابت والمقدسات من رسوخ وما تختزنه وتختزله من
حقائق حيّة وفاعلة، وليس مجرد ترسب زائد تكون إثارته من قبيل الدعوى الفارغة أو
الباطلة.
ومع
تصفية التراث على هذا النحو، ينبغي كذلك تصفية العقل العربي والإسلامي من مشاعر
التقديس الزائفة، ومن الأفكار الخرافية الساكنة فيه وفي الوجدان ؛
لإمكان استخلاص القيـم الصحيحـة والدعائم القوية
التي هي خير دافع للمستقبل في أمده القريب والبعيد.
*** *** ***
وليس
الأمر سهلا على الإطلاق، لأن الإصلاح - من حيث هو -
بما يقتضي من تصحيح لواقع معين غالباً ما يكون فاسداً أو غير ملائم، يجعلنا نتصور
ما يحيط به من صعوبات ينبغي الصبر على تحملها لتجاوزها والتغلب عليها، على
أن يتم ذلك بموضوعية وعقلانية، وبفهم للحاضر وتمثل للمستقبل، واستعداد لرفع كل
التحديات الآنية، وكذا للنهوض بالمسؤوليات الجديدة.
في هذا
الإطار، يجدر التنبيه إلى أهمية الإعلام الذي يتحمل - بالحرية التوجيهية
والنقدية التي يتمتع بها - عبئاً كبيراً في التوعية
بالإصلاح، إن لم أقل الإسهام في صنعه وقيادته ؛ لكن ليس كما تفعل
بعض وسائله للأسف، بأسلوب يعتمد الإشاعة والإثارة والطعن العشوائي في هوية الأمة
ومالها من مرجعيات.
مهما
يكن واقع هذا الأمر، فإن ما يجب استحضاره هو أن المشكلات التي تواجه العرب
والمسلمين اليوم، تتجلى حقيقتها في السعي إلى التقدم والبحث عن وسائل بلوغه، بدءاً
من تطوير أنظمة الحكم التي هي في بعضها متهالكة، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية
التي في سلامتها يكمن ضمان استقرار هذه الأنظمة. وبعد ذلك ينظر في
إمكان التوفيق بين مقتضيات العولمة بقيمها الجديدة التي لا تخلو من ملامح إنسانية،
وبين متطلبات الهوية الصحيحة والثابتة في مقوماتها الوطنية ومكوناتها العربية
والإسلامية.
ولعلنا أن نؤكد ما أوضحناه أكثر من مرة(6)،
من أن هذه الهوية تتمثل في الدين واللغة والثقافة والوطن. أما الدين فهو الإسلام إلى جانب
الديانات الأخرى التي يتعايش معها بتسامح في أقطار معينة. وأما اللغة فهي العربية باعتبارها
لسان القرآن الكريم، ومعها اللغات المحلية وما يساكنها من لهجات عامية. ومن هذين المقومين تتشكل الثقافة
بتراثها في جانبيه المدرسي والشعبي، وما يغتنيان به من تنوع وتعدد، مع ضرورة تقريب
ما هو جامع
واستبعاد ما هو مفرق، وكذا مع الجنوح الصادق إلى محاورة الذات والآخر بهدف التفاهم
والتكامل(7).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مقومات الهوية - ولا سيما منها الثقافة في عمومها - هي أقدر من السياسة الاحترافية
على التقريب بين الشعوب المتباعدة وإشاعة روح التعايش بينها، على الرغم من وجود
اختلافات ثقافية ؛ بل لعل هذه الاختلافات هي التي تجذب المجتمعات المتباينة ثقافيا
لمزيد من التآلف المفضي إلى التعاون والتحالف بناء على مبادئ وقيم. هذا في وقت يؤدي تعارض المواقف
السياسية إلى التنافر الذي غالبا ما يقود إلى الصراع والعداء في اعتماد على الخداع
وتحكيم المصالح.
هذا،
ومع المكون الديني واللغوي والثقافي للهوية، يبرز الوطن، بدءاً من حدوده الضيقة
إلى امتداده عبر العالم العربي والإسلامي الشاسع. ذلكم أن الوطن في
مفهومه الظاهر والمحدود يجسم الأرض التي يولد فيها المنتمون إلى
تلكم الهوية ويحيون فيها ويموتون. وهو في مفهومه الخفي والواسع
يعتبر القسمة المشتركة والخيط الواصل بين هؤلاء، والجامع
لأمرهم، والمغذي لكل الروابط النفسية والفكرية الناتجة عن وجودهم في هذه الأرض،
والدافعة لهم إلى حمايتها والذود عنها والاستماتة في سبيلها، والباعثة لهم على
معانقة الذين يلتقون معهم عبر هذه الروابـط، حتى وإن كانوا
يعيشون في أرض بعيدة عنهم.
ومن
ثم، يلزم التمييز في الإصلاح بين بعده الوطني المحلي، وبعده العربي والإسلامي، ثُمّ
بعده العالمي والدولي. وهي عملية تستوجب اعتبار مستلزمات كل هذه
الأبعاد، في حفاظ على مقومات الذات، ومع الحرص على تحقيق حلم الوحدة وبلورته في
صيغة ملائمة، وكذا مراعاة ضرورة الإندماج فيما هو إنساني والتعاون معه ؛ على أن
يتم هذا كله بوعي وتعقل، وباعتدال واتزان،
وفي غير تفريط أو إفراط، لأن غلبة أي منهما تُفضي حتماً إلى ضده و نقيضه، وذلكم هو
مكمن الصعوبة في المعادلة.
*** *** ***
وبعد،
فإسهاماً مني في بحث هذه المعادلة التي تحتاج إلى كثير من الدرس والتأمل، لإيجاد
الحل الملائم لها والصحيح، أنشر هذا الكتاب الذي مهدت له بهذه المقدمة التي حاولت فيها
تناول إشكال الإصلاح المأمول، والذي يضم بين دفتيه مجموعة من
العروض كنت قدمتها في وقتها، وشاركت بها
في
مؤتمرات ومنتديات نظمتها مؤسسات وهيآت معنية بهذه القضية، وفق منظور شمولي يراعي
جوانبها المختلفة.
وهي
كالآتي وفق تاريخ تقديمها، وعلى النحو الذي تم به هذا التقديم :
1 -
حضارة إنسانية وهويات مختلفة.
2 -
منظور العرب والمسلمين للولايات المتحدة الأمريكية.
(من خلال عوامل التلاقي والتباعد).
3 -
صراع أم حوار ؟ بل هو حوار ... ولكن.
4 -
التجديد الثقافي أول شروط التغيير الشامل.
5 -
أي مستقبل عربي في ظل ثقافة التغيير ؟
6 -
أهمية الثقافة العربية في إبراز الهوية لمواجهة العولمة.
7 -
اللغة العربية: واقع يحتاج إلى تطوير.
8 -
منطلقات لخطاب إسلامي معاصر.
فلعل
هذه العروض - مع التقديم الممهد لها - أن تلقي بعض الضوء
المسعف في تلمس الطريق الصحيح الموصل إلى الإصلاح المنشود.
وبالله التوفيـق.
الرباط في فاتح
جمادى الثانية 1426هـ
الموافــق لـ 8 يـوليـوز 2005م
عباس
الجراري
(1) مطبعة الأمنية بالرباط – 1390 هـ -
1970 م.
(2) نفسها - يناير 1971.
(3) نفسها - مايو 1971.
(4) طبع دار النشر المغربية بالدار البيضاء –
1972.
(5) انظر ما حرره الكاتب عن هذه المسألة في مؤلفيه:
*) الإسلام واللائكية (بالعربية والفرنسية والإنجليزية) - طبع
بالرباط
(142 هـ -
2003 م) ضمن منشورات النادي الجراري - رقم 26.
*)
الدولة في الإسلام: رؤية عصرية - طبع بالرباط (1425 هـ - 2004 م)
ضمن المنشورات نفسها - رقم
27.
(6) على نحو ما في
الكتابين :
*) الثقافة من الهوية إلى الحوار (طبع بالرباط 1413 هـ -
1993) ضمن
منشورات النادي الجراري - رقم 3.
*) هويتنا والعولمة (طبع بالرباط 1421
هـ -
2000 م)
ضمن منشورات
النادي الجراري -
رقم 18.
(7) انظر الدراسات المنشورة للكاتب في هذه المسألة، وهي:
*)
مفهوم التعايش في الإسلام (بالعربية والفرنسية والإنجليزية) نشر
الإيسيسكو 1417هـ - 1996م.
*)
الذات والآخر (بالعربية والفرنسية) طبع بالرباط 1418
هـ - 1998م - ضمن منشورات النادي الجراري - رقم 13.
*)
الحوار من منظور إسلامي (باللغات الثلاثة) نشر
الإيسيسكو 1420 هـ
-
2000م.
حضـارة إنسانيـة
وهويـات مختلفـة
عرض مستخلَص من المحاضرة المرتجلة التي ألقيت بدعوة من النادي الدبلوماسي
المغربي، في قاعة بلا فريج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مساء
الثلاثاء
24 رجب 1423 هـ الموافق فاتح أكتوبر 2002 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
أصدقائي الأعزاء
أستسمحكم - بداية - في أن أعرب بكلمتين عن شعور غامر أحسست به
منذ تلقيت الدعوة لهذا اللقاء، وزاد إحساسي به اللحظة وأنا أدخل هذه القاعة.
أما
الأولى، فكلمة شكر للنادي الدبلوماسي المغربي، على دعوته الكريمة، مع التنويه
بالنشاط المتميز الذي يقوم به ؛ وأخص بهذا الشكر الأخ العزيز سعادة السفير الأستاذ
مولاي أحمد الإدريسي الذي قرب خطاي للاجتماع بحضراتكم في هذه الأمسية.
وأما الثانية، فعن
السعادة التي تغمرني ممزوجة بالاعتزاز، وقد وجدت نفسي بينكم في هذه الوزارة
الموقرة، وكأني لم أغادرها قبل ستة وثلاثين عاماً، بعد أن كنت منخرطاً في سلك
أطرها على مدى أربعة أعوام قضيت ثلاثاً منها في سفارة المغرب بالقاهرة.
وبعد، فعلى الرغم من أني كنت أود أن أنتهز مناسبة هذا
اللقاء، لإثارة إحدى القضايا المباشرة التي تواجهها السياسة المغربية حالياً، حتى
نتبادل الرأي والفائدة من مناقشتها، فقد اقتضى النظر أن أتناول موضوعاً هو كذلك
مرتبط بالواقع السياسي الراهن، لولا أنه يتسم بشيء من الشموليـة والاتسـاع، مع
مرتكزات فكرية وتاريخية منها ينطلق هذا الواقع.
والحق أني، سواء بهذا الموضوع أو غيره، سأكون وأنا أعرضه
على المتخصصين في الدبلوماسية المبرزين فيها، كواسق التمر إلى هجر، أو مستبضعه إلى
طيبة أو خيبر ؛ إذ أنتم بطبيعة عملكم ومالكم فيه من ممارسة دائبة، في واجهة
الميدان، وذوو معرفة وخبرة بمثل هذه الموضوعات.
لذا، فإني لا أزعم الإتيان بجديد أو
بشيء غائب عنكم، وإنما أقصد إلى مناقشة قضية أتمنى أن تُتاح الفرصة في آخر العرض
لتبادل وجهات النظر معكم حولها.
هذه
القضية هي كما جاءت في العنوان : "حضارة إنسانية وهويات مختلفة".
أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات،
لا يخفى أن العالم الآن يعيش تحولات دولية ستكون لها
لاشك عواقب وآثار لا يدري أحد مداها، وإن كثرت حولها التكهنات والتنبؤات. والعرب
والمسلمون يواجهون في سياق هذه التحولات تحديات عديدة، ويعانون تناقضات مع ذاتهم
ومع الآخر، في نزاع شديد يصل إلى حد التشتت والتمزق، وبث روح الانهزام واليأس.
وأبرز هذه التناقضات حيرتهم أمام ما يشاع من تهم تمس
دينهم وحضارتهم وثقافتهم وحتى وجودهم، في وقت لم يفتأوا يبدون رغبتهم في الانخراط
في العالم الجديد، وإن لم يستعدوا لذلك على النحو اللازم. وتتجلى هذه الحيرة في
مظاهر كثيرة، لعل في طليعتها كيفيـة التوفيـق بين هذا النظـام ومتطلباتـه، وبين
هويتهـم وما يشكلها من قيم ومقومات.
وإن أذنتم، فسأتناول هذا الموضوع من خلال مقدمة وثلاثة
محاور وخاتمة.
في المقدمة، أود أن أوضح مفهوم مفردات هذا العنوان، إذ
بناء عليه سيوجه النظر إلى الموضوع.
أما الحضارة في معناها اللغوي فمشتقة من حضَر الشخص
يَحْضُر حضارة إذا سكن الحضَر فهو حاضِر. كما يقال حضِر (بكسر الضاد) يحضَر حضَراً
(بفتحه فيهما) إذا صار حضِراً (بكسره)، أي يقيم في الحضَر الذي هو المدينة ؛
وتقابلها البادية التي يطلق البادي على من يسكنها.
من هنا فإن الحضارة هي عكس البادية، والتمدن مثلها أي مثل الحضارة.
وارتبط بهذا المدلول اللغوي أسلوب أو نمط من الحياة
متحضر ظهر مع بداية التجمع والالتئام في حواضر - أي في مدن - لم تلبث أن تشكلت
منها مجتمعات منظمة ومنتظمة في دول.
وبظهور هذا النوع أو هذا المستوى من الحضارة - أو قريب
منه - خرج الناس من مرحلة العيش البدائي القائم أساساً على التنقل والصيد، إلى
مرحلة تعتمد الزراعة والتجارة والتوسل ببعض المواد الأولية لصنع أدوات وأجهزة، في
محاولة للتكيف مع البيئة، والتجمع في قرى أو مدن للاستقرار. وارتبطت هذه المرحلة
بنشأة الكتابة والنظرة التقديسية لبعض مظاهر الكون قبل أن تظهر الديانات السماوية.
ومع التطور الذي عرفته الحياة الإنسانية في مختلف
المجتمعات عبر العصور وما تعاقب عليها من دول، مس الحضارة ازدهار كبير آل إلى ما
نعيشه اليوم وننعم به. فكان أن أخذ مفهومها يتسع عند بعض الدارسين ليشمل مظاهر
العمران المادية، وكذا ما يقترن بها متصلاً بمشاعر الأفراد وأفكارهم ومعتقداتهم
وما لهم في هذا كله من عادات وتقاليد متوارثة، ومالهم كذلك من إبداعات يجددون بها
هذا التراث ويضيفون إليه، مما يشمله مصطلح الثقافة. في حين ضاق المفهوم عند آخرين
ليقتصر فقط على الجانب المادي، في مقابل الجانب الآخر الدال عليه هذا المصطلح،
أقصد الثقافة ؛ وهو المنحى الذي أميل شخصياً إليه. ثم إن الحضارة تعتبر إنسانية،
أي في ملك البشرية جمعاء، تغنيها وتنميها، وتستهلكها مستفيدة من ثمراتها جيلاً إثر
جيل.
وأما الهوية - وهي بضم الهاء - فمجموع ما يكون به الشيء
هو هو، أي ما يكون به وجوده وماهيته. وهي بالنسبة للإنسان ما تتحقق به ذاته وشخصيته.
ولها مكونات بها تتشكل، يمكن حصرها في أربعة عناصر ومقومات:
1 - الوطن أو البيئة
2 - اللغة مع ما يكون معها من
لهجات
3 - الثقافة بما فيها من تراث
4 - الدين
ويعتبر هذا
المقوم الأخير أهم المكونات جميعاً، لما له من أثر في تكييف سائر العناصر الأخرى،
إذ هو الذي يكيفها ويطبعها ويمنحها الروح.
وبحكم هذا
التشكيل، تكون الهويات مختلفة أي غير مؤتلفة، لكل منها خصوصيات ومميزات قد تتسع أو
تضيق لتحقق بعض التقارب أو التباعد، ولكنها في جميع الأحوال تكون - وينبغي أن تكون
- قابلة للالتقاء وتبادل الأخذ والعطاء.
بعد هذه المقدمة التي أرجو ألا أكون أطلتها، أبدأ
بالمحور الأول أثير فيه ما بين الحضارة والهوية من علاقة. وهي علاقة وطيدة لأن
الإنسان الذي اهتدى ويهتدي للحضارة مبتكراً ومجدداً، إنما فعل ويفعل ذلك بفكره
وعقله وماله من قدرات إبداعية، أي بما له من ثقافة.
والحضـارة في بعدها المـادي تنتقل وتتوارث جيلاً بعد جيل
- كما سبق أن ذكرت - حتى حين تنهار وتخلفها أخرى. وكنت في بعض دراساتي المنشورة قد
أبرزت أن عمر الحضارات، أو الحضارة الإنسانية بمختلف أجيالها وأسرها، يكاد يكون
واحداً لتسلسله واتصاله، ومحدوديته كذلك في الزمن إذا ما قيس بعمر الحياة والكون
وما عرفته البشرية من مراحل أولية وبدائية، قبل أن تهتدي إلى التطور الذي به دخلت
مرحلة التمدن الذي به يؤرخ لنشأة الحضارة بالمفهوم المتداول. هذا مع العلم أن
حضارات سابقة عليها قد بادت بعد أن كان لها وجود وحضور في أزمان غابرة، منذ أن خلق
الله الإنسان واستخلفه في الأرض، وقبل أن يدعوه لدياناته التي بها لاشك فتح صحفاً
جديدة من الحضارة تبدو أكثر تماسكاً وأقوى على البقاء، بسبب نفعية عطاآتها، وعن
طريق التوارث الذي به يتحقق التواصل.
مهما يكن، فإن الحضارات تشكل حلقات في سلسلة يأخذ بعضها
بتلابيب بعض، إذ كلما ظهرت حضارة وتألقت وبلغت أوج ازدهارها، إلى حد الشعور
بالغرور الذي يفضي بها إلى الانغلاق، والذي يفقدها التوازن مع نفسها وبيئتها
والمحيط الذي تتعامل فيه، أصابها انهيار يتيح المجال لغيرها أن تبرز وتترعرع،
مبشرة بدورة جديدة تجتاز هي كذلك نفس السبيل قبل أن تتعرض للانحلال.
وهكذا، تتواصل الحضارات، من غير أن تنتهي الحياة عند
نهاية فترة حضارية ما، ومن غير أن يتوقف الإبداع الإنساني الذي هو أساس كل نهوض
وتجديد. وغالباً ما يتحقق هذا الإبداع على يد الفئة أو الفئات التي تكون قد عانت
الإهمال أو القهر والاضطهاد، وعاشت المحن والآلام، وتحملتها بإيمان في المستقبل،
وفي غير يأس من التغيير، ودون الاندهاش أو الذهول الإحباطي أمام القوى الباغية
والمتجبرة ؛ مع الاستعداد لهذا التغيير بما يلزم من جد وجهد وإنتاج وما إليها من
الأسباب الموصلة إليه والمحققة لأهدافه.
على هذا النحو تتسرب الحضارة وتستهلك مظاهرها. وقد يتم
ذلك بسرعة أو ببطء قليل وفق ما يتبين من فائدة لهذه المظاهر. من ذلك على سبيل
المثال متعلقات الأكل واللباس وشكل الهندام عامة كاللحية وغيرها، إضافة إلى ما يعد
عموماً في الآليات والأدوات التي يستعمل الإنسان في الحياة، بعد أن يدرك نفعها، من
غير أن يسأل عما وراءها من مكـامـن وخلـفيـات. وهو يفعل ذلك بتلقائية ما لم يشعر
بما قد يتعارض مع هويته.
ومن هنا يمكن القول بأن التسرب الحضاري يتم في غير حاجة
إلى حوار يبرره، ومن باب أولى بدون صدام، والسبب أن الصراع تولده مصالح سياسية أو
اقتصادية أو عسكرية. ولعلنا بهذا أن نبطل ما ذهب إليه صمويل هانتنكتون من صدام بين
الحضارات، يقصد بين حضارة الغرب المسيحية والحضارة العربية الإسلامية، باعتبار أن
حضارة العرب والمسلمين لا ترقى إلى مستوى حضارة الغرب ؛ مما يقود إلى المناداة بإسلام أمريكي
يأخذ بالقيم الغربية. ومثل هذا نادى به فوكوياما الذي يرى ضرورة الانتصار على
الإسلام والمسلمين ولو بتدميرهم، كما حدث مع النازية. والحق أنه لا أحد يزعم
منافسة الحضارتين، على ما بينهما من أواصر، لاسيما بعد أن توقف - أو كاد - نمو الحضارة العربية الإسلامية ؛ وحتى على
افتراض وجوده فإنه ليس مبرراً للصراع.
وعلى عكس الحضارة التي يقع الإقبال على مظاهرها المادية
بسرعة، كيفما كان مصدرها وكيفما كان التغير السريع الذي تتعرض له، وذلكم بحكم
نفعها الملموس
- كما
أسلفت - وكذا لعدم ارتباطها بأفكار ومعتقدات وترسبات في الوعي واللاوعي ؛ فإن
الهوية - ولاسيما من خلال مكونها الثقافي - لا تلقى مثل هذا الإقبال، لتشبث
أصحابها بما لهم من عادات وتقاليد وما يومنون به من عقائد دينية، وما يمارسون من
سلوك.
ومن ثم فإن تغيرها بطيء حتى حين يكون التغير الحضاري
المصاحب واضح المعالم، مما قد يصل إلى درجة التخلف. وقد يتحقق داخليا بما قد تعرفه
البيئة العامة لهذه الثقافة من تطور، كما قد يتحقق بالتثاقف القائم في مدلوله
الإيجابي على الاحتكاك بثقافات أخرى مماثلة تتيح التبادل، أو مهيمنة تفرض التقليد
والمحاكاة.
وحتى في هذا الحال، فإن بعض العناصـر المكونـة للثقافة -
وأهمها الدين ثم اللغة - تبقى ثابتة راسخة، أوفي حكم الثابتة والراسخة. وهو ما
يجعل هذه الثقافة قادرة على البقاء وعلى المقاومة كذلك ؛ وإن كانت مقومات أخرى
تبدو أكثر انصياعا للتبدل، ولاسيما ما يتصل منها بمجال الإبداع العلمي والأدبي
والفني، وكذا بالمجال الأقرب للماديات، كأنماط العيش وأساليبه عامة، مما هو أقرب
إلى مظاهر الحضارة.
وأود هنا أن أعيد التذكير والتأكيد بأن الثقافة هي مجموع
ما يشعر به الإنسان في مجتمع ما، ويفكر فيه ويبدعه، وما يقوم به من نشاط وما
يكتسبه من تجارب، وما يختزن من موروث، انطلاقا من قيـم ومبـادئ يومن بها ويمارسها
في سلوكه وفق أسلوب معين في الحياة.
وهي تختلف من حيث طبيعتها باختلاف المجتمعات، إن كانت
منغلقة على نفسها أو منفتحة على غيرها، وكذا إن كانت موحدة ومتجانسة، أو متسمة
بالتنوع والتعدد. كما أنها تختلف من حيث قدرتها على التعايش أو التنافر، وعلى
التحدي والصمود أو الانسياق والذوبان، سواء حين تحتك مع مثيلاتها أو الأقوى منها
أو الأضعف.
ومع ذلك، فإن لكل ثقافة - مهما يكن مستواها - إمكانات
ذاتية للحفاظ على مقوماتها في إطار البيئة التي أنتجتها، ولتبادل الأخذ والعطاء مع
غيرها، ثم لرد الصدمات التي تواجهها من ثقافات أخرى تحاول الهيمنة عليها إذا ما
اضطرت لذلك.
في إطار مثل هذا التفاعل – لا سيما في خطه الإيجابي -
يمكن تصور الحوار إذا ما توافرت له شروطه وظروفه. وإذا هي لم تتوافر يحدث الصراع
الذي كان واجهة لمعظم الحروب. وحين أقول "واجهة"، فلاعتباري أن الدافع
الرئيسي كامن في المصالح والرغبة في المحافظة عليها وتوسيع دائرتها والانفراد
باستغلالها. ويكفيني التمثيل لذلك بالحروب الصليبية التي كانت تتستر خلف حماية
مسيحيي الشرق، ولكنها في الحقيقة كانت تسعى إلى توسيع نفوذ الممالك اللاتينية.
ومثلها الحروب الدينية في فرنسا بين الكاثوليك والبرتستان خلال القرن السادس عشر،
فقد كانت بسبب خلافات سياسية حول حركة الإصلاح يومئذ.
ويبقى سؤال تنقلني إثارته إلى المحور الثاني من هذه
المحاضرة - وسأمر سريعا عليه - ويتعلق بالكيفية التي تم
بها ذلك في الماضي ؛ مما يبرز أهمية استحضار التاريخ الذي عرف حضارات سادت بعطائها
وتفتحها على غيرها، ثم بادت حين انغلقت وفقدت توازنها. وتكفيني الإشارة إلى
الحضارة الهندية واليونانية، ثم البوذية والهندوسية، دون إغفال السريانية والبابلية وإفضائها إلى اليهودية
والزرادشتية، وكذا إفضائها مع الإغريقية إلى الحضارة المسيحية، ثم العربية
الإسلامية التي كان لها أكبر تأثير على الحضارة الغربية الحديثة.
وما أحوجنا
إلى أن نبرز أن حضارتنا العربية الإسلامية - وهي وريثة حضارات سبقتها - أتيح
لها من الاتساع ما تسنى لها به أن تنتشر وتتسع على العالم يومئذ، وذلكم بفضل
شموليتها وتفتحها واستنادها إلى منظومة من القيم الإنسانية. ولعلنا في غنى عن
التذكير بما كان لهذه الحضارة من تألق وازدهار، ليس فقط داخل الأقطار العربية
الإسلامية ولكن خارجها كذلك، مما كان يصل إليه نفوذها، على حد ما تحتضنه بلاد
الأندلس، مما ينهض دليلا ماثلاً للعيان على العطاء الغني الذي تعتز اليوم وتفتخر
به إسبانيا والبرتغال وتستثمرانه كذلك. ومعروف أن الأندلس كانت أهم معابر الحضارة
العربية الإسلامية إلى سائر الأقطار الأوربية.
وشبيه بهذا ما يتصل بالحضارة الأوربية الحديثة التي
انطلقت من الموروث العربي الإسلامي، والتي تتسرب ظواهرها المادية وتستهلك على أوسع
نطاق، وفق ما نعيش الآن، مع التحولات التي تعرفها هذه الحضارة بحكم التطورات
والمستجدات العالمية.
وإذا كانت كثير من المجتمعات الإنسانية اليوم تفيد من
هذه الحضارة ولو على حساب كثير من موروثاتها المحلية، فإنها مع ذلك تظل مصرة على
التشبث بثقافتها أو ثقافاتها ؛ وإذا ما أحست أن هذه ستمس أو تداس، فإنها تنهض
للصراع.
وبالنسبة للتجربة المغربية، فإن عدم التنافر الثقافي هو
الذي مكن للفنيقيين الذين دامت فترتهم ألف عام ؛ وهو الذي أتاح للإسلام أن ينتشر
ويستتب منذ أربعة عشر قرنا. في حين كان الوجود الروماني مرفوضاً لاتسامه بالروح
الاستعمارية، ولسعيه إلى نشر الدين المسيحي واللغة اللاتينية. ومثل هذا يمكن أن
يقال بالنسبة لفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني الذي كان المغاربة - انطلاقاً من
ثقافتهم بكل مكوناتها - يرفضونه ويقاومونه، داعين إلى التضحية بما حمل من مظاهر
حضارية مادية - ولو محدودة - وداعين كذلك إلى التخلي عن منجزاته إلى درجة مقاطعة
بعض سلعه الجديدة. وهو موقف صدامي يبرز مدى دور الثقافة في إحداث الصراع وتشكيله.
وبالانتقال إلى المرحلة المعاصرة - وهو ما يجعلني أثير
المحور الثالث والأخير - يمكنني أن ألفت النظر إلى ظواهـر ثلاثة تواجه الإنسانيـة
جمعـاء وتواجه معها أزمة أو أزمات:
1 - فهناك
تقابلات في الخريطة الحضارية قائمة على تصنيفات أبرزها: شرق - غرب، وشمال - جنوب،
مع إهمال دول أسيوية عظمى لها شأنها.
2 - ثم
هناك إشكالية العولمة.
3 -
وهناك كذلك قضية الإرهاب وإلصاقها - ظلماً وعدواناً - بالعرب والمسلمين، على الرغم
من الطابع العالمي الذي تكتسيه، وعلى الرغم كذلك من معرفة أسبابها المباشرة وغير
المباشرة.
وليس يخفى أن المنطلق في هذه الظواهر والهدف منها كذلك
يلخص في الهيمنة ووحدة القطبية، مما يُبلوره النظام العالمي الجديد، أي العولمة
التي لا اعتراض لنا عليها من حيث المبدأ، لأن الإسلام سبق إليها، وهو دين ينادي
بالعالمية لكن دون أن يتدخل في الهويات. هذا مع العلم أنه لا تخفى بعض إيجابياتها
من حيث تطوير التقنيات وتكنولوجيا المعرفة، وكذا في الجانب الاقتصادي والتجاري
والتسويقي، مع ملاحظة العراقيل التي تحول دون صادرات الدول النامية مما كشفه مؤتمر
سيتيل عام 1999. إلا أن سلبياتها مع ذلك
كثيرة، وتبقى عائقاً دون إيجاد عالمية حقيقية سليمة. فهي تريد فرض قيم ثقافية - أي
هوية - على الآخرين، والأدهى من هذا أنها تعتبر أخذهم بها مؤشراً على مدى
استعدادهم لبلوغ الرقي والتقـدم، وتعتبر تلك القيم كالسلع التجارية التي يمكن تصديرها واستيرادها؛ وإن كنا ندرك أنه
في جانب القيم يوجد ما هو مشترك، مما تمثله القيم الإنسانية المتفق عليها كالصدق
والأمانة والحرية والعدالة وما إليها مما هو معروف.
صحيح أن التكنولوجيا الإعلامية عملت وتعمل على اختراق كل
الحواجز، وعلى تسويق المبادئ والأفكار التي يزيد الاحتكاك بينها، وسيزيد في
المستقبل أكثر، بفضل ثورة الاتصال وانتشار تكنولويجا المعلومات، ولكن ليس إلى الحد
الذي يراد لها عند البعض، بإدماج الهويات
-
والثقافات على الخصوص - وإعطاء مفهوم جديد للمواطنة تصبح به مواطنة عالمية ويصبح
معها الوطن هو العالم ؛ مما فرض مواجهة هذا النفوذ الهادف إلى الإلغاء، أي إلغاء
الآخرين على أساس التفوق عليهم، وفرض كذلك بذل الجهود لجعل الهويات بمقومها
الثقافي تنفتح لتكون قادرة على هذه المواجهة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأوربيين في سياق هذه
المواجهة ينادون بالاستثناء الثقافي، وأن العرب والمسلمين يتشبثون بهويتهم
الثقافية التي نشأت متمحورة حول الدين ومتأثرة به ومنسجمة معه، معتبرين أنه إذا ما
حورب هذا الرباط فإن الهوية ستنهار ؛ في حين أن الهوية الغربية قامت على العكس
بعيداً عن الدين وفي تصادم معه. وهذا لاشك عنصر خلاف ومثار سوء تفاهم بيننا وبينهم.
ولعلنا ألا ننسى الموقف من انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، بسبب الهوية عامة -
والدين خاصة - مع أنها جغرافياً جزء من أوربا.
كما تجدر الإشارة إلى أن
الإحساس بالهوية والتمسك بها مع ما ينم عنه من روح وطنية، يبدو قويّاً إلى حد بعيد
في الولايات المتحدة الأمريكية التي تريدنا أن نتنكر لهويتنا. وقد أتيح لي أن
أزورها وأحضر إحياء الذكرى الأولى لأحداث 11 سبتمبر، فعجبت لشيوع هذا الروح متمثلاً في مظاهر كثيرة، كانتشار حمل
المواطنين للراية، وترديدهم الجماعي للأناشيد الوطنية وغيرها، إضافة إلى الاعتزاز
بالخصوصيات المحلية، على نحو ما لاحظت عند الأميش في بنسلفانيا وأوهايو، وكذا عند
الهنود الحمر ومدى التجاوب العام مع شعائرهم الاحتفالية وغيرها، حتى في العاصمة واشنطن.
والأسف شديد أن الولايات المتحدة بعد هذه الأحداث وجهت
كل طاقاتها لمهاجمة المسلمين، غافلة عن حقيقة الإسلام وعن الروابط التاريخية
والمصالح التي لها معهم، وغافلة قبل هذا وبعد عن عدم وجود ما يعكر صفو هذه الروابط
من عقد تعانيها أوربا معهم، كالحروب الصليبية والاستعمار.
أما بعد، فاستناداً إلى ما سبق، أستخلص أنه يمكن قيام
حضارة إنسانية، لكن بهويات مختلفة، وبعيداً عن الرغبة في أية هيمنة، ولتحقيق ذلك،
يلزم استرجاع الثقة بين المسلمين ونبذ ما بينهم من فرقة وتمزق ونزاع الذات وما إلى
ذلك من حساسيات ؛ مع الأخذ بالأسباب التي تحقق الجانب التنويري في الحداثة، بغير
تزمت أو انغلاق، ومع إعمال العقل بتفتح.
كما يلزم استرجاع الثقة بينهم وبين غيرهم - لاسيما الغرب
- بهدف التعايش، انطلاقا من حوار حقيقي وصادق وليس الحوار الاحتفالي أو التبشيري
الملغوم. والتعايش يقتضي الاعتراف بالآخر، أي بحقه في أن تكون له هويته، وأن يعبر
عنها ويمارسها ويعيش بها، في اعتراف بها وبقدرتها على أن تساعد أصحابها على
الانخراط في بناء العالم، أي المساهمة في الحضارة المعاصرة.
وليس هذا فحسب، ولكن ينبغي كذلك تنبيه الأوربيين إلى
ضرورة التحالف مع العرب والمسلمين لحماية الحضارة الإنسانية التي ازدهرت في حوض
المتوسط، وفي إطار توازن يحمي مصالح مختلف الأطراف. وحتى يتحقق ذلك، لابد من العمل
على تجاوز الهوة الفاصلة بين الشمال والجنوب، لاسيما بين ضفتي البحر الأبيض
المتوسط، والمتمثلة في الفقر والأمية والمرض.
وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالتخلي عن العقلية
الاستعمارية الاستعلائية، وعن الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة ومحاولة فرضها بغطرسة
واحتقار للآخر.
إن آفة الغرب اليوم، أنه يريد أن يعيد تجربة الماضي حين
مهد لاستعمار الأقطار العربية والإسلامية على امتداد القرن التاسع عشر وأوائل
العشرين، بحجة حاجتها إلى الخروج من التخلف الذي كانت غارقة فيه، وكذا بحجة حاجتها
إلى من يساعدها على ذلك. فهو يريد اليوم أن يفرض ليس فقط حضارته، ولكن أن يفرض
ثقافته ومقومات هويته، بدعوى مساعدتنا على التحديث. والحق أنه يريد تغيير الخريطة
الجغرافية وفق ما يحقق له مصالحه، في تركيز لسياسة استعمارية جديدة ؛ بل هو ما زال
متمسكاً بمخلفات الاستعمار القديم، على نحو ما يثبت الاحتـلال الإسبانـي لمدينتـي
سبتة ومليلية المغربيتين.
إن حقيقة هذه الآفة - وقد بلغت أوجها - أن الغرب يثير
الصدام مع غيره عبر الهويات، إذ هو يرفض قبول المجتمعات الأخرى المتشبثة بهوياتها،
والمعتزة بما كان لها من حضارة لم تندثر، ولكنها ما زالت حية وقادرة على النهوض؛
وفي طليعتها المجتمعات الإسلامية المفعمة بقوى روحية تمكنها من الصمود والمقاومة.
وهو ما يدركه الغرب ويعمل على مواجهته، مبرراً ذلك بمحاربة الإرهاب، ومتغافلاً عن
الأسباب العميقة والحقيقية لكثير من القضايا التي تعوق الأمن والاستقرار والسلم
العالمي، وفي طليعتها المشكلات القائمة في المجتمعات العربية والإسلامية، وأبرزها مشكل فلسطين.
أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأعرب عن استعدادي لمناقشة ما
ترون إبداء الرأي فيه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منظور العرب والمسلمين
للولايات المتحدة الأمريكية
(من خلال عوامل التلاقي
التباعد)
عرض
قدم في الندوة التي نظمتها جامعة المعتمد بن عباد الصيفية بأصيلة، في موضوع: "أروبا
أمريكا والإسلام" أيام
5-6-7 جمادى الثانية 1424هـ الموافق 4-5-6 غشت 2003م.

بسم الله الرحمان
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي
الكريم معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة
أصحاب
المعالي والسعادة
حضرات
السيدات والسادة
أود في
البداية أن أعرب عن كبير تنويهي بموسم أصيلة الثقافي الدولي، وهو يحيي ذكراه
الفضية هذا العام، وأن أعرب كذلك عن فائق تقديري لفعالياته الغنية والمثمرة والمتجددة
على مدى ربع قرن من الزمان. كما أود أن أعبر لأخي وصديقي
معالي الأستاذ محمد بن عيسى عن جزيل شكري وعظيم ثنائي، إذ دعاني للمشاركة في أحد
أنشطة الموسم الحالي، عبر الندوة التي تنظمها جامعة المعتمد بن عباد الصيفية في
موضوع حيوي وهام، لعله في طليعة ما يثار على مختلف السوح الوطنية والدولية، وهو
المتعلق بـ "أوربا وأمريكا والإسلام". وسوف أركز فيه على
"منظور العرب والمسلمين للولايات المتحدة الأمريكية من خلال عوامل التلاقي
والتباعد".
في
مستهل هذا العرض الوجيز الذي أسعد بتقديمه، أرى أن أوضح أن العلاقات بين المجتمعات
المختلفة، وحتى بين الأفراد داخل المجتمع الواحد، تتعرض بحكم طبيعة الحياة
ومقتضيات العوامل الفاعلة فيها، لفترات صعود وهبوط، تتحسن حيناً وتسوء أحيانا
كثيرة مخلفة بعض مظاهر التوتر والتأزم.
ذلكم
أن هذه العلاقات تتأثر بالوقائع والأحداث وما ينتج عنها من مواقف ؛ بل هي قد تتأثر
بما يصدر من هذا الطرف أو ذاك من خطاب، وفق ما يسمه من موضوعية هادئة منصفة، أو ما
يطبعه من ذاتية منفعلة منحازة.
ويمكن
القول بأن الخطاب المواكب للعلاقات العربية الإسلامية الأمريكية -
إن لم أقل الصانع لهذه العلاقات - متنوع المشارب ومتعدد الدرجات،
بين ما هو سياسي أو عسكري أو ديني أو أكاديمي أو إعلامي، دون إغفال ملمحه الشعبي
المعبر عن فكر الرأي العام وانطباعه، سواء في هذا الجانب أو ذاك.
وغير
خاف أنه توجد بين الدول العربية والإسلامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية،
روابط تاريخية وصلات متشعبة، تكاد - لما بينها من تشابك -
أن تكون مطبوعة بالتعقيـد، إلى
درجة
أنه
يصعب
الحسـم
فيها لمجـرد الاستناد إلى حـادث أو موقف.
وما
يقال عن هذه العلاقات التي تربط بين أمريكا ومجموعة الدول العربية الإسلامية، يقال
كذلك عن العلاقات الثنائية التي تجمع بين أمريكا وأية دولة من هذه المجموعة، مع
التفاوت الموجود بين هذه الدولة أو تلك وبين الولايات المتحدة.
لو
طرحنا السؤال عن هذه العلاقات وكيف هي ؟ لألفينا أنها خاضعة في جانب منها لمنظورنا
نحن العرب والمسلمين لأمريكا.
ومن
غير أن أذكر بالروابط التاريخية التي لنا مع الولايات المتحدة منذ استقلالها، لا سيما
والمغرب كان في طليعة الدول التي أشادت بهذا الاستقلال ونوهت به، فإنه يمكن الجزم
بأن منظورنا إليها إيجابي، إن لم أقل إنه متسم بالإعجاب والانبهار، قياسا إلى ما
كان لنا مع الدول الأوربية. ويكفي أن أذكر بعض الدوافع
لذلك وما معها من مظاهر:
1 - لم تكن لنا مع
أمريكا حروب صليبية.
2 - لم يكن لنا معها
مشكل استعمار.
3 - تقديرنا لديموقراطيتها المبكرة،
في وقت كانت توجد في أروبا حكومات أرستقراطية.
4 - تقديرنا -
نتيجة ذلك - لموقفها من حقوق الإنسان، بدءاً من حرية المواطن.
5 - إكبارنا لمساندتها
حركـات التحـرر، ولا سيما
ما كان لهـا من دور تحريـري في أوربا أثناء
الحرب العالمية.
ومن ثم لم يكن غريبا
أن تتجه أنظار أجيال الشباب العربي والمسلم لهذا البلد، فينكبوا تلقائيا على تعلم
لغته، ويهاجروا للدراسة فيه أو العمل، سواء بإقامة دائمة أو موقتة.
وهو ما تحقق بتوفيق وسداد لأولادي أصلحهم الله، إذ تسنى لهم بعد إتمام تعليمهم
العالي، أن ينخرطوا في سلك أساتذة هذا التعليم بجامعات
أمريكية مختلفة.
وقد
تسنى لي شخصياً قبل ذلك أن ألمس الكثير من دوافع الإعجاب، أثناء الرحلة الأولى
التي قمت بها للولايات المتحدة الأمريكية عام واحد وثمانين وتعسمائة وألف، تلبية
لدعوة في إطار برنامج فولبرايت، والتي أتاحت لي زيارة معظم الجامعات التي تعنى
بالدراسات العربية والإسلامية، بدءاً من واشنطن ونيويورك في الشرق إلى أقصى الغرب
في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.
وقد
استخلصت من هذه الرحلة التي هي عندي مدونة في نحو مائتي صفحة، أن المجتمع الأمريكي
مجتمع طيب تسوده قيم سلوكية، وصفتها يومئذ بأنها هي القيم الإسلامية الداعية إلى
الانضباط والاستقامة.
وهو
نفس الانطباع الذي تأكد لي أثناء الزيارة الأخيرة التي قمت بها للولايات المتحدة
في الصيف الماضي، وهي محررة كذلك في سفر مماثل. وفيها تسنى لي حضور
إحياء الشعب الأمريكي للذكرى الأولى لأحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقد كان هذا الحضور فرصة كشفت لي مدى قوة الروح الوطنية لهذا الشعب، وكذا شديد
تمسكه بهويته على ما فيها من تنوع وتعدد.
وإنه
ليكفيني في هذا العرض أن أستعيد ما كنت سجلته بهذه المناسبة، من انتشار حمل
المواطنين بافتخار لعلم بلادهم ورفعه على أبواب منازلهم، وترديدهم الجماعي
للأناشيد الوطنية وغيرها في مختلف التجمعات ؛ إضافة إلى اعتزازهم بخصوصياتهم
المحلية، على نحو ما يلاحظ عند الأميش في بنسلفانيا وأوهايو، وكذا عند الهنود
الحمر، مما يدل على كبير تجاوبهم مع شعائرهـم الاحتفالية
وغيرها، حتى في العاصمة واشنطن.
إلا أن
هذا المنظور العربي الإسلامي المفعم بمشاعر الإكبار والتقدير، سرعان ما داخلته
عناصر تشويش كادت أن تقلب هذه المشاعر وتحولها إلى أحاسيس
ضيق وتبرم، إن لم أقل إنها لا تخلو من كره بدت أولى معالمه قبل ذلك، مع تأزم
العلاقات إثر هزيمة سنة سبع وستين وما تلاها من أحداث.
ويرجع
هذا التحول إلى أسباب، من أهمها:
1 - موقف أمريكا من
القضية الفلسطينية، ومساندتها المطلقة لإسرائيل.
2 - تجاهلها للدور
الكبير الذي كان للمسلمين في مساعدتها على مواجهة الشيوعية والقضاء عليها.
3 - اتهامها لهم - ظلماً وعدواناً -
بالإرهاب وبما حدث في حادي عشر سبتمبر.
4 - حرب العراق بهدف القضاء على أسلحة الدمـار الشامـل،
في حين أن إسرائيل تمتلكها، والتساؤل
حول احتلال العراق الذي لن يكون سهلا، وأنه قد يكون - إن نجح -
مطية لتنفيذ مخططات أخرى تهم هذا البلد ودول المنطقة، بهدف التشتيت والتمزيق وفق
خارطة جديدة.
والجدير بالذكر أن هذه الأحاسيس لا تبدو مقصورة على العرب
والمسلمين، إذ هي تكاد أن تكون عامة.
فمرة خطب الرئيس جورج وولكر بوش
وقال متسائلا، وربما مستغرباً كذلك: "لماذا
يكرهنا العالم مع أننا شعب طيب ؟".
والحقيقة
أن هذا الشعور - في ملمحه العام - بدأ يتجلى واضحاً
مع ظهور تيار العولمة، ثم لم يلبث أن تنامى وتقوى مع توالى الأحداث في جميع أنحاء
العالم، يحس به الضعفاء، مثلما يحس به الذين ينافسون أمريكا أو يتطلعون إلى منافستها
في القوة، حتى من هم لها حلفاء.
وهو
شعور يطغى عليه الانبهار - إلى حد الهلع والحذر -
بقوة الولايات المتحدة، والدور التحريري الذي كان لها في أروبا أثناء الحرب
العالمية، وكذا إثر قضائها على الشيوعية. غير أنه شعور ممزوج
بشيء من الاستنكار والإدانة، وذلكم منذ حرب الفيتنام، بل منذ ألقت أمريكا قنابلها
الذرية في اليابان على مديتني هيروشيما وناغازاكي، حيث قتل نحو مائتي ألف من
الأبرياء، وتبعهم مئات الآلاف من الذين ظلوا يعانون عواقب هذا القذف الذري.
تضاف إلى ذلك المواقف اللاديموقراطية التي اتخذتها أمريكا تجاه دول وأنظمة في آسيا
وأمريكا اللاتينية، بهدف مواجهة الشيوعية.
وإذا
كان هذا الموقف في عمومه - والأروبي منه بصفة خاصة -
قد تقوى مع تيار العولمة كما أسلفت الذكر، فلإن هذا التيار ارتبط بمحاولة الولايات
المتحدة الأمريكية فرض نظام عالمي جديد. وهي في ظل هذا
النظام تتأرجح بين رفض وجود أوربا متحدة وقوية، وبين قبول هذا الوجود، شريطة أن
تبقى أمريكا هي الأقوى. هذا في وقت ترفض الـدول
الأروبية هذه الهيمنة الأمريكيـة، في اعتزاز بثقافتها
وتقاليدها وتاريخها.
ومع
ذلك، فإن ما يبدو في الساحة من مظاهر الخلاف بين الولايات المتحدة وهذه الدول،
إنما هو موقت وعارض، وناتج عن بعض ما يثيره الاقتصاد العالمي من مشكلات، ولكنه في
جميع الأحوال، لا ينم عن تأزم سياسي أو فكري عميق يمكن أن يؤثر على الأواصر
المتينة التي تجمع بينهما منذ اكتشاف العالم الجديد، والتي ما زال الحلف الأطلسي
أبرز جامع لها ؛ دون إغفال الرباط المسيحي وماله من تأثير قوي في هذا المجال.
ثم
جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتغدي ذلك الموقف الاستعلائي وتنميه، من خلال
منظور أمريكي تبسيطي للعالم بمختلف مشاكله وقضاياه، يكاد يكون فردي الاتجاه، بل هو
كذلك بالفعل، إذ يركز على الإرهاب، وكأن هذا الإرهاب هو جماع تلكم القضايا
والمشاكل، دون تمييز بين الإرهاب كجريمة، وبين المقاومة كحق مشروع لرد الاعتداء.
كل هذا
جعل الولايات المتحدة تبيح لنفسها أن تتحكم وتفرض قراراتها، مؤكدة زعامتها لعالم
أحادي القطبية، وساعية إلى الحيلولة دون قيام أية قوى أخرى منافسة؛ مع السماح
لنفسها بشن ضربات تراها وقائية، بغض النظر عن عواقبها، وفي غير اكتراث بهيئة الأمم
المتحدة وميثاقها.
وهي
تصرفات تبدو متناقضة مع ما كانت الولايات المتحدة تراه إزاء ما ارتكبت أروبا من
أخطاء، أبرزها:
1 - شن الحربين العالميتين.
2 - ظهور النازية والفاشية والشيوعية.
3 - استعمار الشعوب العربية والإسلامية.
مهما
يكن، وعلى افتراض أن إحساس الكراهية قائم، فإنه – ولا سيما
بالنسبة للمسلمين - نابع من موقف سياسي ومعبر عنه، أي ليس بأي حال
ناتجاً عن موقف ديني كما قد يتوهم البعض، لأن الإسلام دين محبة وتسامح ومودة
وتعارف، ولأن غير المسلمين في معظم أنحاء العالم يكنون الإحساس نفسه ويعلنونه،
رفضاً منهم للطغيان وحب الهيمنة، وما ينمان عنه من شعور متسم بالعدوان.
وهو شعور يوجد داخل الولايات المتحدة، متمثلاً في تيار يغري بمعاداة
المسلمين، يشجع عليه ويريده أن ينتشر.
إلاّ أنه يبقى تياراً غير ذي وزن، إذا ما اعتبرت صفات الطيبة والهدوء وسلامة الصدر
وما إليها مما يطبع شخصية المواطن الأمريكي إلى حد البساطة.
وعلى
الرغم من أن بعض تقارير إدارة البحوث والدراسات في مجلس العلاقات الإسلامية
الأمريكية، تشير إلى أن أجهزة المخابرات تلاحق المسلمين وتراقب أنشطتهم وترصد
مصادر أموالهم، كما تشير إلى بعض مظاهر التضييق عليهم وعلى منظماتهم حتى ولو كانوا
من غير المهاجرين، أي مواطنين أمريكيين، فإنه يبدو أن الأمر قد خف بعد أن هدأ
الروع مما حدث.
فقد
حكى لي غير قليل من المسلمين أنه وقعت بالفعل تصرفات هجومية على بعض المساجد
والمؤسسات الدينية في بعض المدن الأمريكية، قام بها مباشرة بعد أحداث سبتمبر غلاة
مندفعون، ولكن لم يلبث سكان الأحياء التي توجد بها هذه المساجد والمؤسسات، أن
سارعوا - وهم غير مسلمين - إلى جمع التبرعات
لترميم ما أتلف وتعويض ما ضاع، مع تقديم الاعتذار عما وقع.
ولا شك
أن من شأن مثل هذا السلوك الحضاري المتسامح، أن يلطف أجواء التباغض والتنافر، وأن
يخفف من شدة التأزم، إن لم يمحها ويحولها إلى عكسها لتعود إلى أصلها المفعم
بالصداقة الحاثة على حفظ المصالح ومزيد التعارف والتعاون؛ مع استحضار دائم أن
المصالح العليا لأمريكا هي التي تتحكم في اتخاذ القرارات الحاسمة، بعيداً عن
العواطف المجردة
والصداقات التقليدية والآراء الشخصية.
والحق
أنه بهذا المنظور، يتحتم على العرب والمسلمين أن يتعاملوا مع أمريكا، ليس بتلك
العواطف والصداقات، ولكن انطلاقا من المصالح المتبادلة القائمة على ما يتمتعون به
من ثروات ومواقع استراتيجية ؛ مما يقتضي إقناع الولايات المتحدة بأن مصالحها -
في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال - يمكن أن تحفظ
بالتعاون مع الـدول العربيـة، أكثر مما هي
محفوظة مع إسرائيل التي قد تصبح - بل لعلها أصبحت -
عنصر ضيق لأمريكا، بفعل العصابات واللوبيات المتحكمة في اقتصادها وإعلامها
وثقافتها، وفي سياستها على العموم. ومع ذلك، فإنه يبدو أن التقارب
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يتجاوز مجرد توافق المصالح، ليتخذ طابعاً دينياَ
تعكسه المسيحية الصهيونية في صيغة تهويدية للولايات المتحدة. وهو
ما يتجلى واضحاً في الاتجاه الإنجيلي المتسم بالأصولية والتطرف، وبالعداء السافر
للعرب والمسلمين.
وعلى
الرغم من أن بعض العرب والمسلمين يشكون في ذلك، أي في العودة الإيجابية للعلاقات
العربية الأمريكية عبر المصالح المشتركة، فإنه توجد بوادر دالة على إمكانه وعلى
تحسين هذه العلاقات، أبرزها بادرتان اثنتان:
1 - موقف أمريكا الحالي من القضية الفلسطينية، المتمثل في خطة الطريق الرامية إلى وقف الاستيطان
الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولـة فلسطينية مستقلة ؛
وإن كان هذا المشروع يحتاج إلى تفعيله، بل إحيائه ونفض الغبار عنه حتى يمكن تحقيقه
وتطبيقه في الواقع.
2 - إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودول
عربية وإسلامية في أفق العشرية الحالية، مما قد يكون له أثر كبير على تحسين الأوضاع
الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لهذه الدول؛ ما لم يظهر عجز
الاقتصاد الوطني فيها عن مواكبة مقتضيات سياسة التبادل الحر، لا سيما
من حيث المزاحمة الإنتاجية والتسويقية وما إليها من تحديات، قد يكون العنصر البشري
نفسه - بإمكاناته المحدودة - غير مؤهل
لمواجهتها، فضلا عن التغلب عليها ورفعها.
إن من
الإنصاف للذات والآخر، أن نعترف بأنه قد تحقق لأمريكا من القوة والتفوق ما رشحها
لتتبوأ في الفترة الراهنة مقعد قيادة العالم، وتكون لها فيه الكلمة الأولى والقرارات
الحاسمة، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو
الثقافي. وهي بذلك - وبسلوك استعلائي -
تريد فرض نموذجها على الجميع، أقوياء كانوا أو ضعفاء.
وإن
على العـرب والمسلميـن أن يسعوا -
في غير انهزام ولا استسلام ولا يأس - إلى اكتساب
المقومات التي تؤهلهم، ليس فقط للاقتراب من هذا النموذج، ولكن لامتلاك أدواته
كذلك، بما يمكنهم من إحداث التغييرات اللازمة لتحقيق الإصلاح الشامل الذي يتطلعون
إليه. وهو ما لن يتسنى لهم إلا بجملة شروط، منها:
1 - المثابرة على العمل الجاد والإنتاج المثمر.
2 - التوسل بالبحث العلمي والتكنولوجي.
3 - السعي إلى تجديد الفكر وتطوير النظم.
4 - العمل على توحيد الكلمة.
ويبقى
بعد هذا أن على المسلمين كافة – ولا سيما الموجودين منهم
في أمريكا، سواء باعتبارهم أفراداً أو أعضاء في منظمات غير حكومية -
أن يقووا الروابط مع مختلف مكونات المجتمع المدني الأمريكي، عبر الجامعات والهيآت
الثقافية
والمؤسسات الإخبارية، إضافة إلى الأحزاب
السياسية والبرلمانات. ولاشك أن مثل هذه الروابط ستمكنهم من أن يقدموا
صورة صحيحة عن الإسلام، من خلال البرامج الإعلامية والكتب والمحاضرات والندوات
وكذا من خلال السلوك، مما يزيل من ذهن الأمريكيين وهْم إلصاق تهمة الإرهاب
بالمسلمين، ويساعد على التوعية بحقيقة هذا الدين الذي يشهد له المنصفون من غير
معتنقيه، وحتى خصومه. فقد تحدث عنه الرئيس بوش في خطاب تهنئة بشهر
رمضان الماضي، ألقاه في حفل إفطار أقامه بالبيت الأبيض، حضره سفراء الدول
الإسلامية ورؤساء جالياتها، فوصفه بأنه "دين يجلب الأمل والراحة لما يزيد عن
بليون مسلم في كل أنحاء العالم، وله الآن أتباع من كل الأجناس البشرية، كما أنه
أنتج حضارة غنية قامت على التعليم والأدب والعلوم. وها نحن اليوم نحتفي
بتقاليد هذا الدين العظيم من خلال استضافة هذا الإفطار في البيت الأبيض".
أشكر لكم حسن
إنصاتكم،
والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته
صـراع أم حـوار؟
بل هو حوار ... ولكن
ألقي
هذا العرض في الندوة التي عقدها مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات بتعاون مع
معهد العالم العربي في باريز من 22 إلى 25 شعبان 1424هـ الموافـق 20-22 أكتوبر 2003م.
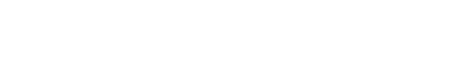
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسائر
النبيئين
والمرسلين.
أصحاب
المعالي والفضيلة والسعادة
حضرات
السيدات والسادة
يسعدني
أن أحضر هذه الندوة الثانية التي يعقدها مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات،
بتنسيق مع المعهد العربي في باريس، والتي يدار موضوعها حول "الإسلام والغرب:
تأثر وتأثير" ؛ في غير قصد لاقتران الإسلام الذي هو دين، بالغرب الذي هو
مجموعة دول. ولو صيغ العنوان على هذا النحو: "العالم
الإسلامي والغرب ..." لكان أوضح وأسلم، لا سيما
والأمر يتعلق بتبادل التأثر والتأثير.
وكما
هو مسطر في البرنامج، فسوف أقدم عرضاً متصلاً بالمحور الثاني لهذا الموضوع، وهو
المحور الذي طرح فيه السؤال: "صـراع
أم حـوار؟". وعلى النحو الذي
يبرزه عنوان هذا العرض الذي أسعد بتقديمه استهلالاً نظريا لعروض المحور، فإني لم
أتردد في الإجابة عن هذا السؤال، إذ جعلتها كالآتي: "بل هو حوار ...
ولكن ...".
ويتضح
من هذا العنوان، أن العرض قسمان :
في الأول
أوضح أن الحـوار يفرض نفسه باعتباره المسـلك الصحيـح
لمواجهـة كل اختلاف.
وفي الثاني
أثير اعتراضاً أو شبه اعتراض، مفاده أنه إذا كان الحوار هو المسلك الصحيح، فإنه
لكي يتحقق على نحو إيجابي يحتاج إلى شروط.
نعم هو
حوار وليس صراعاً، لماذا ؟
لن
أتحدث عن حوارية الإسلام، ديناً وفكراً وممارسة، فذلكم جانب سال فيه مداد غزير،
وتسنى لي شخصياً أن أنجز فيه أكثر من بحث، وهو لديكم معروف؛ ولكني سأشير إلى
جوانب أخرى تحتم حواراً يبدو اليوم أكثر إلحاحاً والعالم يجتاز أزمات عصيبة، بعضها
- إن لم يكن جلها - يمس المسلمين.
ومنذ
البدء، أقول إن مثل هذا الحوار يتطلب تحديد طرفه الآخر ؛ أي مع من يكون الحوار؟
سيقال إنه مع الغرب - كما هو واضح من عنوان الندوة -
ولكن أي غرب يُقصد وما هو؟ هل هو كتلة واحدة وموقف واحد؟ أم كتل شتى ومواقف
متعددة؟ ثم هل سيتم الحوار مع جميع مكونيه وسائر اتجاهاته؟ أم مع مكون واحد واتجاه
معين؟ وإذا كان فما هو؟ هل هو أمريكا؟ أم أروبا؟ أم آسيا؟ وهل مع هذه أو تلك
برمتها، أم مع بعض دولها؟ وهل بعد هذا يمكن أن تُذكر إسرائيل باعتبارها ربيبة
الغرب في الشرق، على الرغم من اعتدائها المتوالي وعدائها المكشوف؟
من هذا
المنطلق، وطالما أن الحوار يفرض نفسه، فأي اعتبار يمكن أن يُعطى لما
يراه صمويل هانتيجتون في "صراع الحضارات" من أن الصراع الآتي سيحدث بين
الغرب الممثّل في أمريكا وأروبا من جهة، وبين الصين والعالم الإسلامي من جهة أخرى؟
مع أن التاريخ أثبت أن الحضارات لم تكن تتصارع، ولكنها كانت تتفاعل وتتعاقب؛ ولم
يكن يثير الصراع في الغالب سوى تباين الثقافات وما يكون من تشبث فيها بمقومات هوية
معينة، وما تغري به من مصالح أو رغبة في بسط النفوذ.
وأي
اعتبار كذلك يمكن أن يعار لما يذهب إليه فوكوياما في "نهاية التاريخ"،
من أن التاريخ بلغ أوجه في النظام السياسي الغربي الأمريكي، وفي الديموقراطية
الليبرالية واقتصاد السوق، وأن أمريكا بمكانتها ينبغي أن تحقق هيمنتها على العالم؟.
ولعلي
هنا أن أذكر بأن الصهيونية العالمية أخذت تعمق فكرة
المواجهة مع العالم غير الغربي ؛ أي بالدرجة الأولى مع العرب
والمسلمين الذين تضعفهم التفرقة، لا سيما وأن هذه
المواجهة لا تستهدف الصين، أو هي في الواقع تستبعدها موقتاً لمكانتها وقوتها،
مع
العمل على محاصرتها. وهو ما سيتيح للغرب - وأمريكا بالذات -
هيمنة وسيطرة على مناطق البترول وما تحتله هذه المناطق - أو معظمها -
من مواقع استراتيجية.
الحقيقة
أننا في عصر العولمة التي أزالت الحدود، ويسرت إمكانات التواصل بين الأفراد
والشعوب
والحضارات والثقافات. وهو ما لا يمكن أن يتسنى إلا بالإقرار بجملة
مسلمات، من أبرزها وحدة الجنس البشري، وتكامل البناء الحضاري والثقافي الذي هو إرث
مشترك للإنسانية؛ مع الإشارة إلى أن التنوع الحضاري والثقافي إغناء لهذا البناء،
وإلى أن الناس داخل هذا التنوع، في حاجة إلى التعارف وتبادل الأخذ والعطاء.
وذلكم
ما يحتم الحوار الذي كان دائما موجوداً، حتى حين يكون غير مباشر، أو حين يتخذ
ظاهره الصراع. وبفضل هذا الحوار الصريح أو
المضمر، شاعت على امتداد التاريخ قيم إنسانية، واتسعت آفاق الحياة البشرية على
مختلف الأصعدة.
إنه لا
أحد يشك في أن الحياة المعاصرة بتطوراتها المختلفة والمتلاحقة، تثير تغيرات كثيرة،
سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية وثقافية واجتماعية، تشيع التباسات عديدة متبادلة،
وتثير اضطرابات في المفاهيم والمقومات، وتبعث في النفوس قلقاً لا يلبث أن ينعكس
على معاملة الذات والآخر.
وليس
من شك في أن الدين - وسأعود إلى الحديث عنه - لما له من قيم
ثابتة وعطاآت متجددة، وبما أراد الله أن يكون له من تأثير في البشر، يمكن أن يكون
عنصر تهدئة وتطمين، وسلاحاً لمواجهة سلبيات العصر، ودواءً لمعالجة
الكثير من الأمراض المتفشية فيه، وسبيلا إلى نشر العدالة والأمن والسلام بين
الأفراد والشعوب ؛ لا سيما مع وجود ديانات متعايشة في كثير من البلدان
المعنية بهذا الحوار، مما يدل على ما بينها من روابط توحي بإمكان التقارب.
لذا،
فإن الحوار مع الغرب لا ينبغي أن يستبعد عنصر الدين، ظناً بأن الدين قد انتهى في
الغرب. والحقيقة أنه لم ينته، ولكن انتهت أو كادت حدة الخلافات
المذهبية التي كان الغرب يعانيها، ربما بفضل التقدم العلمي، أو بسبب إدراك خطر الآخر
؛ وإن كان المسلمون لم يتغلبوا على هذه القضية بعد، على كثرة الجهود واللقاءات
التي عقدت وتعقد للتقريب بين المذاهب، ولإجراء حوار إسلامي إسلامي.
أخـواتي إخـواني
هو إذن
حوار وليس صراعاً، أو هكذا ينبغي أن يكون. ولكن هذا الحوار
يقتضي جملة شروط:
1 - الاعـتراف بحرية
الآخر وحقه في الاختيار. أقصد هنا بالنسبة للمسلمين - وهم
الطرف الأضعف - حقهم في أن يختاروا ما يلائمهم من حضارة الغرب وثقافته.
وحين
أقول حضارة الغرب وثقافته، فإني أقول كذلك الحداثة وما بعدها.
وحتى يعرفوا ما يلائمهم، ينبغي أن يتيحوا لأنفسهم فرصة التعرف إلى تلكم الحضارة
والثقافة، وهذه الحداثة في جوانبها الإيجابية ؛ إن لم أقل ينبغي أن تتاح لهم هذه
الفرصة، لأن الأمر لا يتعلق فقط باقتصاد وتجارة ومظاهر مادية، ولكن قبل هذا وبعد
بأفكار ومشاعر.
وتجدر
الإشارة إلى أن المسلمين - عبر الأفكار
والمشاعر - تعاملوا مع الحضارات التي احتكوا بها خلال التاريخ،
وكذا مع الحضارة الغربية المعاصرة، على الرغم من موقفها، أي موقف أصحابها منهم.
وكان المسلمون في السابق - ومن موقع الطرف الأقوى -
يعملون على إحداث التوازن مع الآخر، والحفاظ على هذا التوازن.
وهو ما أعطى للحضارة الإسلامية تألقها وإشعاعها. ولعل هذا هو ما
تفتقده الحضارة الغربية اليوم، بنهجها سياسة الفرض والإجبار، ومعها سياسة الإقصاء
والإلغاء.
2
- قبول التعامل معه - أي مع الآخر - سواء أكان متفقاً مع الطرف
المحاور له أو مختلفاً معه،
في الجنس أو اللون أو الدين، أو ما يرتبط بذلك كله من معرفة
وثقافة وسلوك، مع الالتزام بهذا القبول باحترام وبفكر واقعي، وبمعرفة صحيحة؛ مع توسيع الأفق
وإزالة الأوهام المشاعة عنه.
وذلكم
ما يتطلب إدراك حقيقته، وبذل جهد للتغلب على الجهل به فضلاً عن تجاهله.
كما يتطلب تجنب تشويهه، وعـدم الاحتراس منه أو التخوف،
مهما تكن درجة الاختلاف معه؛ وكذا عدم استصغار شأنه مهما يكن ضعيفاً.
ولاشك أن مثل هذا
السلوك يفضي إلى عدم إلصاق المآسي التي تعانيها البشرية اليوم به، أو بالدين الذي
ينتمي إليه. كما يفضي إلى البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف
هذه المآسي، ولا سيما ظاهرة التطرف والإرهاب.
وهي أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، قبل أن تكون معزوة إلى الدين الذي
تقلص للأسف مفعوله في التربية والتعليم والثقافة، تحت وطأة الاستعمار الغربي
للبلاد الإسلامية، وما صاحب هذا الاستعمار أو نتج عنه من تسرب مذاهب وإيديولوجيات
معادية للدين أو تكاد؛ وإن كان - ومنذ سنوات غير قليلة -
يعيش
صحوة تحتاج إلى ترشيد حتى لا تتعرض لأي تشويه أو تحريف.
3 - مع هذا السلوك، يلزم
التخلي عن سياسة الاستعلاء، وعن الوهم بامتلاك الحقيقة، والتخلي نتيجة ذلك عن
احتقار الآخر ؛ مما سيؤدي حتماً إلى الاعتراف به وبثقافته وقيمه، وقبول الجلوس معه
حول مائدة الحوار، بجميع مجالات هذا الحوار السياسية والاقتصادية والثقافية
وغيرها؛ دون التهيب من طرح الأسئلة الصعبة، أو التحرج من إثارة بعض المشكلات
المعقدة والقضايا المتأزمة المزمنة، ولكن في لجوء إلى المصارحة، وعون على إيجاد
الحلول، واقتناع بأن الآخر ليس خصماً أو عدواً.
4 - ينبغي ألا يقتصر الأمر على الاعتراف بالآخر، ولكن ينبغي كذلك
مساعدته وإعانته - إن كان معوزا - على حماية موروثاته
الحضارية والثقافية، واكتساب ما يغنيها من جديد؛ مع الرغبة الصادقة في تبادل
التجارب معه والأخذ والعطاء، وفي البحث عن القواسم المشتركة، لتأسيس أرضية صلبة
للحوار. وهو ما يعني إقامة جسور مع الآخر، تخفف من حدة الاختلاف
معه، وتدعو إلى الاستفادة منه. وقد تُمكن من الاتفاق معه على
مجموعة من القيم للنهج عليها، بدءًا من حقوق الإنسان الأساسية.
كما تمكن من إشراكه في اتخاذ القرارات الحاسمة، وفي مواصلة بناء الكيان الإنساني،
وفي مواجهة الأخطار والتهديدات التي تنذر بانهيار البشرية.
إن
الفرق كبير بين أن تكون جماعة ما واحدة متفردة بإدراك الحقيقة واتخاذ القرار
وفرضه، وبين أن تكون هذه الجماعة مشتركة في ذلك مع غيرها، متعاونـة
ومتآزرة ومتكاملة.
5 - مع الاعتراف بالآخر
ومساعدته، يلزم تبادل الاحترام معه، بكل ما يقتضي هذا الاحترام من تقدير وتوقير
وتكريم واعتبار، وكذا الإشادة بما له من مكانة، وإبداء الرغبة في
الاقتراب منه، والانفتاح عليه، والسعي إلى مزيد من التعرف إلى آرائه وأفكاره
وخصائصه ومزاياه، للاقتباس منها والتقوّي بها ؛ مع انتفاء كل محاولة -
كما أشير من قبل - للاستصغار أو الاستهانة، فضلاً عن الاحتقار
والاعتداء، وما قد يترتب عن هذا السلوك الاستعلائي من أحكام مسبقة مهينة، ترى أن
كل ما عند الآخر أو هو متصل به سيء وغير صالح، يستوجب عزله وتهميشه، ثم القضاء أو
الهيمنة عليه.
وعلى
الرغم من أهمية الحوار مع طرف مماثل - أي الحوار الذاتي
كالحوار الإسلامي الإسلامي مثلاً - فإن الحوار غالباً ما ينصرف
عند الحديث عنه، إلى طرف مخالف يقتضي في أولى مراحله معرفة هذا الطرف، في الجانب
أو الجوانب التي يراد فيها محاورته، إن كان ديناً أو حضارة أو ثقافة، أو غير ذلك
مما يكون إطاراً للمحاورة؛ مع العلم أن هذه الجوانب وما إليها تشكل مجالا أو
مجالات للاختلاف قد تمس الفكر والقيم، ومع اعتبار هذا الاختلاف وما ينتج عنه من
تنوع وتعدد ، ظاهرة بشرية رافقت الإنسانية
في جميع مراحلها، منذ خلق الله الكون والإنسان، وجعل الاختلاف فيهما وفي متعلقاتهما من آياته،
على تعدد درجاته واتساع دوائره. وقد بين تعالى كيف ينبغي أن
يتم التعايش داخل هذا الاختلاف بالتعارف، حتى لا يقع التصادم.
ومع أن
التاريخ أثبت أن هذه الظاهرة كانت تفضي أحيانا إلى التنازع وإلى المواجهة التي قد
تتطور إلى صراع وحتى إلى شن الحرب، فإنه أثبت كذلك أنها كانت في الغالب تحث على
التفاهم والتفاعل، وعلى الاقتباس والإبداع والتنافس فيهما، وأنها بذلك حققت التطور
الذي عرفته البشرية.
6 - لعل من أبرز أسباب الاختلاف، ما يكون متصلا
بالدين، مما يستوجب العودة في هذا العرض إلى إثارة المسألة الدينية.
فغير خاف أن الاختلاف في الدين والعرق بانعكاساتهما الحضارية والثقافية، وما لها
من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، كان كثيراً ما يشكل أساساً لمعظم الصراعات
البشرية، أو يتخذ وسيلة لتبرير هذه الصراعات وإضفاء الشرعية عليها.
هذا مع
العلم أن الدين - وقد غدا اليوم بِجهلٍ واجهة للصراع -
يستدعي مراجعة فهم الناس له ولقيمه، وتصحيح ما الصق به من تحريف، حتى يعود له دوره
الكبير في إزالة عوامل التوتر والصراع، وفي إشاعة التفاهم وإحلال السلام ؛ مع
الدعوة إلى أن يطبق كل أصحاب دين قيمه بصدق، قبل أن يبحثوا عن القيم المشتركة مع
غيرهم.
إن
الدين من حيث هو – ولا سيما في صيغته التي
اكتملت بالإسلام - يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وإلى المحبة والعدل
والسلام، وإلى التآزر والتضامن، وإلى تحقيق رسالة الإنسان في الكون بحمل الأمانة
التي عرضها الله تعالى على أعظم مخلوقاته، فأبت حملها وحملها الإنسان.
ثم إن
الحاجة ماسة في ظل التطورات العالمية الجديدة وما رافقها من دعوة لعولمة تحاول أن
تحتوي كل شيء، إلى أن يعار كبير الاهتمام للجانب الإنساني في الحياة، بما يُكونه
من دين وفكر وثقافة. وهو ما يستوجب إعادة النظر في الموقف من الدين،
لاستعادة دوره وبعث رسالته على نحو صحيح، باعتباره مقوماً للحياة والسلوك، وفاتحاً
لآفاق النمو البشري، وليس وسيلـة تستغل لتحقيق هدف معين، فضلاً
عن أن يكون هذا الهدف غير سليم ؛ وباعتباره كذلك أداة تطوير وتجديد وتقدم، وليس
أداة تخلف وتأخر وانحطاط. كما أنه إلى جانب هذا
الاعتبار، ينبغي الاقتناع بصلاحية الدين لمعالجة كثير من الأدواء التي تعانيها
البشرية اليوم.
وتحقيقاً
لهذا الهدف وغيره مما يعين الدين على إدراكه - وهو كثير -
يتحتم تجنب تعميق ما بين الأديان السماوية من فوارق، بأن يُركز على ما بينها من
اتفاق في الأصل، بعيداً عما بينها في الفروع من خلاف لو لم يكن موجوداً لكانت
ديناً واحداً.
وينبغي
إلى جانب هذا، أن يعتبر الحوار في هذه الأديان، حوار حياة لا حوار عقيدة ولاهوت ؛ وذلكم
بتحويله إلى فعل في هذه الحياة، لاسيما بالنسبة للإيمان والسلوك، مما قد لا يُحتاج
معه في سياق الحوار إلى محاولة تعميق العمل على التقريب بين الديانات.
على أن التعامل مع الدين أو غيره من مقومات الكيان، يقتضي اللجوء باستمرار إلى
النقد الذاتي، لتصويب أخطاء الاجتهاد وهفوات الممارسة، وتصحيح نهج المسير.
أما
بعد هذا كله، وحتى يعطي الحوار الإسلامي مع الغرب المسيحي ثماره، فإنه ينبغي العمل
على تنقية الذاكرة وتصفية النفوس من رواسب الماضي، بأن تقدم الكنيسة اعتذارها
للمسلمين عن الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش ؛ وذلكم على غرار الاعتذار الذي قدمته
لليهود في قضية المحرقة، وكذا حين صرح البابا بأن المسيحيين لم يكن لهم الموقف
اللازم ضد النازية، ثم حين دعا قداسته إلى تعديل العهد الجديد وتجريده من كل ما
يمس اليهود ؛ دون أن ننسى احتفال الفاتيكان بالذكرى الخمسين لقيام إسرائيل، في وقت
تعمل هذه على تدمير الشعب الفلسطيني المدافع ببسالة عن أرضه وحريته وكرامته.
أشكر لكم حسن
إنصاتكم
والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته.
التجديد الثقافي
أول شروط التغيير الشامل
الهادف إلى الإصلاح
عرض
قدم في الندوة التي عقدتها الإيسيسكو يوم الخميس 19 شوال 1425هـ، الموافق لـ 2 ديسمبر 2004م، حول موضوع: " ثقافة
التغيير بين التأصيل والتجديد "، في إطار المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الفكر
العربي، بمراكش خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2004م تحت عنوان: "
العرب بين ثقافة التغيير وتغيير الثقافة ".
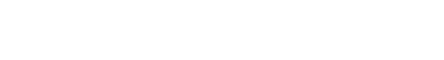
بسم الله الرحمان
الرحيم
الحمد لله رب
العالمـين
والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب
المعالي والفضيلة والسعادة
الأخوات والإخوة الأساتذة
حضرات
السيدات والسادة
بابتهاج
كبير وسعادة غامرة، أحضر وأشارك في هذه الندوة القيمة التي تعقدها المنظمة
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ضمن برنامج المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الفكر
العربي، والذي يتناول قضية كبرى لعلها أولى القضايا التي تواجه عالمنا العربي
والإسلامي في المرحلة الراهنة، ألا وهي المتعلقة بالتغيير الذي يتطلع إليه، وما
للثقافة من دور كبير وحاسم في تحقيقه.
وذلكم
ما جعلني أقترح لمساهمتي في هذا اللقاء الهام موضوعاً ينصب على التجديد الثقافي
باعتباره أول الشروط التي يقتضيها التغيير الشامل الهادف إلى الإصلاح.
أصحاب
المعالي والفضيلة والسعادة
الأخوات والإخوة الأساتذة
حضرات
السيدات والسادة
التغيير
- لغة - يعني الإتيان في الشيء بما
يعارضه أو يضاده ويناقضه. وهو مصدر فعل "غيّر"
الذي يأتي بمعنى بدَّل وحوّل. وقد يكون من حال حسنة إلى أخرى
قبيحة، كما قـد يكون علـى عكس ذلك مـن
وضع سيئ إلى آخر أفضل.
وفي
سياق المعنى الأول الدال على تبديل النعمة بالنّقمة، وردت
الآية
الكريمة
التي يقول فيها الحق سبحانه: "ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم"(1). ومثلها التي يقول فيها عز وجل:
"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"(2).
والتغيير
- اصطلاحاً - هو التبدل الذي
تتعرض له مختلف البنى الاجتماعية، والذي يمس جميع أنواع الفاعليات وما يرتبط بها
من التزامات تقتضي إعادة النظر في الوسائل والإمكانات وكيفية استعمالها وتوظيفها.
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يكون جزئياً، بل لابد أن يكون شموليّاً وكليّاً حتى ولو
بدون قصد إلى ذلك، لأن أي تغيير يحدث في بنية ما من المجتمع، ينعكس تلقائيا على
بقية البنيات.
وقد
يقع بالتدريج، أو فجأة على نحو ما يحدث في الثورات. كما قد يكون
إرادياً مستجيباً لشروط وأسباب وتطلعات داخلية، أو لا إرادياً غير نابع من النفس
والكيان نتيجة عوامل تفرض من الخارج ؛ مما غالباً ما يحدث له رد فعل من الداخل.
وفي أحيان غير قليلة تكون الدوافع إليه مشتركة بين الذات والآخر.
ولعل ذلك هو ما يُواجهه العرب والمسلمون اليوم.
ومع
هذا، فإن التغيير ليس سلعة تستورد، ولا عملية فورية وبنت لحظة معينة ينتهي
بانقضائها، ولكنه يخضع لاستمرارية قد تطول، ويتطلب هضماً سليماً وصحيحاً للمعطيات
المختلفة، محلية وإقليمية ودوليّة، بكل ما يشكلها من شعارات وأفكار ورؤى ومواقف
تلزم بالانفتاح عليها. ويحتاج قبل هذا وبعد إلى اعتباره إحدى ظواهر سنة
الوجود وطبيعة الحياة، وإلى تجاوز الأهواء الخاصة والمصالح الذاتية في اللجوء إليه
أو مواجهته. والسـبـب أنه قد يصادف من
يقاومه، نظراً لما كان اعتاده وألفه في خشية من التخلي عنه أو الخروج عليه.
كما أنه قد يقبل في غير هذه الحال، لاسيما إذا ظهرت مصداقيته، أي مصداقية الداعين
إليه والعاملين على تحقيقه. وغالباً ما يزيد الإقبال عليه
والتحمس له حين تبدو بعض نتائجه الإيجابية، مثلما يرفض إذا ما ظهر عكس ذلك.
وبتأمل واقع أقطارنا العربية والإسلامية، يلاحظ أن دوافع
ضرورة التغيير والتطلع إليه عديدة ومعقدة ؛ لعل أبرزها عدم الرضى عن الواقع
المتخلف الأليم بكل مشكلاته وتحدياته الداخلية والخارجية، والحاجة في الآن نفسه
إلى تبديل هذا الواقع، وإن في غير انزعاج يائس منه، مع بعث الأمل في النفوس، من
خلال محاولة التوفيق بينه وبين التطلعات العاطفية التي لا تخلو من صدق وإخلاص، أي
من خوف حقيقي على الذات والكيان من التفتت والضياع، في سعي للحفاظ على ذلكم الأمل،
ليس فقط لكي يعيش ويبقى مهما يكن نوع هذا البقاء، ولكن في نمو وتطور وتجدد.
وإذا
ما تحقق هذا الأمل، فإنه لاشك سيساعد على الخروج من حال القلق والحيرة والتيه أمام
الأزمات المتراكمة وما تحدث من هزات وصدمات، لا تلبث أن تحدث عقداً نفسية من شأنها
إذا لم تُحل أن تؤدي إلى يأس قاتل. وهو وضع مستبعد بسبب التفاؤل
الناجم عن ظهور وعي جديد بين الأجيال المختلفة، نتيجة إدراك الحقائق والشعور
بمرارتها، وكذا بحكم الاتصال الوثيق بالعالم المتقدم، والانتباه إلى كثير من مظاهر
الاغترار التي استبدت بنا، وجعلتنا نغمض أعيننا عن جوانب ضعفنا، وما نعانيه تجاه
ذاتنا المريضة، وتجاه الآخر الذي تفوق وغدَا يتحكم.
وذلك
كله يدل على أن عوامل مادية ونفسية كثيرة تكمن خلف الحاجة إلى التغيير، وأن هذه
العوامل أفرزت خللاً قد يصيب القيم والمقومات، بما يحدث من تناقضات متعددة
المظاهر،
وربما
صراعات
بين
الفئات داخل المجتمعات، وما
ينتج عنها من فقدان التوازن الذي لابد منه لأي مجتمع سليم، والذي
ينبغي أن يتحقق بإشراك الجميع، وأن تبرز تجلياته في مختلف المجالات السياسية
والاقتصادية والثقافية، وهذه بالذات، لاسيما حين يكون الجمود الفكري في عمق أسباب
التخلف.
لذا،
وبغض النظر عن كل المفاهيم التي تعطى للتغيير، انطلاقا من رؤى فكرية فلسفية
مختلفة، فإنه يمكننا القول بأن التغيير يحدث أو تقع الحاجة إليه نتيجة ما يكون في
المجتمع من تناقضات، وتحت ضغط تحديات أو تطورات داخلية أو خارجية تحث على إيجاد
وضع جديد قد يتسم بالواقعية أو المثالية ؛ ولكنه في جميع الأحوال يتوق إلى التقدم
لا إلى التأخر، أي يتوق إلى تغيير يكون وسيلة للإصلاح أو الطريق إليه.
والإصلاح
ضد الإفساد، وهو مشتق من الصلاح الذي هو كل ما فيه خير ونفع أو ما
يؤدي إليهما. كما أن الإفساد مشتق من الفساد الذي هو كل ما فيه شر
وضرر أو ما يفضي إليهما. والإصلاح بهذا هو رد الشيء
الفاسد صالحاً. ويكون إما بالتطوير، أي تطوير عناصر الصلاح، وإما
بالتغيير، أي باقتلاع عناصر الفساد واجتثاثها من الجذور.
وهو أقوى من التطوير وأبعد أثراً منه. وتعتبر الثورة على
الفساد أعلـى درجات الإصلاح حين لا يتسنى ذلك بأسلوب هادئ سليم.
وقد تقدم أن الحاجة إليه تظهر حين يتم الشعور بالفساد ومعاناته، وحين توجد الرغبة
في إزالته. أما حين لا تكون الرغبة مع وجوده واستفحاله، إما قصداً
أو جهلاً، فتلكم لاشك أعلى درجات الفساد وأخطرها، إذ تقترن إذ ذاك بالمكابرة أو
انعدام الوعي.
وينبغي للإصلاح - حتى يتحقق على النحو الصحيح - أن يمس جانب الذات بمراجعتها
ومعالجة أدوائها وعدم الإصرار على بقائها فاسدة، مع التركيز على المجتمع عن طريق
توعيته بالإصلاح ودعوته إليه وإلى المساهمة فيه. ونقصد بالمجتمع كل
ما يشكله وجميع ما يتعلق به وبتسيير أحواله وتدبير شؤونه، سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية، ودينيـة كذلك، في سعي إلى الوسطيـة
والاعتدال، وبُعد عن أي مظهر للغلو والتشدد.
ومحاولة
منا في هذا العرض الوجيز أن نقرب الصورة الصحيحة للإصلاح، فإنا نرى إثارة جملة
أسئلة نعتبر الإجابة عنها أقرب السبل إلى تمثل هذه الصورة.
ولعل
أول ما يثار في هذا المضمار، سؤال عن مدى وجود فكر إصلاحي،
أي مدى توافر قدرات وإمكانات لصياغة هذا الفكر ؟ وإذا كان فأين هو ؟ ولماذا لم
نوفق لحد الآن في تحقيق الإصلاح ؟
نعم، إنه لا أحد يجادل في أن لنا رصيداً هائلاً من محاولات
الإصلاح بدأت منذ القرن التاسع عشر، وحتى قبله، لاسيما في مصر والشام والمغرب،
ولكنها أجهضت، مع اختلاف مستويات هذا الإجهاض، فكان أن أفضت إلى الفشل.
من هنا
يمكن وضع السؤال الثاني عن كيفية الإصلاح اللازم ؟ ومن غير أي تمحن في الرد، نبادر
إلى القول بأنه لكي تكون هذه الكيفية صحيحة وايجابية، لابد من أمور أهمها ثلاثة:
أولاً: تحديد رؤية فكرية
واضحة لهذا الإصلاح تبرز
منظوره وتخطط له.
ثانياً: وجود
إرادة سياسية قابلة للتغيير.
ثالثا:
تهيىء وسائل تنفيذ هذه الرؤية وما تخطط له.
هنا
يطرح سؤال ثالث عن الذين ينبغي أن يقوموا به ؟ ولسنا نعني أن يسند الأمر إلى فئة معينة
في المجتمع، طالما أن كل أفراده مطالبون بالإسهام فيه، ولكن نعني أنه لا يمكن بل
لا ينبغي أن يقوم به إلا الذين يهمهم أمره، أي لابد من أن ينطلق
من الذات. ومن ثم لا يتصور إصلاح يفرض أو يملى من الخارج.
والتحفز
من الذات يعني طرفين، أحدهما منوط به التصور، والثاني مكلف بالتنفيذ.
أما التصور - أي الرؤية والتخطيط - فذلكم ما يجب أن
ينهض به المثقفون، في توفيق محكم بين الحلـم والواقـع،
وبإشراك جميع فئاتهم، بعد أن تعود الثقة بينهم قبل أن تعود فيهم ؛ على أن يكون
المنظور ساعيا إلى إقامة دعائم جديدة لإشاعة العدل والمساواة والحق والحرية،
والتأهل بذلك لانفتاح سليم على العالم والتفاعل معه ومع مستجداته.
وأما
التنفيذ فيقع على عاتق القائمين بالشأن العام من مسؤولين وحكام.
وهو ما يستوجب إيجاد مؤسسات متطورة وهياكل جديدة قادرة على تسييرها، تكون متحلية
بالجدية والشجاعة والإقدام على الجديد،
في غير
تردد أمام الصعوبات المحتملة، ولكن بعدم تهوينها أو الاستهانة بها؛ وبمنأى عن أي
تجريد
أو
ارتجال،
ولكن
بموضوعية وتوسل بالأساليب الحديثة، والحث على مواصلة العمل؛ وفي تجاوب مع الهيآت
السياسية، ومع مكونات المجتمع، المدني بمختلف أفراده، حتى يتجاوبوا ويثقوا
ويُساندوا ويساهموا بحرية، ويخرجوا بذلك من اليأس والإحباط واللامبالاة، ومن حالة
الاغتراب ؛ بعد أن يكونوا قد شعروا بقيمتهم وبإمكان أداء دورهم، وبفتح المجال لهم
كي يصبحوا فاعلين مؤثرين بأعمالهم وأفكارهم التي لا ينبغي أن تبقى عندهم حبيسة
الحذر والخوف. وإن من شأن ذلك أن يتيح فرص الاستقرار الداخلي نفسياً
وواقعياً واجتماعياً، وأن يمكّن من تحقيق التنمية والازدهار.
صحيح
أن ضغوطاً كثيرة تواجه الدول العربية والإسلامية ينبغي اعتبارها، مع ما قد يكون
لها من جانب إيجابي يتمثل أو ينبغي أن يتمثل في رد الفعل، أي في تحريك الوعي
الداخلي، ولكن هناك كذلك - وقبل ذلك -
ضغوط أخرى عليها من الشعوب التي أصبحت متعطشة للإصلاح الذي تراه ضرورة ملحة أمام
الإحباط العام الذي يستبد بها، والذي يضخمه تحديان اثنان: أحدهما داخلي يلح على
هذه الضرورة في استعجال لقيام الإصلاح، والثاني خارجي يريد أن يفرض منظوره لهذا
الإصلاح القائم على تعميق الفوارق العرقية والطائفية والدينية والخصوصيات
الثقافية، وعلى محاولة تقسيم للأقطار العربية والإسلامية وفق خارطة لها جديدة.
وبغض
النظر عن كون أي إصلاح لا ينطلق من مقومات الذات وقيمها الفكرية والروحية يكون
محكوماً عليه بالفشل، فإنه سيكون من العار أن يسجل التاريخ أنه وقع الانقياد
للضغوط الخارجية على حساب الطموحات الشعبية، وإن كانت الموضوعية تلزم بالاعتراف
بأنه ما كان للغرب أن يقدم مشروعه الإصلاحي دون أن يشرك من يعنيهم أمره، لولا عجز
هؤلاء المعنيين عن الإصلاح وكذا حذرهم وتخوفهم منه، ولولا تفشي ظاهرة التطرف
والإرهاب المنسوبة ظلماً وعدواناً للإسلام والمسلمين.
وحتى
لا يقع المحظور وما لن تحمد عقباه، فإنه لا مندوحة من أن يسمع الصوت الثقافي، وأن
تكون له المبادرة الصحيحة، ليس فقط لإيجاد التصور، وللإقناع الداخلي به، ولكن كذلك
لإشاعته والإقناع الخارجي به. وهو ما قد يخفف الضغوط أو
يزيلها. وذلكم حتى لا تبقى أنظمة الدول وحدها في المواجهة، إذ
ليس من مصلحتها أن تنفرد بالقرار المفترض، وتتحمل معزولة تبعاته.
وهذا
ما يستوجب استرجاع الثقة بين الأطراف المعنية، وفتح باب الحوار بينها، بقصد
التعبئة والتحالف لتحقيق الإصلاح، باعتبارها جميعاً مراكز قوة آن الأوان لتجاوز
الصراع المفتعل بينها، ولتحقيق التصالح والتآزر، وقبل ذلك الإحساس بالحاجة الماسة
إلى إحداث هذا الإصلاح، وفق اتفاق موضوعي ونزيه يكون بعيداً عن أي مؤثر كيفما كان،
سواء في سياق التحمس أو الرفض. والاتفاق المنشود لا يعني
أحادية قد تكون مفروضة في الرأي، وإن كان تحقيقها غير مستبعد إذا ما ذللت النزاعات
وأزيلت الخلافات.
ومع
ذلك، وبغض النظر عما يمكن أن يقال عن سلطة المثقفين أو استقلاليتهم عن
الدولة، فإن الذي ينبغي استحضاره والتذكير به، خاصة في هذه اللحظات الحرجة التي
نجتازها، هو أن المثقف صاحب رسالة في مجتمعه، وأن له بذلك دوراً ريادياً ينبغي أن
يعترف له به في النقد والتصحيح، والتخطيط والتوجيه.
*** *** ***
لكن
ماذا نقصد بالثقافة والمثقفين ؟
قد
يبدو السؤال بسيطاً إلى حد تجاوز الإجابة التي قد تعتبر بدهية عنه، إلا أن الأمر
على عكس ذلك، مما يقتضي بعض التوضيح لإزالة ما هو واقع من اضطراب والتباس مردهما
إلى المفهوم الذي تعطيه مختلف الفئات التي لها صلة قريبـة أو بعيدة بالثقافة.
والحق
أن الثقافة منظومة متكاملة يتداخل فيها الوعي مع المعرفة في مختلف أنماطها
وأشكالها، ومع عدد من القيم التنويرية والأدوات المسعفة في الفعل الذي تكون له قوة
وتكون له مصداقيـة، ثم تكون له فعاليـة، أي تأثير إيجابي،
سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.
لذا،
نرى أن الحاجة ماسة إلى توسيع دائرة الثقافة والمثقفين، ليس فقط للابتعاد عن ضيق
الأفق المعرفي، ولكن كذلك بدون تحيزات وما تؤول إليه من إقصاء للمخالفين في الفكر
أو الرأي على العموم، وفي التوجه السياسي على الخصوص.
وإذا
ما تحقق هذا المفهوم ووقع الاقتناع به بين من يعنيهم الأمر، أصبح ممكنا إبداع
ثقافة جديدة متحررة من التناقضات مع الذات والآخر، ومن سلبيات التراث، ومن الإغراق
في الخصوصيات المحلية، ومن شتى التشنجات التي تعتمل في النفوس.
وإن من
شأن مثل هذه الثقافة المتخلصة من الرواسب المتراكمة والمؤثرات المثبطة، أن تصوغ
خطاباً هادئاً وموضوعياً ومقنعاً عن طريق التنوير المشع، والتوعية الصحيحة
بالتحديات وبالخلل الذي يعانيه المجتمع، في غير ضغط أو محاولة لاحتكار الرأي
والقول ؛ ومقنعاً كذلك بضرورة الإصلاح باعتباره مطلباً وطنياً ملحا يهم الجميع،
تحفزاً من النظر إلى الواقع وإلى المستقبل، باعتدال لا يبالغ في التشاؤم أو
التفاؤل ؛ وبانسجام يراعي ما هو وطني، وما هو ممتزج به من روح قومي عربي إسلامي.
وبهذا
يتاح للمثقف أن يَخرج هو ويُخرج غيره من التيه الذي تعيش فيه الأنظمة والشعوب.
كما يتاح له أن يتحول من مشكل وعائق، إلى أداة ناجعة لحل جميع الأزمات ومواجهة
مختلف التحديات، وليس الاكتفاء بالوقوف أمامها بتهويل وتباك وعجز.
وسيتسنى إذ ذاك وضع مشروع تحديثي يبدأ بالبحث عن أسباب إخفاق
محاولات الإصلاح السابقة، وتقديم قراءة جديدة لها تعتمد النقد الموضوعي للفكر
الإصلاحي بمختلف توجهاته، ولاسيما ذي النزعة الدينية التي يبدو أنها كانت في السابق
أكثر انفتاحاً وتوسطا وأقل تعصباً وتشدداً، مما هو رائج في الساحة الحالية من
أفكار ذات توجه إسلامي، إذ كانت في بعضها متطلعة داخل نزعتها الدينية إلى الاقتباس
من الغرب، والاستفادة من تقدمه الحضاري والثقافي وما حققه في مختلف المجالات،
وخاصة
منها السياسيـة والاقتصادية.
ولعل
ذلك أن يكون الخطوة الأولى للقيام بنقد ذاتي يساعد على إدراك أخطائنا وعوامل فشلنا
وظروف تخلفنا، وعلى مراجعة ما هو رائج بيننا من آراء ومواقف وممارسات سياسية
وفكرية، في ضوء التحولات الحضارية والثقافية المعاصرة، وما أصبح النظام العالمي
الجديد يفرضه بتجاوز مرحلة الحداثة ؛ في مراعاة للمعطيات الذاتية، ومع توضيح
المفاهيم ومراجعة ما يتصل منها بالقيم والمقومات ؛ سواء ما كان منها مرتبطا بالدين
أو التاريخ أو الموروث الشعبي، أو التراث على العموم، للإبقاء على الصالح منها
والحقيقي، وإغنائه وتطويره وإلغاء ما سواه.
وذلكم
ما يستوجب تحرير العقل، ثم تنظيم فعله والتخطيط لعمل بنيوي أساسي، في إطار
المتطلبات الوطنية والتطلعات العربية والإسلامية، وكذا الأهداف الإنسانية، مع
إدراك واعٍ لموقعنا في التاريخ وفي العصر، وفي ما نتوق إليه في المستقبل القريب
والبعيد.
*** *** ***
وبعد،
فإننا إذا كنا نسعى إلى صياغة ثقافة جديدة، فلإننا نعاني على الصعيد الثقافي
تخلفاً يعوق المجتمع عن مواكبة التطورات والتغيرات التي تعرفها أصعدة أخرى مادية،
تقنية وصناعية وما إليها، مما أصبحنا نعيشه الآن متجليا في تطور المعلوميات.
ولا شك
أن تجاوز التخلف يقتضي تغيير الرؤى والأفكار، وما يرتبط بها من نظم اجتماعية
وغيرها، وتبديلها بأخرى تكون مبنية على رؤية بعيدة للمجتمع كيف نريده
وكيف ينبغي أن يكون، دون أي تشويش أو خلط أو تمويه أو تزييف.
وإذا ما تحقق ذلك، فسيسهل استعادة الوعي واستنهاض الهمم، وتدعيم روح المواطنة
والشعور بالانتماء الحق، سواء إلى الوطن أو إلى ما هو أوسع وأرحب، بتسامح وتساكن
وتعايش، بعيداً عن أي تعصب أو تطرف. كما سيسهل تفعيل الإرادة
وامتلاك أدوات هذا التفعيل، وفي طليعتها العلم والعقل والحرية.
وهي
أدوات ستمكن من فتح قنوات للحوار مع الذات ومع الآخر، بمنظور جديد، ومنطلقات تحقق
الأهداف المرجوة، في غير رفض مسبق مطلق، وكذا في غير تساهل أو استسلام ؛
لكن مع التمييز بين الأطراف المتعددة التي علينا أن نجري معها هذا الحوار.
ولعل
هذا التوجه في جانبه الإيجابي أن يحثنا على تقوية معرفتنا بالغرب وثقافته ووسائل
تقدمه، بغية فهمه على نحو صحيح، بعيداً عن أية أحكام تعميمية تجعلنا نرفضه بإطلاق،
أو نرتمي بعشوائية في أحضانه.
إن
التغيير الذي ننشد به الإصلاح مشروع شامل، بل هو فعل تاريخي يقتضي الإيمان به
والإعداد له والتعاون من أجل تحقيقه. وإن الثقافة التي ندعو إلى إبداعها،
باعتبارها مفتاح هذا الإصلاح، هي ثقافة أصيلة ومتفتحة، وقادرة على التصحيح
والتوجيه والتأطير والتجديد.
ولاشك
أنها ستكون مؤهلة لذلك، إذا ما التأم المثقفون كافة والتحموا، وأخذوا
مبادرة تبدأ بتخليهم عن موقع المتفرج اللامبالي أو الساخط، وكذا عن موقع المنتظر بأمل
كاذب أو يأس مميت.
شكراً لكم
والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته.
(1) سورة الأنفال - الآية 53
(2)
سورة
الرعد – الآية 11
أي مستقبل عربـي في ظل
ثقافة التغيير ؟
عرض
مرتجل قدم في الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للفكر العربي، الذي انعقد بمراكش من 18 إلى 21 شوال 1425هـ الموافق للفترة من 1 إلى 4 دسمبر 2004م.

بسم الله وبه نستعين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدي صاحب السمو
الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي.
الأخوات
والإخوة أعضاء هذا المؤتمر الموقر
حضرات
السيدات والسادة
أرجو
في البدء أن تأذنوا لي بالإعراب عن الابتهاج الكبير الذي يخامرني شعوره العميق،
وقد طُلب مني في آخر لحظة أن أشارك في هذه الجلسة التي تختتم بها أشغال مؤتمرنا
الحافل، والتي سيدور موضوعها حول سؤال هام هو: "أي مستقبل عربي في ظل ثقافة
التغيير ؟".
ولست
في حاجة إلى أن أبرز أنه سؤال كبير، وأن وضعه في حد ذاته يعد أمراً إيجابياً،
وسيجعلني أعرض أسئلة أخرى فرعية وتكميلية ؛ إذ لا تخفى أهمية إثارة الأسئلة، لما
تدل عليه من وعي وتطلع وتحفز لكشف الحقائق، ولا سيما الغامضة منها أو الخفية، أو
التي قد يتجنب الحديث عنها في بعض الأحيان.
وتمهيداً
لتناول هذا الموضوع، أستسمح في أن أشير إلى قضية قد تبدو بدهية، وهي لاشك كذلك.
وتتعلق بالمستقبل في الزمن، أي من حيث هو جزء في الزمن. ذلكم أن الأزمنة في
الظاهر وفي المتعارف عليه ثلاثة: ماض، وحاضر، ومستقبل.
ولكنها
في
الحقيقة زمنان اثنان: ماض، ومستقبل.
والسبب أن الحاضر لا يشكل سوى لحظة خاطفة أو عابرة تكون في طي المستقبل، ثم لا
تلبث أن تصبح ماضياً بمجرد أن تمر.
من هنا
أود
أن أضع
السؤال: أية قيمة لهذا المستقبل ؟
لن
أتردد في القول بأن المستقبل - من حيث هو
زمن - يبدو غير ذي قيمة، ما لم يكن محملا
بطموحات، ومفعماً بآمال، ومشحوناً بتطلعات.
وإن
هذا التحميل، وهذا الإفعام، وهذا الشحن، هو الذي
يعطي للمستقبل معنى ومدلولاً. وهو الذي يبرر وجوده ويمنحه
المشروعية، أو بالأحرى يبرر وجودنا فيه، ويمنحنا الحق في أن نقبل عليه ونحياه
ونعمل فيه بلا حدود، وكأننا نمتلكه كله ونعيشه بأجمعه ؛
مصداقا للحديث الشريف الذي يقول فيه : "اعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبداً... "،
وكذا الحديث الذي أوصانا فيه عليه السلام باغتنام خمسة أمور قبل خمسة أخرى، منها:
"حياتك قبل موتك...".
انطلاقاً من هذا
المفهوم وأبعاده، يمكن طرح سؤال ثان حول المستقبل العربي. والجواب عنه يقتضي
أسئلة فرعية توضيحية، وفق ما ذكرت من قبل.
وأبدأ
بهذا الاستفسار: هل لنا في حاضـرنا منظور واضح لما
نحن عليه ؟ ثـم لمـا نريده ؟
الحقيقة
أننا اليوم في حيرة واضطراب من أمرنا، وأكاد أقول إننا في حالة نسعى فيها إلى
تشخيص لوضعنا، ولمعرفة الداء الذي نعانيه، والبحث له عن الدواء الناجع.
والأسف أن هذه الحالة التي نجتازها، تعقدها الأحداث التي تفاجئنا، والتحديات التي
تواجهنا - داخلية وخارجية - مما يجعلنا في
نهاية الأمر، نعيش في تيه لا ندري كيف نخرج منه.
ثم إن
الحديث عن هذا المنظور، الذي لا نتصوره إلا كليا وشموليا متضمنا للأهداف ووسائل
إنجازها، ينبغي أن يراعي جانب الثقافة الذي هو من صميم مسؤوليتها، ولا سيما
في ملمحها التغييري الذي هو الأساس والمنطلق للتغيير الذي نتطلع إليه بهدف تحقيق
الإصلاح الشامل، والذي نريده رغم طابعه التجديدي أن يكون محافظاً على الجوهر وقائما
على الثوابت، أي نابعاً من الذات، غير مفروض علينا من الآخر.
وكما قلت أمس في العرض الذي قدمت أمام حضراتكم، فإنه
سيكون عاراً وأي عار أن يفرض علينا إصلاح من جهة أجنبية ووفق مخططاتها وأهدافها،
وأن نقبله نحن ونطبقه، وكأننا مجرد أدوات مسخرة لا رأي لنا ولا قدرة لنا على إبدائه إن وجد. والقصد عندي أن أثير الانتباه،
ولو بنقد ذاتي موضوعي ما أحوجنا إليه، بعيداً عن أي سلوك للتشفـي في الذات أو لإهانتها وجلدها
بالسوط.
بعد
الرؤية - أو المنظور - ومن بين عناصرها،
تأتي الخطة. وذلكم ما يجعلنا نضع السؤال: هل لنا خطة أو استراتيجـية
تمكـننا من بلـورة هـذه
الـرؤية
؟ والـخطـة - كالمنظور -
قضية ثقافية، أي هي مسؤولية يتحملها المثقفون.
ومع
افتراض وجود هذه الخطة، هل فكرنا في الإمكانات التي بها يتسنى تحقيقها وإنجازها،
والتي على الدولة وجميع مكونات المجتمع أن توفرها ؟
ثم،
إذا
ما
توافرت الإمكانات، فمن سينهض بالتنفيذ؟ لا نتردد في القول بأنه بحكم طبيعة الخطة -
أي بحكم شموليتها - فإن عبء التنفيذ يقع على جميع فعاليات المجتمع:
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
هنا
يثار سؤال آخر: هل ستتاح للثقافة والمثقفين فرصة وضع الرؤية والخطة ؟ وقبل ذلك هل
ستتسنى لهم فرصة التشخيص الدقيق والصحيح الذي من شأنه أن يخرج من التيه، أو يساعد
على الخروج منه ؟
ولست
في حاجة هنا إلى أن أشير بأني أقصد إلى مفهوم شمولي وواسع للثقافة والمثقفين، لا
يقتصر على نمط معين أو فئة خاصة. ولعلكم تذكرون ما قلته حول هذه
النقطة في العرض الذي قدمت أمس.
بعد
هذا كله، يبقى سؤال أخير، لعله جماع هذه الأسئلة كلها وغيرها والمبرر لها، وهـو:
هل نحن مستعدون للإجابة عنها ؟
والرد
يقتضي افتراضين اثنين:
إذا
كان بالإيجاب - وهو ما نحن مؤهلون له - فإن المنظور
للمستقبل سيكون واضحاً، رغم كل التحديات والأزمات التي نجتازها، والتي ستكون -
إذ ذاك - كالصدمات الكهربائية التي تشفي وتعالج.
وهي مرحلة أو دورة سبقتنا إليها شعوب ودول أخرى. فبتأمل حال أروبا
مثلاً، نجد أنها ما تقدمت إلا بعد أن عاشت ظروفاً أقسى مما نتعرض له نحن الآن،
ولكنها أفضت بها إلى إدراك قيمة الوحدة وأهمية التعاون في جميع الميادين.
ومثل ذلك يمكن أن يقال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت مدة طويلة
تتخبط في الحروب العنصرية، قبل أن تفهم معنى الاتحاد وتعمل لتحقيقه.
هذا
إذا كان الرد بالإيجاب، أما إذا كان غير ذلك، أي بالسلب، فإن المستقبل سيزيدنا
إغراقاً في التيه وما يفضي إليه من ضياع، وكأننا لم نأخذ الدرس من غيرنا، ولم
نستخرج العبر والعظات من كل المحن التي تعرضنا لها وما نزال.
وذلكم ما سيكون عاراً تاريخياً لا تستحقه أمتنا العربية الغنية بأمجادها، وبرصيدها
الحضاري والثقافي، وبثرواتها ومواقع أقطارها، وطاقات أبنائها العلماء والخبراء في
كل ميدان؛ أقصد هؤلاء الذين يختمرهم القلق والغضب والحسرة في
أوطانهم بسبب البطالة، أو لانعدام فاعليتهم حتى حين يسعفهم حظ التشغيل.
كما أقصد أولئك الذين يضطرون للهجرة، يفيدون بعلمهم وخبرتهم مجتمعات أخرى يعملون
على تنميتها وتقدمها، توفر لهم وسائل التفتح وأجواء الإبداع وإمكانات الإنتاج،
بقدر من الحرية والعرفان لا يتسنى لهم غالباً في أوطانهم التي أنفقت على تربيتهم
وتكوينهم، ثم تحجم عن المواصلة معهم في مرحلة هم قادرون فيها على العطاء ورد
الجميل، وهي في أمس الحاجة إليهم للنهوض والارتقاء، لو وجدت الإرادة السياسية لذلك
بكل ما تتطلبه وتقتضيه. ولعلهم -
وهم في ديار الغربة - أن يحركوا عجلة التغيير في أوطانهم التي تذكر
لأمثالهم في هذا المضمار الإصلاحي، دوراً سابقاً سجله لهم التاريخ.
ومع
ذلك، ومع كل المثبطات والعوائق المتزايدة، فإن علينا أن ننظر بتفاؤل وأمل إلى
مستقبل نُقوّي فيه ذاتنا، ونَقوَى بها وانطلاقا منها لمحاورة الآخر بقصد تجديد
معرفتنا به، والإفادة منه، والتعاون معه والتفاعل بإيجاب. وذلكم ما سيمكننا
من مواكبة وتيرة التطور السريع الذي يعرفه العالم، والذي علينا أن نشارك فيه،
بدءاً من القضايا المستعجلة التي يثيرها بإلحاح والتي علينا أن نوضحها له، وفي
مقدمتها قضية التطرف والإرهاب. على أن هناك مشكلات عديدة
نحتاج إلى بحثها مع أنفسنا ومعه، بدقة وعمق وبأدوات علمية لا مجال لاستعمالها بدون
إعادة فتح باب الاجتهاد، ولاسيما في مجال الفقه وكل ما له علاقة بالدين والحياة.
أشكر لكم حسن
استماعكم
والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته.
أهمية الثقافة العربية
في إبراز
الهوية لمواجهة العولمة
محاضرة ألقيت في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في
دورته الحادية والسبعين الممتدة من 10 إلى 24 صفر عام 1426هـ الموافق 21 مارس إلى 4 أبريل 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
كم كان أملي كبيراً، وأنا أُعد هذه المحاضرة، أن أقدم لها بكلمة عرفان
وامتنان لرئيس مجمعنا الموقر، أستاذي العلامة الدكتور شوقي ضيف الذي تفضل، وهو
يدعوني لحضور
مؤتمر المجمع في دورته الحادية والسبعين، فطلب مني أن أشارك في أعماله بمحاضرة
تتصل بالموضوع الذي اختير لهذه الدورة، وهو: "الثقافة واللغة العربية في عصر
العولمة".
إلا أن القدر المحتوم أبى إلا أن يكون التقديم كلمة عزاء، بعد أن فُجعنا
جميعاً بنبأ وفاة الشيخ الرئيس الذي شاءت إرادة الله عز وجل أن تختاره إلى جواره
الكريم، وهو منهمك في التهيئ لهذا المؤتمر.
إن رحيل رئيس المجمع المهيب وعميد الأدب العربي ومعلم أساتذته كافة، يعتبر
رزءاً جسيماً، ليس فقط بالنسبة لمصر الحبيبة وعلمائها ومفكريها، ولكن كذلك بالنسبة
لسائر الأقطار العربية وباحثيها ومثقفيها عامة، سواء منهم الذين أسعدهم الحظ -
مثلي - فتلمذوا عليه في قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعـة القاهـرة، أو الذين
درجوا في مدرسته الثرية الرصينة من خلال مؤلفاته القيمة العديدة.
فعزاؤنا واحد في هذا المصاب الجلل الذي لا نملك إلا أن نواجهه بالجَلَد
والاحتساب، داعين لأسرة الفقيد العزيز بجميل الصبر والسلوان، وسائلين العلي القدير
أن يتغمده بواسع الرحمة وجزيل الغفران، وأن يجزيه الجزاء الأوفى، لقاء ما قدم
لوطنه وأمته من عمل جليلل لن يَنقطع بما بثه في الصدور والسطور من علم نافع.
زملائي الأفاضل وإخوتي العلماء أعضاء المجمع الكرام.
حضرات السيدات والسادة
بلسان
جريح وقلب مكلوم، أعود للمحاضرة التي أقترح في نطاق الموضوع المحدد للمؤتمر، أن
أركز فيها على "أهمية الثقافة العربية في إبراز الهوية لمواجهة
العولمة".
وسأجعلها
مقسمة إلى ثلاثة محاور:
الأول عن الهوية من حيث مكوناتها وأهميتها.
الثاني عن العولمة وما لها من إيجابيات وسلبيات.
الثالث عن الثقافة باعتبارها
جماع المقومات المبرزة للهوية.
ومن خلال هذه المحاور، ولا سيما عبر المكون الثقافي، سأبرز كيفية المحافظة
على الهويـة وتقويتها، لمواجهة العولمـة، مع الحاجة إلى تغيير ثقافي، في نطاق
الثوابت الراسخة والدعائم الأساسية.
** ** **
الهوية - وتقابلها الغيرية - هي الإِنِّية والنفس والجوهر، أَي الذات بما
يلزمها ويلازمها، مما به تتأكد الماهية. وأصلها اللغوي من "هـو" الدال
على ما به يكون الشيء أو أي كائن "هو هو". وهي هنا ما به تتحقق ذات
الإنسان وشخصيته، وما يميزه عن غيره، فرداً كان أو جماعة. ونقصد بالجماعة أي تكتل
ينضوي فيه هذا الفرد، وتجمعه به قيم ومقومات تشكل وعيه وضميره وفكره وإرادته،
وتضمن وجوده الراسخ وحضوره القوي وانفعاله مع العوامل والمؤثرات، واستمراره على
مدى الحقب والعهود، مهما تكن التحديات التي تواجهه.
ويعتبر الوطن بأبعاده المكانية والزمانية، وعناصره الطبيعية والبشرية،
وأوضاعه الاقتصادية والسياسية، وأنماطه الاجتماعية والسلوكية، أحد المكونات
الأساسية التي منها تنطلق الهوية وتبدأ في التشكل.
وإن هذا التشكل ليشهد اكتماله، ذهنياً وفكرياً ونفسياً، عبر المعتقد الديني
بكل ما له من انعكاسات تجليها العبادات والمعاملات، ومختلف التصورات والمنظورات التي يتوسل بها في نطاق الذات، أو العلاقة مع
غيرها من الذوات المخالفة. وإن هذا المعتقد ليؤثر في النظم التي تتحكم في سير
الوطن وسلوك أبنائه، تحفزاً من شرائع الدين ومبادئه ومُثُله وما تُرسبه في الأفكار
والمفاهيم.
ثم لا يلبث هذا الارتباط أن يتم ويتقوى عبر اللغة التي هي أداة تواصل وعنصر
التحام، ووعاء فكر، وبوتقة ذهن، ورمز قيم، وإعلان وجود؛ مهما تكن اللهجات العامية
النابعة منها أو المعايشة لها في وطن ما قليلة أو كثيرة.
وهو ما تبلوره الثقافة في بعديها المدرسي والشعبي، من حيث هي الإرث الملخص
لما بلغه هذا الوطن في مجال المعارف والخبرات وأنواع التعبير، وما يتداوله ويمارسه
من عادات وتقاليد، وما ينفعل به أفراده ويضيفون إليه، مبرزين في كل مرحلة من
حياتهم ما لهم من إمكانات تنم عما لهم من عبقرية ومهارة.
لذا، فإن الشعور بالهوية يكاد أن يكون فطرياً في الإنسان الذي هو بطبيعته
وبحكم وجوده، يشعر بالحاجة إلى كيان يحقق به ذاته ويحصنها، ويكسبها قوة ومناعة،
ويتواصل انطلاقاً منه، ويحتمي به عند الأزمات والظروف الحالكة، لا سيما إذا واجهته
نزاعات أو صراعات.
ومن ثم، كان الحفاظ على الهوية هو الوسيلة لتعرُّف حقيقة الذات، وتحديد
قدرات الاستمرار في الوجود، وإمكانات الصمود ومواجهة التحديات.
يضاف
إلى ذلك أن الهوية بطبيعة تشكيلها وعناصر هذا التشكيل، تدخل في نطاق حلقات تتسع أو
تضيق، تجعل لها روابط مع هويات أخرى متفرعة عنها، تغنيها - أي تغني الهوية الأم -
بخصوصيات معينة ومحددة، وفق ما يكون في بيئة ما من تعدد وتنوع. كما تجعل لها روابط
مع هويات أخرى أوسع وأكبر، من خلال مكونات مشتركة.
ويمكن تصور هذه الحلقات بالنسبة للهوية المغربية أو المصرية - على سبيل
المثال - في الإطار العربي ثم الإسلامي، وكذا المتوسطي و الإفريقي ؛ مما يوصل في
نهاية الاتساع إلى هوية إنسانية. وبقدر ما يكون لأية هوية من ملامح متميزة وسمات
خاصة تتحفز منها للتعايش والتساكن، تكون قدرتها على تبادل الأخذ والعطاء، أي على
النمو والاغتناء.
وبحكم الارتباط الذي يكون للإنسان بهويته، فإن العناية بها في مختلف
مكوناتها، ينبغي أن توجه كذلك إلى المنتمين إليها ممن اضطرتهم ظروف الدراسـة أو
العمل إلى مغادرة أوطانهم، والهجرة والإقامة في مجتمعات لها هوياتها الخاصة.
إن من شأن مثل هذه العناية أن تجعل المهاجر يتمسك بهويته من جهة، ولا يحس
بالاغتراب من جهة أخرى، وأن تجعله كذلك على ثقة بنفسه، غير محتار في أمره، وبعيداً
عن كل حيرة فكرية قد تنتابه، أو نزاع نفسي قد يعانيه، وقادراً بالتالي على إبراز
شخصيته ومواجهة كل ما يمكن أن يعرضها للإهانة.
إن التمسك بالهوية حق نابع من الحق في التميز والاختلاف مع الآخر الذي
ينبغي - مع ذلك - التواصل معه والتعاون، انطلاقا من إدراك متبادل ومسؤول لهذا
الحق، والقدرة على التمتع به وممارسته.
وعلى الرغم من أن الهوية بمقوماتها تبدو وكأنها مستقرة ثابتة، أي لا تقبل
التغيير أو التبديل، فإنها باعتبارها ظاهرة فردية ومجتمعية، تخضع لمختلف العوامل
المؤثرة في حياة الفرد والمجتمع، سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ونفسية، مما تتحقق به لا شك مكتسبات جديدة. وهو ما يتم ببطء وتلقائية في الغالب، ما
لم يحدث التعرض لهزات عنيفة أو مفاجئة.
هذا ولا يخفى أن الهوية العربية الإسلامية تعاني اليوم مشكلات، وتواجه
تحديات تمس مختلف مقوماتها، بدءاً من الأوطان المهددة بالتمزق وفق خارطة جديدة، إلى
العقيدة المتهمة ظلماً وعدوانا بالتطرف والإرهاب، وكذا إلى اللغة التي ترمي
بالجمود والعجز عن مسايرة اللغات المتطورة والمتقدمة، ليصل الأمر في النهاية إلى
وصم الثقافة العربية بالتخلف والانهيار، والارتباط بالتقليد، وعدم القدرة على
مواكبة المعاصرة واقتحام مجال الحداثة فضلاً عما بعدها. وتكاد العولمة أن تكون
ملخصة لكل تلك المشكلات والتحديات.
*** ** **
إن العولمة تقترن بالعالمية
وتفيدها، ولكنها - في الصيغة التي جاءت عليها والتي هي المقصودة منها - تَعني
باتجاه أحادي محدد فرض سياسة اقتصادية وتسويقية، وكذا فرض مناهج وأفكار وقيم
وأنماط سلوك وعناصر ثقافية أخرى، أبرزها اللغة التي يراد الإلزام بها عبر
الإنجليزية التي أخذت تشيع في كثير من دول العالم، والتي يتوقع لها مزيد من
الانتشار على حساب بقية اللغات. والعولمة بهذا كله تَعني فرض هيمنة وسيادة تؤديان
إلى قطبية واحدة تتحكم في الكون بأسره.
أمام العولمة بهذا المدلول، يقف
العرب منبهرين بتقدم صانعيها والداعين إليها وما حققوا من تفـوق عسكري واقتصادي؛
ومن ثم يقفون متأرجحين بين ثلاثة مواقف:
أولها: موقف الارتياب الذي يصل إلى الرفض. ويرى
الذين يتخذونه أنهم اعتادوا مثله من جميع
ما يأتي به الغرب ويقدمه، منذ البوادر الأولى للنهضة قبل نحو قرنين. وهم في ذلك
على بعض الحق، لما عاناه العرب والمسلمون من الاحتكاك بهذا الغرب، سواء في عهد الحروب الصليبية أو في
مرحلة الاستعمار، مما جعلهم يفقدون الثقة فيه وفي التعامل معه.
ثانيها: موقف الخوف من أن تبتلعهم، في استسلام
يبدون به غير قادرين على التمييز والاختيار، وكأنهم مغلوبون على أمر واقع لا مفر
منه، مهما يكن الثمن المدفوع على مختلف الواجهات، ولو بالتخلي عن الهوية.
ثالثها: موقف الصمود الذي يدعو إلى الاندماج في
العولمة، من خلال إيجابياتها التقنية والاقتصادية،
ولكن دون التفريط في الهوية التي هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الشخصية،
والانطلاق منها للتعامل مع العالم المتقدم، إن لم يكن على مستوى الندية، فعلى
مستوى الابتعاد عن مجرد مد اليد طلباً للعون والمساعدة، مقابل التضحية الكاملة
بالخصوصيات الثقافية، أو تكييفها لتوافق مزاج المتبرع أو المتصدق.
إن العرب من خلال هذه المواقف، يشعرون لا شك بضعف موقفهم
أمام تيار العولمة، ولكنهم يشعرون - قبل ذلك وبعد - بضعف الموقف مع أنفسهم، نتيجة
استلابهم واهتزاز إيمانهم بهويتهم وبما يشكلها من قيم ومقومات، في يأس من إمكان الانخراط
في العولمة، بفكر يؤهل لقبول إيجابياتها، ويمكن من تجنب سلبياتها، ويكون قادراً
على إجراء التعديلات اللازمة التي تمنحها التوازن مع مختلف الهويات، وتكسبها بالتالي سمة الإنسانية التي تتيح
معايشتها.
إن معايشة العولمة لا تعني إدماج جميع الهويات في بوتقة واحدة هي التي
تصنعها هذه العولمة وتفرضها، ولكنها تعني البحث عما هو مشترك، أي ما يمكن أن يجمع
ويوحد، ولا سيما فيما يتصل بالقيم التي تكون ذات طابع إنساني أو بُعد فطري. وتعني
البحث كذلك عن الخصوصيات المميزة للحفاظ بها على الذات والكيان والسيادة، ثم
للانطلاق منها في التواصل مع الآخر وتبادل الأخذ والعطاء، وقبل ذلك لإزالة ما في
ذهنه حول الثقافة العربية من موقف عدائي سببه الجهل، ولكن سببه كذلك التشويش
والتشويه عن قصد وسبق إصرار.
ومن ثم، فإن التمسك بالهوية - كيفما يكن تنوعها - هو خير
سلاح، ليس فقط لمواجهة العولمة ورفع تحديها، ولكن لتحقيق تلك المعايشة. ويقتضي
إظهار هذه الهوية وإبراز قيمها ومقوماتها، في خطاب متطور جديد تكون له مصداقيته
وفعاليته وتأثيره، وينأى عن الاكتفاء بشعارات تعتمد الصخب والتهريج، مفرغة من أي
مضمون، أو كان لها مضمون ولكنه جف لكثرة استهلاكه، أو لإغراقه في المثالية
والتجريدية.
لذا، فإن العرب يحتاجون إلى أن يجعلوا لحضارتهم وثقافتهم أبعاداً جديدة،
تتجاوز ما هو تاريخي أو رمزي فيهما، وتفتح المجال لدور واقعي وفاعل يكون به لهذه
الحضارة والثقافة إسهام في تطور العالم وتقدمه.
وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا بسلوك نهج ينطلق من معرفة حقيقية بالذات في
واقعها وتطلعاتها، وما لها كذلك من سلبيات يلزم استبعادها حتى لا تشوب خطط
التنمية، وحتى لا تعطل مسير التقدم.
وحتى تتحقق تلك المعرفة وذاك المنهج، فإنه لا بد من تأمل لهذه الذات، هادئ
وتدريجي وبنفَس طويل، في غير تعجل أو تسرع لبلوغ الغايات، على الرغم من أن الوقت
لا يرحم، وكذلك التحديات التي لا تقبل طول الانتظار، فضلاً عن المواجهة بالاستسلام
والانهزام.
والسبب أن العرب اليوم يوجدون في قلب الصراع، بحكم ثرواتهم ومواقعهم
الاستراتيجية، وبحكم تمسكهم بهويتهم الدينية والثقافية، وما يواجهون من قضايا
مختلفة وتُهم توجه إليهم، كالتطرف والإرهاب وعدم الرغبة في الإصلاح أو القدرة
عليه. وهو وضع يشترك فيه المسلمون كافة، وكذا الذين يشاركونهم المواطنة من غير
المسلمين، ومعها يشاركونهم المعاناة.
وغير خاف أن الإسلام دعا إلى الارتباط بالهوية والتمسك بها، معتبراً أنها
كامنة فيه. ومن ثم حث على الائتلاف ونبذ الاختلاف. وهو ما قَرَّبَه القرآن الكريم
من خلال صورة الاعتصام بحبل الله الرامز لدينه: "واعتصموا بحبل الله جميعاً
ولا تفرقوا"(1). بل
إنه انطلق من اعتبار اختلاف الخلق - عبْر شعوب وقبائل شتى - ليدعو إلى التعارف
الدال على تبادل المصالح والمنافع؛ مما ينم عن بعد عالمي وإنساني كان الإسلام قد
سبق إليه، جاعلاً الأفضلية فيه قائمة على التقوى وليس على الطغيان: "يا أيها
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
الله أتقاكم"(2).
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الأوروبيين وحتى
الآسيويين - لما لهم من هويات متميزة بلغاتها وثقافاتها - يرفضون العولمة في شكلها
الذي يراد فرضه، على نحو ما برز في مؤتمر سيتيل أوائل شهر دجنبر عام 1999م.
وإنه لمن دواعي الاستغراب ومظاهر المفارقة العجيبة، أن تتوحد أوروبا على
الرغم من كل عوامل الاختلاف الثقافية القائمة فيها، ولا سيما من حيث الأعراق
واللغات، وأن يتفرق العرب على الرغم من التقائهم في الهوية بمقوماتها على العموم،
والثقافية منها واللغوية على الخصوص.
ولعل ما عاناه الأوروبيون - على سبيل المثال - من نزاعات وصراعات وحروب
فيما بينهم، على نحو ما تكشفه الحربان العالميتان الأولى والثانية، هو الذي جعلهم
يشعرون بضرورة التوحد، بدءاً بالتكتل الاقتصادي.
إنه بالإمكان اليسير أن يتجمع العرب في تكتل مماثل، وأن ينطلقوا من وحدة
الهوية الثقافية لإيجاد صيغ ملائمة لتوحد أوسع وأشمل، يتسنى به تحقيق الحياة
الأفضل التي تتوق إليها جميع الشعوب العربية. وذلكم ما يقتضي الإلحاح على عنصر
الثقافة.
** ** **
إن الحديث عن الثقافة في هذا المضمار - بما فيها من تراث حي وذاكرة تاريخية
غنية - يستلزم ضرورة اعتبارها، ليس مجرد مجال مترف للإمتاع والمؤانسة، ولكن وسيلة
لإثبات الوجود وترسيخ الكيان. كما يستلزم ضرورة توظيفها لإيجاد حلول ناجعة
للمشكلات، مع التوسل بها في عملية الإصلاح الذي نريده أن يكون داخلياً ونابعاً من
الذات؛ أي غير مفروض من أية جهة خارجية.
وهو ما يقتضي البدء بالاعتراف بأن الثقافة العربية، على ما كان لها في
الماضي من قوة وعطاء وقدرة على الانفتاح والتفاعل، عانت انغلاقاً شديداً على مدى
حقب الضعف والانهيار، وفرضت على نفسها - أو فُرض عليها - أن تنغلق على ذاتها، في
انطواء شديد ألزمها باجترار هذه الـذات، والبقاء حبيسة الماضـي والتـراث، ورهينة
التقليد والتكرار.
ومن ثم، فإن الحديث عن دور جديد للثقافة العربية، ينبغي أن يَعتبر روحها
المتمثل في مرتكزاتها الراسخة، ودعائمها الثابتة القائمة على أسس متينة لا شك أن
اللغة من أهمها، إن لم تكن أهمها بعد العقيدة. وهي بذلك التي تمكنها من الصمود
وتحميها من الانهيار، مهما تكن الظروف والأزمات التي تتعرض لها.
كما ينبغي أن يراعي ما يستجد فيها من مكتسبات تغتني بها، نتيجة ما لها من
طاقة إبداعية، واستعداد للامتصاص والاقتباس من ثقافات أخرى، وفق ما يلائمها ولا
يتعارض مع ثوابتها العميقة. ومن خلال هذه السمة، يتضح ما للثقافة من حيوية ذاتية،
وقدرة على الاندماج في العصر والتجاوب معه، وعلى التواصل مع مختلف فاعلياته كذلك،
عبر تبادل التأثر والتأثير. وهو ما يؤهلها في نهاية الأمر للتطور والتجدد
والاغتناء.
ولن يتاح لنا أن نحقق شيئا من ذلك، ما لم نعتبر الثقافة رأس مال ثري، وأداة
استثمار ووسيلة إنتاج ؛ وليس مجرد مجال للهروب من الواقع والانطواء على الذات -
كما سبق أن ذكرت - للتغني بأمجادها
الماضية أو اجترار آلامها الحالية.
والثقافة لا تكون كذلك، إلا إذا اندمجنا فيها، من حيث هي معرفة وإحساس
وسلوك، وقدرة على تنمية الشعور بالذات، وكذا على نقد هذه الذات، وعلى التوعية
والتعبئة بها، ثم حثها على التواصل والاستيعاب، وعلى الإبداع والإنتاج، وتأهيلها
بذلك للأخذ والعطاء، بدون أية عقد أو مركبات.
وفي هذا الإطار، ينبغي إعادة النظر بفكر اجتهادي في البعد الإسلامي لهذه
الثقافة، أي في المفاهيم الإسلامية لإغنائها وملاءمتها مع العصر، بقصد تصفيتها مما
تعج به المرحلة من ضلالات تسيء إلى المسلمين، بعيداً عن مقاصد الدين ومبادئه
القائمة على الوسطية والاعتدال، وعلى الحرية والعدل والمساواة، وعلى السلم
والتسامح والتعايش، في إلحاح على الحقوق، ولكن كذلك على الواجبات.
وحتى يتسنى ذلك، فإنه لا بد من تقوية الثقافة بمختلف علوم العصر ومعارفه،
وما جد فيه من إعلاميات حديثة ووسائل اتصال متعددة، وكذا توسيع آفاقها بالتفتح على
ثقافات أخرى - غربية وشرقية - وإيجاد قنوات للتواصل معها، والدخول معها في حوار
إيجابي من شأنه أن يقدم صورة حقيقية عن العرب، ويزيل ما علق بها من شوائب وتشوهات،
هي في معظمها من صنع الخصوم والأعداء، وإن كانت في بعضها مرتبطة بسلبيات ذاتية
تراكمت على امتداد فترات التقهقر والانحطاط.
لذا، فإننا ملزمون بالنظر إلى الثقافة التي نتطلع إليها في عصر العولمة،
باعتبار مجالاتها العلمية والتقنية التي نحن في أمس الحاجة إلى الأخذ بها، والسعي
إلى مواكبتها والإسهام فيها. ولكنا ملزمون كذلك بمراعاة سائر الميادين الفكرية
والأدبية والفنية، وما يتصل بها من معارف إنسانية لا تخفى أهميتها وما لها من دور
في إذكاء النفوس وتهذيبها، وسبر أغوارها، وتحفيزها للعمل، وتفجير طاقاتها المبدعة،
وحمايتها من الإغراق في العلم المادي وما قد ينتج عنه من سلبيات مدمرة.
ولكي تتمكن الثقافة العربية من تحقيق هذا التطوير والتجديد، فإنها تحتاج
إلى أن تسعى باستمرار لاكتساب الجديد، عن طريق الإبداع الذاتي، وكذا بواسطة الاقتباس
المبني على مدى القدرة على التمييز بين ما هو لائق ومناسب وصالح ومغن للثقافة
الوطنية، وبين ما هو غير ذلك، مما يدس في هذه الثقافة لتشويهها أو تمييعها أو
تحريفها عن خط الأصالة الحق.
وللحفاظ على هذه الأصالة، فإننا مدعوون إلى التمييز بين التراث النافع الذي
ينبغي التمسك به وإحياؤه وتطويره، وبين ما رافقه من تراكمات سلبية تثقله، يلزم
التخلي عنها، ولا سيما وهي تضخم الصورة المشوهة التي ينظر بها الآخر المتقدم إلى
العرب. وهي النظرة التي شكلها عنهم من خلال التاريخ الصليبي وفترة الاستعمار، بكل
ما في هذه النظرة من احتقار وازدراء، وكذا من تهيب وتخوف.
وإذا كانت الحاجة ماسة كذلك إلى استبدال صورة حقيقية بهذه وما معها من رؤية
غير صحيحة، فلإن من شأن هذا التغيير أن يذيب كثيراً من الخلافات وعوامل النزاع
وأسباب الصراع، وأن يقرب الخطى والمسافات، إن لم يعمل على ردم الهوة الفاصلة بينهم
وبينه، أي بين التخلف والتقدم.
وهو ما ينبغي أن تنهض به الثقافة العربية الجديدة، في
إبراز للمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، ولما تتمتع به الأقطار العربية -
كما سبقت الإشارة - من ثروات ومواقع استراتيجية، وما تمتلكه من موارد بشرية، ومن
أسباب شتى لتحقيق التنمية الشاملة وما ينتج عنها من رقي وتقدم.
والحديث عن الموارد البشرية يجر إلى إثارة موضوع الناشئة العربية التي
علينا أن ننقل إليها هذه الثقافة الوطنية المكونة للهوية، عبر التربية في المؤسسات التعليمية، ومن خلال أجهزة الإعلام المختلفة، وكذا
في البيت والشارع، وفي كل مجال تقتحمه وتتسرب إليه قيم جديدة قد يكون فيها كثير من
الغرابة والانحراف. وقد تبدو في أحسن الأحوال غير فاسدة، أي ملائمة لأصحابها،
ولكنها مخالفة للقيم النابعة من الهوية العربية.
ولعلنا في غير حاجة إلى أن نؤكد أنه لولا الثقافة، لما استطاع العرب اليوم
أن يحافظوا على ما يشد أواصرهم. وهي الأواصر التي كان يتحتم أن تتقوى بتكامل
اقتصادي وتجاري، لولا التمزق الذي يعانونه، حائلاً دون وحدتهم، والذي للسياسة في
تعميقه أثر كبير وواضح. وما أحوجهم إلى إعادة النظر في هذا الهدف البعيد المتمثل
في الوحدة، لتأملها بواقعية وعقلانية، مع مراعاة المصالح المشتركة والحقيقية، وفي
حرص عليها بالصيغة المناسبة التي لا تهدد سيادة الكيانات القائمة، بل تحميها مما
تهددها به العولمة، وما ترسم من خطط لوضع خارطة جديدة للعالم العربي والإسلامي
قائمة على مزيد من التفتيت والتقسيم.
إن المتأمل بعمق في التقدم الذي حققه الغرب في مختلف المجالات، ينتهي إلى
أن العامل الأساسي الفاعل فيه كامن في الثقافة، من خلال البحث العلمي، وما يبذله
العلماء من جهود فكرية قائمة على الخلق والابتكار، بذهنيات متفتحة، وبتشجيع من
دولهم التي أدركت قيمة العنصر الثقافي في تحقيق التقدم.
والجدير بالذكر والتنبيه، أن كثيراً من العلماء العرب المقيمين في بلدان
الغرب - سواء في أمريكا أو أوروبا - يساهمون بنصيب وافر في تحقيق هذا التقدم. وكان
بالإمكان أن يوجهوا علمهم وجهودهم فيه، لإحداث نهضة علمية وثقافية في أوطانهم، لو
تسنى لهم شيء مما يجدونه في ديار الغربة، من تقدير واحترام، ومن إمكانات مادية
ومعنوية تتيحها لهم مراكز البحث بسخاء.
والأسف أن المثقفين المقيمين بديارهم، يعانون إلى جانب فقدان تلك الإمكانات
- وبحكم عوامل سياسية واجتماعية وغيرها - تشتتا وتمزقا غالبا ما يفضيان إلى النزاع
والصراع. وهو ما يجعلهم يدورون حول أنفسهم، يجترون آلامها برؤى فردية لا تؤهلهم
لتناول قضايا المجتمع الكبرى والحقيقية، وما يعاني من مشكلات، فينتهي الأمر بهم
إلى أن يقفوا حيارى أمام الواقع المليء بالتناقضات، يتخبطون فيه وفي ذواتهم،
عاجزين عن مواجهة واعية لهذا الواقع، فضلا عن رفع تلك التحديات.
إن الحاجة ماسة إلى أن يستعيد المثقف ثقته بنفسه وإيمانه برسالته، باعتباره
حارس المثل العليا والمبشر بها، وصاحب طاقات إبداعية، سواء على مستوى العلوم
والمعارف، أو على صعيد القيم والمفاهيم وأنماط السلوك.
ومثل هذه الاستعادة للدور الذي هو منوط بالمثقف، ينبغي ألا تقتصر على ما
أَلِفه من أدوات للتعبير والتبليغ، وما يَشُد إلى الثقافة المكتوبة والشفوية، ولكن
يلزم أن تتوسل كذلك بما يستحدث من جديد في عالم التواصل الآلي، من خلال الإعلاميات
الحديثة، وما يدخل في نطاق الثقافة الإلكترونية، مع تمكن من أدواتها التكنولوجية
وتحكم فيها، حتى يخضعها لطموحه في التطوير والتجديد، وحتى لا يكون هو مجرد آلة
طيعة هي التي تتمكن منه وتتحكم فيه. وذلك ما يقتضي توظيفها، ليس فقط للتلقي والأخذ
كما هو واقع الآن، ولكن أيضا للإسهام بالعطاء، وللانطلاق منها في الحوار مع الآخر.
إننا كثيراً ما نتحدث عن الحوار، ولا سيما حوار الثقافات، ونمارسه مع غير
العرب وغير المسلمين، ولكنا نشعر بأنه يظل دائراً في حلقات من المجاملة لا تقدم
ولا تؤخر، بعيدة عن أن تغير شيئا مما ترسب في أذهان هؤلاء. وإذا تجاوزها فإنه قد
يصادف درجة ما من الصدام.
والحق أننا مطالبون قبل ذلك بحوار
عربي عربي، وإسلامي إسلامي، أي حوار داخلي نوضح فيه كثيراً من الحقائق، ونرسخ به
عدداً من الثوابت، ونزيل ما علق بهذه وتلك من شوائب وسلبيات، يزيد بقاءها في تركيز
النزاعات والخلافات التي تسيء إلينا حين تظهر على بساط الحوار مع الآخرين، وتبدو
كالحائل دون ولوج مجال الحداثة، فضلاً عما بعدها.
وتجدر الإشارة إلى أن علينا كذلك أن نغير منظورنا لهذه الحداثة التي ما
زلنا نعتبرها مبادئ وقيماً ومنجزات، نرى ضرورة اقتباسها وتطبيقها حرفياً كما هي
عند العالم المتقدم ؛ إذ يلزم تأملها بالعقل وإعمال النقد اللازم لها، والتوسل في
ذلك بمعطيات الذات التي ينبغي أن ينبع منها الشعور بتلك الحداثة والتهيؤ لدخول
عالمها والاندماج فيه والإسهام كذلك، بما يجعل هذه الذات تتطلع إلى ما بعد المرحلة
التحديثية، مسلحة بمهارات وخبرات تمكنها من مفاتيح التقدم.
وبهذا يتبين أن مسؤولية الثقافة والمثقفين اليوم، ليست في التنفيذ أو قبول
ما يفرض من جهات أخرى قريبة أو بعيدة، ولكن المسؤولية تقتضي صياغة مشروع مستقبلي
يمس جميع جوانب الحياة، سياسية واقتصادية واجتماعية وفكريــة وسلوكية ؛ تحفزاً من
إدراك حقيقي للواقع وما يعتمل فيه من قضايا العصر ومشكلاته، وإدراك كذلك لما في
العالم المتقدم من مظاهر الرقي والعوامل التي أدت إليها، ثم بعد ذلك إلى إبداع هذا
المشروع، انطلاقا من الكيان ومقوماته الثابتة وقيمه الراسخة، أي من الهوية.
إننا حين ندعو إلى الانطلاق من الهوية التي لا يكون لها وجود إلا إذا تم
التمسك بها وبجوانبها الثقافية، فلاعتبارنا أن الإنسان هو المنتج الحقيقي للتقدم،
وأن هذا التقدم لا يكون لصالحه إلا إذا كان متحكما في زمامه، وقادراً على التصرف فيه بإرادته، وعلى التعبير عنه بلسانه؛ في إطار قيمه، وفي
نطاق أمن نفسي ومجتمعي يشعر به. وذلكم ما يحتم الاهتمام باللغة العربية التي يعير
مجمعنا الموقر كبير عنايته لها، والتي ستكون بقية المحاضرات والعروض وما يعقبها من
مناقشات، مجالاً لإثارة مختلف القضايا المتعلقة بها، وبضرورة تطويرها، لتواجه
سلبيات عصر العولمة.
أشكر لكم حسن إنصاتكم.
وأجدد الترحم على الراحـل العـزيـز الذي خدم اللغة العربية وآدابها بما
يَعِز له نظير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
(1) سورة آل عمران - الآية 102.
(2) سورة
الحجرات –الآية 13
اللغة العربية :
واقع يحتاج إلى تطوير
عرض قدم في اللقاء الثاني من الندوة العلمية حول "
قضايا استعمال اللغة العربية في المغرب " المنعقد بفـاس يومي 16 و17 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 25 و26 ماي 2005م
بسم الله وبه أستعين الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد رئيس الجلسة
الموقر
سيادة أمين سر الأكاديمية المحترم
الزملاء الكرام والإخوة الأساتذة
حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن ألقي هذا العرض عن اللغة العربية من حيث واقعها الذي يحتاج إلى
تطوير، مشاركة مني في أعمال اللقاء الثاني من الندوة العلمية التي تنتظم لدراسة
قضايا استعمال اللغة العربية في المغرب، والتي عقدت أول لقاء لها قبل أزيد من عشر
سنوات(1) وهو الاستعمال الذي يعتبر
السهر على تناول مختلف قضاياه من خلال لجنة اللغة العربية، في طليعة المهام
المنوطة بأكاديمية المملكة المغربية، وفق ما ينص على ذلك ظهير تأسيسها.
*** *** ***
إن اللغة - من حيث هي - ظاهرة اجتماعية تنشط وتقوى وفق نشاط مجتمعها، وما
له من قوة لخوض غمار واقع الحياة وفتح آفاق المستقبل. وهي قد تفتر وتضعف إذا ما
فترت حركة هذا المجتمع، وبدا عاجزاً عن حل ما يعترضه من مشكلات، ورفع ما يواجهه من
تحديات.
ومن ثم، فإنها تكتسب كينونتها وتكتسي حيويتها، بقدر ما يكون للناطقين بها
والكاتبين من إمكانات، لبث الحياة فيها، وإبقاء هذه الحياة متواصلة فيها ودائمة،
لا يعترضها عائق في التعبير عن أي جديد تعيشه، مهما يكن هذا الجديد ؛ مما يجعل
اللغة في حقيقتها، صدى يعكس واقع الذين يتوسلون بها في شؤونهم العامة والخاصة.
ثم إن اللغة كائن حي يحتاج إلى النمو الدائم والتطور المستمر، في مواكبة
تلقائية لمستجدات العصر، وما تستوجب من استعمالات تتطلب بدورها ألفاظاً ودلالات
تغني معجمها بالتوليد والاقتباس، كيفما تكن طبيعة هذا العصر ومجتمعه متسمة بالضعف
والانهيار. وقد يصل هذا التطور وذاك النمو إلى حد التغيير الذي يتجاوز تلك الألفاظ
والدلالات إلى المباني وما بينها من علاقات، والذي لا تخفى إيجابياته، ما لم يمس
البنيات الأساسية، أو يُصبْ ملامحها بالتبديل والتشويه.
وبحكم تلقائية هذه العملية - وحتميتها كذلك - فإنها تتم حسب الحاجة، ووفق
ما يفرضه التداول، وفي محاولة بالسليقة قبل أن تكون بالعلم، للملاءمة مع القوانين
الضابطة والمعايير المتحكمة، وبناء على إجراء اختياري نابع من كونها وجميع
متعلقاتها مرتبطة بحق أصحابها في التوسل بها دون غيرها، سواء للتواصل فيما بينهم،
أو للإبداع، أو لاكتساب المعارف والعلوم.
ومن العجيب أن العالم كله يتحدث اليوم عن حقوق الإنسان، وعن أبرز هذه
الحقوق ألا وهو حق الاختيار، استناداً إلى الانتماء وما يستلزم من حاجات، دون
محاولة فرض أي اختيار آخر يكون غريباً عن هذا الانتماء، وغير مستجيب لتلك الحاجات.
ومع ذلك يراد للعرب أن يحرموا هذا الحق الذي يمارسه غيرهم، والذي مارسوه هم طوال
عدة قرون.
وباعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية وكائناً حيا - على النحو الذي بينا - فإنها
ذات مفهوم جامع وشمولي، يجعل منها بنية متكاملة تكونها أصوات ورموز، منها تتركب
كلمات تكتسب معاني ودلالات بحكم ارتباط بعضها ببعض، ووفق ما يحتاج إليه المتوسلون
بها للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، ثم للتفاهم والتعارف. وهي حاجة تحثهم على توسيع
متن هذه اللغة وتدقيقه، وتحديد القواعد الضابطة لاستعماله والمعايير الفنية
لتجميله وتحسينه. كما تحثهم بذلك على الارتقاء المستمر بها، لإظهار تفوقهم،
ومضاهاة غيرهم في مجال الإبداع والإنتاج على مستوى العلوم والآداب والفنون، وكذا
على الصعيد العام كأداة للتواصل، سواء فيما بينهم أو مع الآخرين.
وإذا كان هذا التعريف ينطبق على جميع اللغات، دالاً على وظيفتها المادية
التي بها تصبح كيانا حياً ونسيجاً تُشكَّل الثقافة من خلاله، والأساس الجامع لجذور
المجتمع الناطق بها، فإنه بالنسبة للسان العربي يكتسي عناصر إضافية هي لا شك ضمن
مميزاته ومزاياه. وتكمن في الجانب الروحي النابع من كون القرآن الكريم نزل بهذا
اللسان المبين، وجاء معجزاً به، لفظاً وأسلوبا وبيانا ونظماً ومضموناً. كما تكمن
في كونها لغة التراث الحضاري والثقافي الذي رافق ويرافق الإسلام، سواء في الأقطار
الناطقة بها - حتى حين يوجد بها غير مسلميـن - أو في غيرها من البلـدان الإسلاميـة
مهما تكن لغات التخاطب فيها.
وغير خاف أن ارتباط اللغة العربية بهذا الجانب، أغنى مضامينها بقيمه
وشرائعه، وأضفى عليها جمالية رائعة، وأتاح لها ما لم يتح لغيرها، إذ غدت - كما سبق
الذكر - لحمة متينة تربط العرب بغيرهم من المسلمين الذين لا ينطقون بها، حيثما
وجدوا، يتلون بها القرآن الكريم ويحفظونه ويتعبدون به، ويشعرون من خلاله بإحساس
باطني يداخل وجدانهم، فيزيدهم إعجاباً بها ورغبة في تعلمها، واعتباراً لها أحد
مكونات هويتهم الذاتية.
ومن المؤكد أن اللغة العربية تعرضت
- طوال مسيرها الممتد قروناً عديدة - لتطورات كثيرة، بحكم اتساع رقعة الأوطان
العربية والإسلامية، وتعدد الناطقين بها من غير العرب، وكذا بسبب التمازج الذي حدث
بين سكان الحواضر والبوادي، ثم نتيجة الاحتكاك بمجتمعات أجنبية، والصدام مع
الاستعمار، وما أعقب ذلك من نهوض صاحبه وعي جديد وتطلع إلى التقدم واللحاق
بالأقطار التي حققته.
وهي اليوم في هذا السياق الساعي إلى مواصلة تنميتها ورقيها، تواجه مشكلات
كثيرة تكشف أن موقفنا منها هو أبرز مظاهر واقعنا وما نعاني فيه من ضعف وانهيار،
وحيرة وتردد، وعجز عن مصارحة الذات ومحاولة علاج أدوائها. ولا شك أن بعض تلك
المشكلات هو مما تراكم عليها طوال فترات الضعف، وأن بعضها الآخر هو مما يصادمها في
المرحلة الراهنة من تحديات ليس من السهل التغلب عليها ورفعها ؛ وأبرزها تحدي
العولمة، والفقر الذي تشكوه في التعبير عن مستجدات هذه المرحلة، وما يستحدث فيها
من مصطلحات علمية وحضارية وثقافية تحتاج إلى أن تقتبس أو تترجم، ومن ألفاظ دالة
على مفاهيم ومعان جديدة يتطلب استعمالها أن تكون واضحة في الأذهان.
إن اللغة العربية في حاجة - لكي تكون لغة العصر وما يجد فيه من معارف وعلوم
ووسائل التواصل المستحدثة - إلى أن تعتبر اللغة الأم، أي اللغة الوطنية والرسمية
ذات السيادة الكاملة، بعيداً عن أية هيمنة تكون للغة أجنبية كيفما تكن هذه اللغة،
وبعيداً كذلك عن كل محاولة لفرض لهجة عامية محلية، مهما يكن لهذه اللهجة من حضور
في الواقع أو التراث.
ولا يمكن أن تكون هذه السيادة كاملة إلا إذا تجلت في مختلف المجالات
الحيوية للمجتمع، وإلا إذا كان عليها الإجماع، في ثقة بها وإيمان بضرورة تدعيمها
وترسيخها، وجعلها لغة الحياة العامة، وفي مختلف المرافق الإدارية، وكل ما يحتاجه
المواطن في علاقته بالمؤسسات الرسمية وغيرها؛ دون الاضطرار بتمحن إلى الازدواج
اللغوي الذي أضحى ظاهرة شائعة في كثير من الأقطار العربية بعد أن تحررت من
الاستعمار ؛ مما تكمن خلفه أسباب اجتماعية ونفسية، إلى جانب إغراء منتجات الحضارة الحديثة،
مما لا شك يكون له تأثير على وحدة المجتمع الذي يعاني عقداً ومركبات تظهر آثارها
على لسانه، بقصد منه وبدون قصد، لرسوخها في وعيه ولا وعيه.
إن اللغة أداة توحيد في المجتمع، لا أداة تفريق. ولعل مما يرسخ هذه
الحقيقة، أن تكون لغة التعليم في جميع مراحله، بما فيها المرحلة الجامعية وما يتصل
بها من بحث علمي، بكل ما يقتضيه من اجتهاد في نقل المصطلحات وما إليها مما يجد في
هذا البحث على مستوى العالم.
وإنه لخطأ فادح ما يحدث في معظم الجامعات العربية، حين يراد قصر اللغة
العربية على الدراسات الأدبية والإنسانية، مع فسح المجال للغة الأجنبية بالنسبة
للعلوم التقنية والمعارف العصرية. ومن العجيب أن الذين يريدون أن تقتصر اللغة
العربية على تلك الدراسات وما فيها من حقول فكرية وإبداعية، ينسون أنها هي التي
تحتاج إلى معجم أوسع وطاقات تعبيرية أكبر، في حين أن ميادين العلوم الأخرى - على
سعتها وتعددها ووفرة جديدها - لا تتطلب في الاستعمال التخصصي الدقيق، سوى متن
محدود تملأه مصطلحات يمكن التغلب بالتعريب والاقتباس على ما عندنا فيها من نقص
كثير ومتزايد؛ إضافة إلى ما في التراث العلمي العربي في هذا الباب.
وهو إمكان مشروط بتوافر الرغبة والشجاعة لمواجهة هذا النقص، مع بذل الجهد
اللازم الذي يتطلبه التنقيب في ذلك التراث ؛ بعيداً عن أي تباطؤ أو تمحن في
محاولات متعثرة للتعريب، ومثبطة لعزائم الداعين إليه ؛ وبعيداً كذلك عن الرفض
المطلق للاقتباس على ما في هذا الاقتباس من ربح للوقت، وكذا إغناء لمتن اللغـة
العربيـة التي لا يخفى ما أَثْرت به من دخيل على مر العصور.
إن اللغة العربية - بهذا كله وكأية لغة أخرى - عنصر أساسي في التنمية وما
ينتج عنها من رقي وتقدم، سواء في بُعدها البشري أو في سياقها الشامل المستديم. ولا
إمكان لتحقيق هذه التنمية بلغة أجنبية أو بشتات لغوي، مهما يكن في المجتمع من تعدد
وتنوع. وحتى حين يوجد مظهر ما لهذا التنوع والتعدد - كما هو حال الأمازيغية في
المغرب على سبيل المثال - فإنه ينبغي معالجته بما يحفظ له ثراءه وقيمته في إغناء
المكونات الاجتماعية والثقافية، ولكن كذلك - بل قبل ذلك - بما يحافظ على اللغة
الوطنية والرسمية التي هي الآصرة الجامعة واللحمة الموحدة لذاك المجتمع.
وإلى جانب هذه المتطلبات الأساسية لحماية اللغة العربية وتقويتها، فإنه
يلزم كذلك احترام استعمالها في الملتقيات الدولية التي اعترفت بالعربية لغة
عالمية، والتي تستغرب مع هذا الاعتراف ما يصدر عن بعض المسؤولين العرب من تجنب
الحديث بها، ولجوئهم إلى لغات أخرى لتقديم خطبهم، على نحو ما يلاحظ مثلاً في منظمة
اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة. وقد تفاقمت هذه الظاهرة المؤسفة إلى حدٍّ جَعل
الأمين العام الأممي يثيرها، مستغرباً ما يقع فيه هؤلاء المسؤولون من تناقض، حين
يطالبون بجعل العربية لغة رسمية في المنظمة، ثم هم في الوقت نفسه يتخلون عنها ؛
على الرغم من أن ترسيم هذه اللغة كلف الكثير لتحقيقه، سواء على مستوى التجهيزات أو المترجمين أو المطبوعات وما إليها من لوازم العمل.
ومع ذلك، فإن الدعوة إلى إيلاء اللغة العربية ما هي
جديرة به من مكانة، لا تعني تصنيمها أو تقديسها إلى حد التجميد الذي قد يفضي إلى
الموت والتحنيط، ولكن تعني وجوب تطويرها والإسراع بتحقيق ما هي في أمس الحاجة
إليه.
ويمكن البدء في ذلك بتقريب هوة الاختلاف بين مستعملي
اللغة العربية في الأقطار الناطقة بها، وحتى داخل القطر الواحد. وهو الاختلاف
الناتج عن طبيعة البيئة والسكان وما لها من تأثير على الألسنة، وما قد تفرزه من
لهجات عامية محلية قد تكون نابعة من هذه اللغة، كما قد تكون بعيدة عنها. ويمكن
لهذا التقريب أن يتحقق باقتباس ما هو متداول من تلك اللهجات على الصعيد العام، مما
هو غير موجود له مثيل في اللغة المعربة أو الفصحى، وإخضاعه للتفصيح.
وهي عملية تبدو اليوم سهلة إن لم تكن قد بدأت تتحقق، بفضل انتشار التعليم،
وتعدد وسائل الإعلام على العموم، والمرئية منها على الخصوص ؛ مما قد تنتج عنه لغة
عربية فصحى جديدة تتسم بالبساطة وسعة التداول. وهذه لا شك ظاهرة حميدة سترفع من
مستوى العاميات، دون أن تنزل بمستوى اللغة الأم أو تسف بها. كما أنها ستحول دون
إحلال تلك العاميات مكانها.
ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى شيء من المرونة في التقريب بين ما تضبطه
المعايير اللغوية والقواعد النحوية والصرفية، وبين ما يجري على ألسنة الناس مما
استسهلوا صياغته وتداولوا التعبير به ؛ لكن في غير تشدد أو تضييق، وكذا في غير
انسياق للتيسير والمبالغة فيه ؛ مما يستلزم مراعاة القوانين الأساسية التي بها تتأتى سلامة التعبير وجودته وجماله، دون
إغفال التحول الذي أصاب المعاني الأصلية والمفاهيم القديمة على امتداد العصور،
فأكسبها غير قليل من الجديد.
وحتى يتحقق مثل هذا المبتغى على أوسع نطاق، فإنه لا مناص
من قيام تنسيق بين مختلف الهيآت والمراكز المسؤولة عن اللغة العربية، بدءاً من
المجامع والأكاديميـات إلى الجامعات وما إليها من مؤسسات تعليمية وتكوينية ؛ وهي
في عمومها محتاجة إلى غير قليل من التطوير والتجديد. ولعل إنشاء مجمع لغوي موحد أن
يكون خير انطلاق لكل ما يتطلع إليه المهتمون بشأن اللغة العربية والمهمومون به ؛
مع الإشارة إلى أنهم جميعاً يعلقون آمالاً كبيرة في هذا المضمار على المشروع
المغربي بإحداث «أكاديمية محمد السادس للغة العربية»، منتظرين تنفيذه بفارغ الصبر.
ويكاد جماع هذه التطلعات أن يكون مؤسساً على الاعتزاز
باللغة العربية، والحرص عليها، والتمسك بها، واستعمالها - بناء على ما ذكرنا من
قبل - في البحث العلمي، والإعلام، والتعليم، والإدارة، والإعلان التجاري، والتخاطب
اليومي، وفي مختلف الميادين ؛ وكذا إيلائها محلها اللائق بها - على الصعيدين
الرسمي والشعبي - من حيث هي أحد أهم مقومات الذات والكيان، حتى وإن اقتضى الأمر
إصدار قانون يلزم بذلك ويعاقب مخالفه. وهو وضع لا يتنافى أو يتعارض مع ضرورة تعلم
لغة أو لغات أجنبية، بقصد توظيفها الإيجابي في المجالات التي تستدعي هذا التوظيف.
وليس يخفى أن تحقيق جميع ما نطمح إليه، يتطلب مزيداً من العناية بتلقينها،
وتحسين مناهج هذا التلقين في مراحل التعليم وتحبيبه إلى الناشئة؛ مع العناية
بتأليف مقررات دراسية ملائمة، وبتكوين المدرسين والمعلمين، وكذلك الإذاعيين ومن
إليهم من القائمين على الإعلام، وكل الذين هم بحكم طبيعة وظائفهم يخاطبون عموم
الناس ويشدون إليهم المسامع والأنظار.
والدعوة إلى إعادة النظر في مناهج تدريس اللغة العربية بمختلف مراحل
التعليم، تتطلب التركيز على ما يتعلق بقواعد النحو والصرف، بما يجعلها مستساغة
وطيعة في الاستعمال، بعيداً عما هو شاذ أو خلافي، أو معقد يصعب على التلميذ أو
يشوش عليه. كما تتطلب إبراز القدرات الإبداعية التي تختزنها هذه اللغة، وما لها من
إمكانات للتعبير عن كل جديد، وكذا إظهار عناصر رشاقتها وملامح جمالها من خلال
اختيار نصوص فكرية وأدبية منتقاة من القديم والحديث. ثم يعزز ذلك بتدريب النشء على
الكتابة السليمة والإنشاء الصحيح بتدرج وترغيب، وفق معجم ميسر ومكتمل وواضح. وهو
ما يقتضي تخفيف هذا المعجم من كثير مما تغتني به القواميس العربية من ألفاظ لم تعد
مستعملة أو قل استعمالها، وكذا من مرادفات قد تثير البلبلة في ذهن المتعلم
المبتدئ.
وتجدر الإشارة في هذا السياق التربوي التعليمي إلى ضرورة تطويع اللغة
العربية وتوسيع استعمال حرفها في الحاسوب الذي غدا أداة التواصل الأولى بين
الشباب، مما قد يساعد على تبادل المعلومات بها، ويجعلها قادرة على التوسل بمختلف
آليات العصر وتقنياته في جميع العلوم والمعارف وما يجد فيها من ابتكارات متوالية
واختراعات متسارعة، مع ما يصاحبها من مفاهيم جديدة وألفاظ دالة عليها لم تكن
معروفة.
على أن العناية بهذا الجانب التربوي التعليمي - وهو الأساس - لا ينبغي أن
تبعد المهتمين بقضايا اللغة العربية عن النظر إليها من خلال الأزمة العامة التي
تعيشها في أبعادها المختلفة، سياسيـة واقتصاديـة وفكريـة واجتماعيـة، وما تعاني في
ذلك من تحديات متعددة.
ويبقى بعد هذا أن اللغة العربية هي الخيط الواصل بين المغاربة كافة، وكذا
بين العرب والمسلمين على العموم، والجامع لشملهم، والمعبر عن انتمائهم، والرامز
لوحدتهم. وهي بمتنها وقوانينها الضابطة لها، وبتراثها الغني الغزير، وببعدها
الروحي المتمثل في القرآن الكريم، تشكل أساساً يدعم الشخصية العربية ويقوي كيانها.
وذلكم ما يجعل خصوم العرب يحقدون عليها ويسعون إلى تبديلها جملة، أو تغيير نمط
كتابتها، أو إلغاء ضوابطها بدعوى بعض الصعوبات التي تعانيها، أو بعض المشكلات التي
تصادف متعلميها، يضخمونها ويعتبرونها عقبة كأداة تحول دون توسيع مجال انتشارها، وتجعلها
غير قادرة على مواكبة العصر وما يحفل به في مختلف حقول المعارف والعلوم.
والحقيقة أنهم بمحاولة الطعن في اللغة، يرمون إلى ما هو أبعد من ذلك، أي
إلى ما هي مرتبطة به من عقيدة وفكر، وحضارة وثقافة، وتاريخ وتقاليد متوارثة، وكل
ما تلخصه وترمز إليه في حياة العرب والمسلمين، حتى يبتعدوا عنها كليا باستعمال
غيرها، أو جزئيا باستعمال لها غير صحيح غالباً ما يقرن بالدعوة إلى العاميات.
إن الابتعاد عن اللغة العربية في كلتا الصورتين، سواء باللجوء إلى لغة
أجنبية أو إلى لهجة عامية، لا يؤدي ولن يؤدي سوى إلى تقوية تيار التغريب، وزرع
بذور النزعات العرقية والنعرات العنصرية التي لا تفضي عند تمكنها من النفوس إلا
إلى الصراع والصدام، ثم إلى التفرقة والانقسام ؛ ومن ثم إلى إيجاد هويات ممسوخة
وكيانات ممزقة قد لا تجد العولمة أية صعوبة في ابتلاعها والتهامها لقمة سائغة.
أيها الزملاء والإخوة الأساتذة
حضرات السيدات والسادة
هذه هي أهم الجوانب التي سمح الوقت المحدد للعرض بتناولها، والتي لا شك
أنها ستثير قليلاً أو كثيراً من النقاش. وإني إذ أعرب عن ترحيبي بما قد تبدون من
آراء وأفكار ستغني الموضوع بكل تأكيد، لا أملك إلا أن أعبر عن شكري لكم على حسن
إصغائكم، مجدداً ما أحس به من اعتزاز بالمشاركة في هذا اللقاء العلمي المتميز.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
(1) تم هذا
اللقاء في الرباط يومي 23 و24 جمادى الأولى 1414
هـ الموافق 8
و9 نوفمبر 1993م، وشارك فيه الكاتب ببحث عنوانه : "اللغة العربية بين التطوير
والتقويم". أنظره في كتاب الندوة، وكذا في كتاب : "قضايا للتأمل برؤية
إسلامية" لصاحب هذا العرض، ابتداء من ص : 101 (منشورات النادي
الجراري - رقم 20 مطبعة الأمنية - الرباط 1421هـ - 2000 م).
منطلقـات
لخطاب إسلامي معاصر
عرض قُدم
للمؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، في عمّّان، بالمملكة
الأردنية الهاشمية، في الفترة من 27 إلى 29 جمادى الأولى 1426هـ الموافق لـ 4 إلى 6 يوليوز 2005م.

بسم الله وبه أستعين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد
رئيس الجلسة
أصحاب
الفضيلة العلماء والأساتذة
حضرات
السيدات والسادة
بسعادة
غامرة مقرونة باعتزاز كبير، أحضر هذا المؤتمر الإسلامي الدولي الذي تُشرف على
تنظيمه مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي الموقرة، استجابة لما نبه إليه صاحب الجلالة
الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله في "رسالة
عمّان"(1) من ضرورة بحث
الأزمة التي يجتازها العالم الإسلامي ووسائل تجاوزها ورفع تحدياتها المختلفة.
وقد
زاد في سعادتي واعتزازي اقتراح اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر أن أشارك فيه بالكتابة
في موضوع "الخطاب الإسلامي المعاصر". وهو ما أرجو أن
أوفق إلى تناوله من خلال هذا العرض الذي أشرف بتقديمه إلى حضراتكم، والذي سأركز
فيه على "منطلقات" ذاك الخطاب.
أيها
الإخوة الكرام
إن كل
من يتأمل الأزمة التي يعانيها المسلمون اليوم، ينتهي إلى أنه لا مخرج منها ولا حل
لمشكلاتها الشائكة إلا بالإصلاح.
لقد
أصبح هذا الإصلاح قضية حتمية، ليس فقط بحكم ناموس الحياة القائم على التطويـر
الدائم لهذه الحياة، ولكن كذلك لأن واقع الشعوب الإسلامية -
بحكم تلكم الأزمة - غدا يوجب هذا الإصلاح ؛ إضافة إلى ما تفرضه
العولمة من تعامل.
إلا أن
هذا التعامل لا يمكن أن يكون سَوِياً، أي صالحاً لتلك الشعوب، إلاّ إذا كان قائماً
على ما لديها من قيم ومقومات، وفي طليعتها الثقافة التي ينبغي أن تكون قويّة حتى
تستطيع المشاركة في العصر، إن لم نقل المواجهة لتحدياته، وحتى يتسنى لها قبل هذا
وبعد، أن تستفيد من تلك العولمة وما فيها من إيجابيات لاشك أن الأخذ بها والانخراط
فيها يؤديان إلى دعم الفكـر الإصلاحـي
الداخلـي، وإسعافه في تحقيق التغيير المأمول.
وبذلك
يخرج هذا الفكر من مجال الحلم والخيال، ومن مجرد التذمر والرفض، إلى مرحلة الإسهام
الفاعل والمؤثر في العملية التغييرية ؛ بدءاً من نقد ذاتي بدونه لن تتاح أية
مشاركة إيجابية في هذه العملية.
صحيح
أن المسلمين اليوم - وبحكم الظروف المتطورة والمعقدة التي يجتازونها
داخلية وخارجية - مقبلون بكل تأكيد على مرحلة إصلاحية جذرية مفروض
عليهم فيها أن يراجعوا كل تنظيماتهم وجميع شؤونهم، سياسية واقتصادية واجتماعية
وغيرها. وهو ما لن يتأتى لهم على النحـو السليـم،
إلاّ إذا بدأوا بالثقافـة واستندوا إليها دعامـة
أساسية.
وصحيح
كذلك أن الحديث شاع في الآونة الأخيرة، وعلى مختلف الأصعدة عن الإصلاح.
إلا أنه غالباً ما يوجه في خط دعائي لا يمكن أن يوصف إلا بأنه سلبي مُوحىً به من
الخارج، بل مفروض من جهات معينة تعمد به إلى التخويف والتهديد؛ بعيداً عما هو مرجو
له من تصحيح داخلي للمفاهيم والأفكار وأنماط السلوك، سواء على مستوى المسؤولين أو
سائر هيآت المجتمع بمختلف تياراتها والأفراد، بقصد مواجهة القضايا الوطنية بجد،
وليس بمجرد إطلاق شعارات إصلاحية.
وذلكم
ما يقتضي من المسؤولين أن يقتنعوا بأنه لا إصلاح بدون الإصغاء إلى القوى الداخلية
والتعاون معها، وعلى رأسها قوى الثقافة. ولعلنا أن ننبه إلى
أنه حتى الذين لا يرون في الإصلاح إلا جانبه السياسي أو الاقتصادي، فإن عليهم أن
يراعوا ما لهذين الجانبين من اتصال بجوانب أخرى ثقافية واجتماعية هي
التي تؤثر إن لم تكن توجه وتتحكم.
وغير
خاف أن العنصر الثقافي هو أساس اختلاف وجهات النظر للعولمة على مستوى الأوطان
والشعوب التي ترى ضرورة التعدد الثقافي وتمارسه في تمسك واعتزاز بثقافتها الخاصة،
ورفض للانسلاخ عنها باعتبارها أحد مكونات الهوية الذاتية.
إن
الإصلاح حين ينطلق من الثقافة ومن البعد التغييري فيها، فإنه لاشك سيقويها في
مجالاتها كافة، لتشع وتحدث بهذا الإشعاع فرصة لتنوير فكري قادر بوعيه الجديد على
أداء دوره، وقادر كذلك على الصمود في وجه كل فكر مضاد وصدِّّه.
والإيمان
بأن الإصلاح الشامل ينبغي أن تكون انطلاقته ثقافية، نابع من الاقتناع بأنه لا جدوى
من أي إصلاح، ما لم ينظر إلى المجتمع وقيمه وحاجاته وجميع ما يصبو إليه، ليس الآن
أو على المدى القريب فحسب، ولكن على الأمد البعيد كذلك. وهو ما لا يمكن أن
يتحقق إلا عن طريق الثقافة التي هي المفتاح لكل تقدم ورقي.
إن
الإشكال الذي يواجه المسلمين اليوم هو كيفية الاستجابة لهذا المطلب الملح الذي أخذ
يفرض نفسه - سواء من الداخل أو الخارج - بضغوط شديدة لا مفر
أمامها من الوصول إلى الحل الناجع لهذا الإشكال.
ويكمن
هذا الحل فى إيجاد التوافق اللازم بين حاجات الإصلاح ولوازم تحقيقه، وبين حقيقة
الذات وثوابت الهوية، لا سيما وأن غير قليل من جوانب هذا
الإصلاح تربطه بما عند الآخر الذي ينطلق من ذات مختلفة وثوابت مغايرة، وقبل ذلك
وبعد يتحفز من مصالح يسعى إلى بلوغها، مهما يكن الثمن الذي يدفعه الطرف المستضعف.
ويكاد
الدّين أن يكون الثابت الأول الذي لا إمكان لإزاحته والتخلي عنه، لرسوخه في أعماق
المجتمع، ولتاريخيته كذلك، ثم لأنه كان دائماً الدرع الواقية من كل أخطار الأزمات
التي واجهت هذا المجتمع، على نحو ما وقع أثناء مقاومة الاستعمار.
ومن
هنا، غالباً ما يوضع الدين - خطأً - في مواجهة الحداثة
التي تُُرْبَط - خطأ كذلك - بالإلحاد في صيغ
مختلفة للائكية والعلمانية.
*** *** ***
لذا،
واقتناعاً منا بأنه لا سبيل لأي إصلاح تتطلع إليه الأمة الإسلامية، ما لم
تنطلق فيه من مراجعة ثقافتها وما تنبني عليه من خطاب، فإنا نرى أن إبداع هذا
الخطاب الذي يجب أن يكون إسلاميا ومعاصراً وجديداً، هو أساس كل محاولة للتحديث
الذي كثر الحديث عنه وتعددت نداآته شرقاً وغرباً، وبدت معالم فرضه على المسلمين من
الخارج على نحو غير ملائم لهم في الغالب.
وأظننا
في غير حاجة إلا أن نؤكد أن هذا الخطاب، وهو يتسم بطابع الإسلام، ينبغي أن يكون
نابعاً من فكر المسلمين بكل ما فيه من تعدد وتنوع، نتيجة استيعابه لثقافات الشعوب
المختلفة التي تدين بهذا الدين.
كما
ينبغي أن يكون مؤهلاً لإيجاد صيغة سليمة يميز فيها بين حقائق الإسلام الصحيحة
والثابتة، وبين ما داخلها من شوائب وبدع وقع التركيز عليها وإبرازها خلال عصور
الانحطاط، فأفرزت تقاليد جامدة مست حتى صلب العقيدة، وعمقت الخلافات بين المسلمين.
ولن
يتأتى شيء من ذلك للخطاب المقصود، إليه إلا إذا لَفَت النظر ونَبَّه بحزم وصرامة
إلى أهمية الثقافة، أي إلى الفكر والمعرفة والتراث والبحث العلمي ومراكزه، وما
إليها من معاهد وجامعات تشكو الفقر للأسف في جانب الدراسات العلمية الرصينة، بسبب
عدم العناية بها والتشجيع عليها، رغم وفرة الأساتذة العلماء الباحثين الذين يعانون
تبعات هذا الفقر داخل مؤسساتهم، ويضطر بعضهم بسببه إلى الهجرة لبلدان أجنبية حيث
يلقون ما يفتقدونه في أوطانهم.
إن
الفكر الإسلامي لم يعد اليوم - كما كان في
السابق
- محصوراً في علوم معينة ومعارف محددة، كان علماء الوقت
قادرين على اكتسابها وتبليغها مهما يكن فيها من تنوع. وهو التنوع الذي
كان ينقلها من الفقهي الشرعي إلى المنطقي والعقلي، ثم الأدبي والفني ؛ مع الإشارة
إلى أن العلم الديني كان هو المَعْبر لما سواه.
وذلكم
ما يتحتم أخذه بعين الاعتبار، بعد أن اتسع نطاق ذاك الفكر باتساع آفاق الفكر
الإنساني، ولا سيما بعد أن تعالت أصوات هنا وهناك تنادي بإبعاد الدين
عن غيره من المجالات، مع الزعم أنه لا سبيل للنهوض إلا بالاستجابة لهذه المناداة.
ومع
اعتماد الخطاب الإسلامي الجديد على ذلك الفكر المتسع، بل وحتى يؤتي هذا الاعتماد
ثماره، فإنه يلزم القيام بنقد الذات، بدءاً من الإجحام عن تحطيمها بما يبث فيها
الفشل والإحباط نتيجة ما تعاني من تخلف، إلى التخلي عن تضخيمها والإفراط في التغني
بما كان لها من أمجاد، وفي إشاعة شعارات استعلائية مفرغة من أي مضمون، أو كان لها
مضمون في السابق، ولكنها لم تعد اليوم ذات أي مغزى أو مدلول.
إننا
إذ نُثير مسألة النقد الذاتي - ونعود إليها -
فلأننا نراه لازماً وضرورياً، ولأننا لا نريد أن يستبد بنا وبالأجيال الحالية
والقادمة شعور بالضعف والانهزام. فإنه ما زال في مقدورنا أن
نواجه ليس الآخر فحسب، ولكن أن نواجه قبل ذلك أنفسنا، ونعمل جادين على تقويمها
وتصحيحها. وهو ما يتحمل المفكرون مسؤوليته، ويجب أن يتحملوها في
مختلف جوانبها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بنضالية متفائلة.
ولاشك
أن مثل هذا الموقف الموضوعي سيقود في الوقت نفسه - بتسامح -
إلى الكف عن الطعن في الآخر ورفضه، على الرغم من تقدمه، ومن إمساكه بخيوط هذا
التقدم، يتحكم بها في مصير الشعوب المتخلفة ليملي عليها منظوره لإصلاح أحوالها.
ولسنا في حاجة إلى أن نوضح أن الكف المطلوب رهين بعدم تجاوز الحدود.
وإذا ما حدث هذا التجاوز، فإنه يستوجب الرد والمواجهة. وما قضية تدنيس
المصحف الشريف عنا ببعيدة.
ومن
المؤكد أن هذا الموقف المتسامح سيؤدي إلى السعي لامتلاك تلك الخيوط وما يشدها من
علوم ومعارف، ومن قيم سلوكية كذلك بما تدعو إليه من جدية واستقامة وحث على العمل والإنتاج.
وهي القيم نفسها التي سبق الإسلام إلى التبشير بها والدعوة إليها، والتي بها
استطاع المسلمون الأوائل أن ينشئوا حضارة زاهية وثقافة مزدهرة.
وهو ما
يفضي إلي البحث عن العوامل الحقيقية التي أدت بالمسلمين إلى التوقف عن مواصلة هذا
المسير الحضاري والثقافي المتألق وإلى التخلي - نتيجة ذلك -
عن ركب الإنسانية المتفوق ؛ وذلكم من خلال السؤال الذي غدا تقليدياً يتردد:
"لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟".
في هذا
السياق، يبدو أن من أولويات تجديد الخطاب الإسلامي أن ينطلق من الوعي بواقع
المرحلة التاريخية وما يعتمل فيها من مشكلات عميقة ومعضلات دقيقة، كمسألة النظام
السياسي أو قضية الحكم في الإسلام(2).
فهي - إلى جانب ما تستلزم من اجتهاد - تحتاج إلى أن
يُمهَّد الطريق لها نفسياً وفكرياً، وأن تخف حدة الوقوف منها في حلبة الصراع
والرفض، سواء من طرف خصوم الإسلام أو من قِبل المتخوفين بين المسلمين الداعين
للعلمانية من أن يتحول الأمر إلى كهنوت طاغ ومتجبر، أو إلى نظام حكم يعتمد الدين
ورجاله لإخفاء استبداده أو تبريره.
ولعل
تقوية الروح الديني من خلال قيم المجتمع ومقومات الحياة الخاصة والعامة لأفراده،
أن يكون السبيل إلى أن تنهج المؤسسات خط الإسلام في كل مجالاته، ولا سيما
السياسية والاقتصادية ؛ دون الانشغال بمشكلات مفتعلة، لا يقصد منها إلى
غير العبث بشؤون الدين واستفزاز المسلمين، على نحو ما أثير حول إمامة المرأة، مما
لا يعدو أن يكون مجرد بدعة قُصد منها إلى شغلهم عن الواقع المرير الذي يعانون
أزماته على واجهات شتى ومستويات متعددة.
وحتى
يتسنى للخطاب المتطلَّع إليه أن ينهض بدوره في هذا المجال، فإنه ينبغي أن يكون
متحليّا بالشجاعة الفكرية التي بها يستطيع مواجهة المشاكل الحقيقية بحلول ناجعة،
والتي بها يستطيع كذلك استشراف المستقبل وما قد يكون فيه من سلبيات مخبأة تحتاج
إلى أن ترسم لها خطط كي تستأصل قبل أن تظهر وتستفحل ؛ حتى ولو اقتضى الأمر البحث
عن بدائل لمعظم الاختيارات القائمة التي أظهرت تجاربها المديدة والمتكررة أنها
عاجزة عن إيجاد تلك الحلول، وأنها في أحسن الأحوال تردد شعارات مهدئة ومسكنة، لعدم
مصداقيتها، ولصدورها في الغالب عمن لا يتوافرون على الأهلية اللازمة، فضلاً عن
الروح الإسلامي الذي هو المنطلق والأساس.
لذا،
فإن الخطاب الإسلامي المعاصر ينبغي أن يتصدره العلماء الحقيقيون، يوجهونه ويقودونه
في انسجام مع الأمة التي تشارك فيه بفعالية، بعيدا عن أي مظهر للامبالاة أو
الصدام، بل باستعداد للدفاع عنه ومواصلة بنائه ومتابعة تطويره، لمزيد من التمكن من
رفع كل التحديات ؛ بدءا من محو الملامح المشوهة التي يراد إلصاقها بالإسلام، ولا
سيما ملمح التطرف والإرهاب الذي لم يعد خافياً على أحد أنه ظاهرة عالمية، وأن
نشأته الأولـى تمت خارج البـلاد الإسلاميـة،
وأن أسبابـه والدوافع إليه معروفة.
ونظراً
لأن القصد من هذا التشويه هو تنفير المسلمين من دينهم الذي هو بريء من مثل هذه
التهمة، فإنه لابد للخطاب الإسلامي الجديد أن ينطلق من تأكيد البعد الروحي في نفس
المسلم، عبر توثيق الصلة بالباري عز وجل ودينه الحنيف. وهو ما يتحقق بفهم
صحيح للعبادات وإدراك للدور الذي لها، ليس فقط فيما يتصل بهذه الصلة، ولكن كذلك
بما ينشأ عنها من سلوك سليم تجاه الذات والآخر، بكل ما يمكن أن يُقوِّم هذا السلوك
ويوجهه نحو نسْج علاقات إنسانية تهدف إلى إشاعة الخير والنفع، وإلى بث الأمل في
المستقبل وفي الأجيال الصاعدة.
إننا -
لهذا - نريده خطاباً ينزع من أفراد الأمة ما يَسكُنهم من يأس
وجزع وتذمر واستلاب، وكل أسباب الفشل والإحباط ومظاهر الاغتراب والانهزام، ويعيد
إليهم الثقة في نفسهم ودينهم ووطنهم ولغتهم وثقافتهم، ويبعث فيهم الحيوية وإمكانات
النهوض والقدرة على أخذ المبادرة وعلى تحقيق النجاح وبلوغ الرقي والتقدم.
وليس
يخفى أن هذا الخطاب التصحيحي سيكون بالتأكيد مقنعاً ليس فقط للقائمين عليه
والساعين إلى المشاركة فيه، ولكن كذلك لجميع أفراد الأمة حتى يتجاوبوا معه
ويتفاعلوا بوعي ومعرفة وإيجاب، وقبل ذلك بإدراك لإشكالية التخلف بجميع أسبابه
الداخلية والخارجية، وما يحتاج للتغلب عليها، وكذا ما يقابلها من متطلبات التقدم،
على نحو ما سبق ذكره.
والإقناع
لا ينبغي أن يقتصر على هذا الخطاب من حيث هو يشكل أدبيات تُنشأ أو تبدع، أو تعاليم
تُسطَّر وتقنَّن - وقد يتغنى بها إطراء وتمجيداً -
ولكن من حيث هو يتضمن مشروعاً للإصلاح الشامل، بكل ما يقتضي هذا الإصلاح من تجديد
وتغيير، ومن جدية في العمل لتنفيذه، وإشراك للجميع في ذلك بحميمية وغيرة وحماس،
وفي مجال من الحرية كبير ومتسع ؛ مع التوسل بمختلف الأدوات
التي أوجدتها ثورة الاتصالات على صعيد الأنترنيت، وكذا على مستوى البث التلفزي،
والإعلامي عامة، وما لذلك وغيره من أثر كبير في التواصل، إضافة إلى أدوات التبليغ
التقليدية.
وإذا
ما اتضحت هذه الأبعاد، فإن الخطاب الإسلامي المرجو إحداثه سيكون مقنعاً
ليس فقط للمومنين بالتوجه الإسلامي، ولكن حتى للذين يرفضون هذا التوجه من المفكرين
المسلمين الذين يرون في ثقافة الغرب السبيل الوحيد للخلاص والخروج من حلقة التخلف
؛ لأنهم ليسوا بالضرورة خصوماً لذلك التوجه، بقدر ما هم مقتنعون بأنه
متجاوز، وبأن الدوران في فلكه ولو بالدعوة إلى إصلاحه لن يكون مجدياً في شيء.
إن
الهدف من هذه العملية الإقناعية، هو إيجاد توافق بين مختلف مكونات المجتمع وبنياته.
والتوافق يقتضي مبدئياً أن يكون الخطاب جامعاً لما هو
مشترك بين المسلمين كافة، ومستبعداً لما هو بينهم مُفرق ؛ ولكن يقتضي في الوقت
ذاته قبول الاختلاف القائم بين سائر توجهاتهم، مهما يكن بينها من تعارض أو تناقض ؛
في مراعاة لمصالح هذا المجتمـع المستقبليـة،
شريطـة إيجاد قنوات للاتصال بين كل هذه التوجهات.
ويلزم
تبعاً لذلك وَصْلُ هذه القنوات مع غير المسلمين عبْر قيم تكون أساس كل تحاور
وتعاون ؛ مع تحديد الأولويات التي ينبغي البدء بها والتركيز عليها، وفق ما سبقت
الإشارة إليه ؛ مما تحتمه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يجتازها العـالـم
الذي يجب على المسلمين ألاّ ينعزلوا عن ركبه أو يتخلفوا عنه، بل أن يندمجوا فيه
بأن يكونوا شركـاء بما عندهم في بنائـه وتقدمـه،
وليس عالة عليه وعلى الممسكين بزمام قيادته.
*** *** ***
وبعد،
فإن الحاجة ماسة بإلحاح إلى خطاب إسلامي يقدم صورة جديدة عن قيمنا ومبادئنا، وعن
واقعنا كذلك، ثم عن تطلعات شعوبنا وما نسعى إلى أن نكونه في المآل القريب والبعيد.
ومثل
هذه الصورة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت تعبر عنّا بحق، أي بما يجعلنا
نُصدق أنفسنا ونعترف بالأدواء التي تفتك فينا وتشدنا إلى مزيد من التخلف
والانهيار، ثم بما يجعل غيرنا يتعامل معنا بشيء من الثقة الموصلة إلى الاقتناع
بخطابنا المعاصر، مقارنة بخطابنا التراثي الذي لم يعد له وجود على النحو الذي ما
زلنا نثيره، رغم ما بين الخطابين من تباعد أو تضادّ.
وتلكم
مسؤولية علمائنا ومفكرينا الذين هم مدعوون إلى أن ينفضوا عنهم غبار الخمول والعجز
والإحباط واليأس من التغيير، والاكتفاء بالتفرج على الواقع أو التشفي مما يحدث
فيه، طالما أنهم لا يد لهم فيه.
كما
أنهم مدعوون إلى أن يستعيدوا دورهم الريادي، باعتبارهم الآلة الأساسية في كل ما
يحرك المجتمع، بأن يثيروا قضاياه، ويفكروا في همومه، ويبدعوا حلولاً لها برؤية
مستقبلية متفائلة وواعدة بها تتحقق الحداثة.
وهو ما
يتطلب منهم أن يعيشوا بوعيهم وفكرهم داخل مجتمعهم، غير منعزلين عنه، وغير تاركيه
إلى من يحرف مسيره متوسلاً بنداآت كاذبة أو شعارات جوفاء.
وهذا
يعني أن عليهم أن يجددوا رباطهم معه، وألاّ ينفصلوا عنه، بحكم التكوين، أو بسبب
اعتلاء منصب، أو بدافع رفض بعض تقاليده. ويعني
كذلك أن عليهم أن يتعاملوا بمرونة وتسامح مع أنفسهم ومع أمثالهم ثم مع غيرهم، وأن
يتخلوا عن التمسك الشديد بما ورثوه من أفكار ونظم ومناهج قديمة بالنسبة للبعض،
وبما يغريهم من آراء ونظريات جديدة بالنسبة للآخرين.
ولعلهم
بهذا أن يعملوا على إبداع صيغة متطورة للفكر الإسلامي القادر على تفعيل الإصلاح
وإجراء التحديث، لكن في غير انسلاخ عن المقومات التي تقربهم من مجتمعهم، وتتيح لهم
أداء رسالتهم التنويرية، في نطاق الثقة المتبادلة التي ينبغي أن تنبعث من الخطاب
الإسلامي الجديد.
إن
عنصر الثقة في هذا الخطاب يجب أن ينطلق - كما مر -
من فهم واقعي للعصر، أي للمرحلة المعاصرة التي هي على الرغم مما يعانيه المسلمون
فيها من أزمات وتحديات، تبرز الإسلام في صورة تحث على التفاؤل، إذ تتجلى في
الإقبال المتزايد على اعتناقه، في مجتمعات أجنبية عنه وبين شعوب غير إسلامية، وكذا
على حسن انتشاره بين المسلمين وأجيالهم الشابة، ما بين فتيان وفتيات، على نحو لم
يكن معروفاً من قبل، مما يدل على صحوة إسلامية مبشرة، لاشك أنها ستؤول إلى ما فيه
صالح المسلمين، إذا ما رشدت واستطاعت استرجاع القيم الحقيقية التي بها تحصن
العقيدة بمناعة واقية من كل انحراف أو تشويه، وتكون في الوقت نفسه حافزة على
اكتساب مقومات النهوض والإصلاح لتحقيق التقدم.
بهذا وغيره، يتبين أن الحاجة اليوم ماسة إلى فكر إسلامي
عصري، يعبَّر عنه بخطاب يراعي كل المتغيرات التي عرفتها الإنسانية جمعاء، وما
رافقها من مستجدات، ويتوسل بأسلوب جذاب غير منفر، ويتناول قضايا العصر السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بروح علمي اجتهادي(3)، يستند إلى ثوابت الشرع ومقتضيات العقل،
ومراعاة المصالح من خلال منظور شمولي متسامح يعتمد التيسير والتبسيط، بهدف التوفيق
بين الدين والواقع في نطاق قابل للممارسة والمعايشة، وفي غير تناقض أو تصادم قد
يؤديان إلى الرفض والإلغاء ؛ أي بهدف تفعيل النص الديني وإبراز واقعيته، وإبقائه
حيا وذا تأثير إيجابي ومستمر في حياة المسلم
مهما تكن جوانب هذه الحياة حديثة، إذ هو في نطاق مرجعيته – ومثاليته كذلك - يبقى قادراً ليس فقط على مسايرة
الحداثة ومواكبتها والتكيف معها، ولكن قادراً كذلك على احتوائها واستيعابها، وعلى
التمييز بين النافع منها والضار، وعلى تنمية ما هو صالح منها وإغنائه لمواصلة
الرقي والتقدم، وللدخول إلى ما بعدها بالإسلام.
شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
(1) قرئت هذه الرسالة ـ وفق ما جاء في خطاب الدعوة الذي
تلقاه الكاتب من مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي ـ ليلة السابع والعشرين من رمضان
المبارك عام 1425هـ بحضرة جلالته، في
افتتاح مسجد الهاشميين بمدينة عمّان، وأذن أيده الله أن تكون مرتكزاً للبحث
والتخطيط لعمل بنَّاء مُجد لخدمة المسلمين يقوم عليه المتبصرون من علماء الأمة
الوعاة، كما أذن جلالته أن تقوم على ذلك لجنة عالمية للتخطيط والإشراف على عقد
مؤتمر إسلامي دولي ؛ ووجه وزير البلاط الملكي الهاشمي الدعوة لأعضاء تلك اللجنة،
فعقدت اجتماعاتها وأعدت تقريراً مفصلاً ناقشت
فيه مختلف القضايا المتصلة، وانتهت إلى الاتفاق على تعيين موضوع المؤتمر وضبط محاوره التي استمدت من نص "رسالة
عمان"، مع إسناد رئاسة الأمانة العامة لهذا المؤتمر إلى
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي.
(2) انظر في هذه المسألة
ما كتبه صاحب العرض في مؤلفيه:
- الإسلام واللائكية
(معرفة الإسلام) - الرباط 1424هـ = 2003 م -
منشورات النادي الجراري رقم:
26.
- الدولة في الإسلام (رؤية
عصرية) - الرباط 1425هـ = 2004 م -
منشورات النادي الجراري رقم:
27.
(3) انظر في مسألة الاجتهاد ما كتبه صاحب العرض في المؤلفين
المشار إليهما في الهامش السابق، وكذا في كتابه: "لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام".
الرباط 1425 = 2004م - منشورات النادي
الجراري -
رقم:
30.
فهرس
- مقدمة : مشكل الإصلاح 7
- حضارة إنسانية وهويات مختلفة............................... 31
- منظور العرب والمسلمين
للولايات المتحدة الأمريكية 53
- صراع أم حوار؟ بل
حوار ... ولكن 71
- التجديد الثقافي أول شروط
التغيير الشامل الهادف
إلى الإصلاح............................................................ 87
- أي مستقبل عربي في ظل ثقافة
التغيير ؟............... 107
- أهمية الثقافة العربية في
إبراز الهوية لمواجهة العولمة 117
- اللغة العربية :
واقع يحتاج إلى تطوير 143
- منطلقات لخطاب إسلامي معاصر.......................... 161